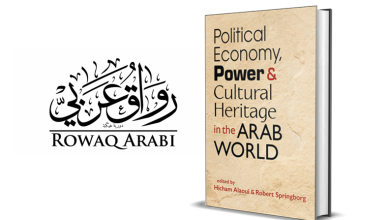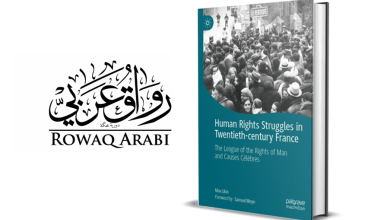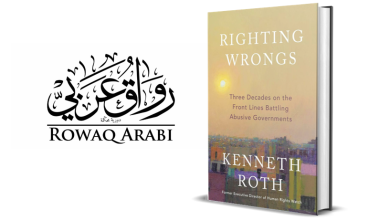مراجعة كتاب: «مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج» لمحمد السيد سعيد

الإشارة المرجعية: الرمضاني، مسعود (2024). مراجعة كتاب: «مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج» لمحمد السيد سعيد. رواق عربي، 29 (3)، 5-9. DOI: 10.53833/YNXT3717.
إبان الغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس سنة 1990، لم تخرج أغلب المواقف العربية، على المستويين الرسمي والشعبي، عن الدهشة والانفعالات الظرفية وردود الأفعال المزاجية والاصطفاف الأيديولوجي والانحياز لهذا الطرف أو ذاك. ورغم جسامة الكارثة، ليس على منطقة الخليج فحسب وإنما على النظام الإقليمي العربي عامة؛ إلا أن الدراسات المتأنية التي تتناول أزمة هذا النظام وتفحص الأسباب العميقة والتداعيات المحتملة والمؤكدة على مستقبل المنطقة ظلت محدودة.
وبحسب كتاب «مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج»، الذي ألفه محمد السيد سعيد ونشرته الدورية الكويتية «عالم المعرفة»،[1] فإن الأزمة تتجاوز إشكالية نظام عراقي متهور، يطمح لابتلاع دولة مجاورة ذات سيادة، منتهكًا بذلك كل أسس الروابط التي تجمع بين الدول العربية –على هشاشتها وتقلباتها– والقانون الدولي؛ لتطرح قضية حيوية أخرى، وهي مدى تماسك هذا النظام الإقليمي برمته ومدى وعي أنظمته، خاصة ذات القناعات الأيديولوجية الشمولية –بالمتغيرات التي أحدثها النظام العالمي بعد تفتت الاتحاد السوفياتي، وضمور الاستقطاب الثنائي الذي كان يحكم العالم.
لذلك يعتبر الكاتب أن قرار الحكومة العراقية لغزو الكويت يعد أحد «أكثر القرارات الخطيرة حمقًا في التاريخ العربي الحديث»؛[2] إذ لم ينتبه لتلك المتغيرات الدولية، كما لم يقرأ جيدًا تاريخ محاولات الوحدة الاندماجية السابقة والتي تزعمتها قيادات تاريخية، أدركت لاحقًا أنه برغم افتتانها الأيديولوجي بالوحدة العربية؛ إلا أن إمكانية فرضها بالقوة تظل مستحيلة. كما أن فشلُ تلك المحاولات الوحدوية المتكررة، في الستينيات والسبعينيات، يبرهن كذلك على ضرورة الاعتراف بالواقع القُطري العربي، والقبول بمبدأ الدولة الوطنية مع التمسك بروابط خاصة بين العرب، روابط يضمنها التواصل الجغرافي والاتساق في عديد العناصر اللغوية والثقافية والتاريخية.
أزمة النظام الإقليمي العربي
ومع هذا لا يمكن فهم أزمة الخليج بمعزل عن أزمة النظام الإقليمي العربي، إذ اتسمت العلاقات بين الدول العربية، أحيانًا، بالتوتر والصراع، ولم تكن لحظات الاستقرار والانسجام سوى لفترات قليلة. هذه الخلافات المتكررة نتجت عن أسباب عديدة، منها ما يتعلق بالتناقضات الأيديولوجية للنظم العربية وعلاقة بعض الأنظمة «المعتدلة» بالقوى العظمى والتنافس على الزعامة. بالإضافة إلى الميراث القبلي الذي لازال يحكم كثيرًا من أوجه الثقافة العربية السائدة، ميراث قائم على التحارب والصراع وليس على العمل المشترك والتضامن. كما ساهم عجز الحكومات العربية في تنفيذ ما يتفق عليه من قرارات، وما يتُخذ من مواقف في مؤتمرات القمة وفي اجتماعات الجامعة العربية في تلاشي مصداقية أي عمل مشترك.
لكن هل تبرر كل هذه المشاكل والمآزِق والعوائق الغزو؟ قطعا لًا، لأنه جاء في لحظة كان النظام العربي يحاول لملمة جراحه و تجاوز خلافاته وتدارك هشاشته، خاصة بعد قمة عمَّان العربية (1987) وما شهدته من تفاهمات، وما حققته من مصالحات بين عديد الدول العربية، فكان الغزو «انقطاعًا سلوكيًا لحركة نحو الصحوة، مهما كان ضعفها».[3] إذ اختارت القيادة العراقية أن تتخذ قرارًا أخرق «لتفرضه على ذاتها وعلى الوطن العربي ككل، أي ضم دولة عربية بالقوة».[4]
أنظمة لا تمثل إرادة شعوبها
في حقيقة الأمر، لا يمكن اختزال أزمة النظام الإقليمي العربي في صراعات الأنظمة وتنافسها، بل والاهم في غياب تمثيلية إرادة شعوبها. فصلابة أي نظام إقليمي ومصدر قوة دوله ومصداقية قراراته لا تُقاس بمدى التوافق والانسجام الرسمي للأنظمة، وإنما بمدى استجابتها لقضايا شعوبها وتحقيقها لطموحاتها. وهنا تفشل الحكومات العربية؛ لأن الانشغالات الحقيقية للشعوب، مثل الحرية والديمقراطية محذوفة من جداول الأعمال الرسمية.[5] وهنا أيضًا نفهم أسباب الفشل الدائم في تحقيق التنمية والارتقاء السياسي.
في السياق نفسه فإن ضعف النظام الإقليمي العربي له علاقة أيضا بالفجوة بينه وبين المتغيرات الدولية، وعدم قدرته على استيعاب المرحلة الجديدة من النظام العالمي الذي بدأ في منتصف الثمانينيات مع انهيار «القطبية الثنائية» والتحول إلى «القطبية الواحدة» الأمر الذي شكل تحديًا حقيقيًا للمنطقة وقضاياها الساخنة، خاصةً بعد أزمة الخليج.
أزمة النظام العراقي
هناك أيضا أزمة النظام العراقي قبل الإقدام على الغزو. إذ خرج هذا النظام من حربه الطويلة مع إيران منهكًا، مستنزفًا كل قدراته المالية والاقتصادية، مثقلًا بديون ضخمة، إذ أن غالبية إيراداته اتجهت نحو التسلح وإنشاء مجمعات عسكرية واقتناء تكنولوجيا حربية متطورة، مما أفرز تناقضًا صارخًا بين مقدرات عسكرية هائلة وهشاشة اقتصادية، زادها سوءً انخفاض أسعار النفط، مقارنةً بسبعينيات القرن الماضي.
هذا التناقض لم يكن ليُحل سوى بإحدى طريقتين: الأولى عقلانية، عبر إدارة اقتصادية عالية الكفاءة، تستوجب التخلي عن عسكرة الاقتصاد والانفتاح السياسي لاستعادة الكفاءات والخبرات العراقية التي أجبرها القمع وانسداد الأفق على الفرار؛ للمساهمة في تنمية مستدامة، واقتصاد مدني متطور. فيما تتمثل الطريقة الثانية في الاقتصار على الدولاب العسكري وتوجيهه لابتزاز دول الخليج الأخرى. ولما كان الحل الأول غير ممكن لأنه يعني «نفي لذات النظام البعثي» الذي تربى على تقديس «القوة الغاشمة» والعنف؛ فان الحل الثاني هو الذي كان متاحًا، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى كارثة الاجتياح، وبالتالي المزيد من إضعاف النظام الإقليمي العربي وتشتته.
صعوبة استيعاب الأقليات
كما أسفر الوضع الاقتصادي الكارثي عن العديد من الأثار المدمرة على وحدة العراق وتماسكه الداخلي حتى قبل الاجتياح. فقد نجحت الدولة التسلطية خلال السبعينيات في احتواء جزء مهم من الهويات الطائفية والعرقية عبر إدماجها في الحياة العامة وإفساح المجال أمامها لتولي المسئوليات الحكومية، فضلًا عن توفير الرعاية الاجتماعية. كما ساهمت الطفرة النفطية في التطور الاقتصادي وفك عزلة الجنوب. وما أن بدأ الوضع الاقتصادي في التدهور نتيجة التسلح؛ حتى تبيّن انه لم يعد ممكنا للدولة «أن تحافظ على مستوى مقبول من الاستيعاب للأقليات القومية والطائفية».[6] ولا شك أن الإقدام على غزو الكويت والحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد النظام العراقي قد فاقم من الظروف المعاكسة لهذا الاندماج.
موت السياسة
ومن البديهي دائمًا أن يفقد النظام القائم على العنف والقمع، بشكل تدريجي، مقوماته السياسية والأيديولوجية ليتحول إلى نظام امني صرف، يدمّر خصومه ومعارضيه إلى جانب كوادر حزبه النيّرة. الأمر الذي أسفر مع بداية الثمانينيات عن تفشي العنف الأمني، ما أدى بدوره إلى هجرة مئات الألاف من الكوادر السياسية والحزبية إلى أمريكا الشمالية والبلدان الأوروبية. ومع نهاية الثمانينيات «لم يعد للدولة وجه مدني»، بمعنى أن «الدولة نزعت طابعها السياسي وأصبحت دولة أمنية قائمة على قاعدة العنف المطلق».[7] وأصبحت تدور في حلقة مفرغة، دون وجود الدعم السياسي والأيديولوجي الذي قامت عليه في بدايتها. كما استنفد النظام العراقي شرعيته الخارجية نتيجة حروبه وغزواته، وأصبح في عزلة تامة في محيطه الإقليمي والدولي.
إعادة الاستقرار بأيادي خارجية
من بين النتائج المدمرة لحرب الخليج، أن تداعياتها أضعفت –بشكل غير مسبوق– الروابط العربية، ودمرت جزءً مهمًا من الموارد، وأوهنت المعنويات، وزادت من أزمة الثقة بين الدول؛ خاصة في ظل أن إعادة الأمن والاستقرار بعد الغزو، قد حدث بواسطة قوى غير عربية، وأمام نظام إقليمي عربي هزيل ومشتت. كما برزت قوى إقليمية أخرى، مثل إيران وتركيا وإسرائيل، وهي القوى التي ستمتلك دورًا مهمًا في سياق تشكيل معادلات جديدة في الشرق الأوسط. وهكذا دخل العرب عصرًا جديدًا من العلاقات الدولية فيما يعانون حالة من اليأس والضعف، بعدما ترك نظام الثنائية القطبية الدول العربية تواجه منفردة نظامًا عالميًا جديدًا يفرض شروطه وإرادته حول قائمة من الخلافات التاريخية، لعل أهمها قضية فلسطين. ولم تجد الولايات المتحدة صعوبة كبيرة في إقناع الدول العربية المجتمعة في قمة مدريد (أكتوبر 1991) بالتخلي عن الموقف التاريخي الذي تشكل في مؤسسات النظام العربي بشأن كيفية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي.
بلورة بعض الحلول للخروج من الأزمة
وفي مواجهة الأزمات المتعددة التي شهدها النظام الإقليمي العربي، والتي بلغت أوجها في الاحتلال العراقي للكويت، كان لابد من البحث أبعد من الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدارك النواقص العديدة والاختلالات التي أدت إلى الشرخ العربي، وبلورة فهم جديد لعلاقة الحكومات العربية فيما بينها، وكذلك في مواجهة النظام العالمي الجديد، وأيضًا في أسلوب الحكم وعلاقة الحكومات العربية بشعوبها.
ففي علاقة الدول العربية داخل هياكلها، وحتى في علاقاتها الثنائية، كان يجب التخلي عن الشعار الذي وصفه الكاتب بـ«السوقي» والذي يعمل على «إعادة توزيع الثروة العربية»، واستبداله بتوجه أكثر عقلانية وفاعلية يعتمد على التعاون الاقتصادي والتكامل التنموي، وهو شعار كل التجمعات الإقليمية الناجحة. فالتكامل الاقتصادي يمكنه العمل باستقلالية عن الهياكل السياسية العليا، كما يمكنه أيضا تخطى كل الحواجز الأيديولوجية، فيما يقتصر نجاحه على تفعيل الهياكل الوظيفية والإدارية التحتية وتقسيم العمل بين الدول، ويعد «العالم العربي مؤهلًا أكثر من غيره من مناطق العالم الثالث لتقسيم أرقى للعمل والأدوار».[8]
على مستوى العلاقات مع العالم الخارجي، يرى الكاتب وجوب استيعاب المتغيرات العالمية والاستجابة الخلاقة لها، ويقصد بذلك الالتزام بالشرعية الدولية؛ إلا أن هذا الالتزام لا يعني الخنوع والقبول بالأمر الواقع والامتثال لسيطرة القوى العظمي والقبول بسياسة الكيل بمكيالين، وإنما الدفاع عن مبدأ هذه الشرعية والسعي لتطبيقها بعدالة. فالشرعية الدولية التي تستبيح الحيف والظلم تستحق الوقوف في وجهها والعمل على إعادة توازنها، إذ «ليس هناك ما يلزم أي دولة بالقعود عن محاولة تغيير قاعدة من قواعد الشرعية الدولية بالوسائل والأدوات التي تحددها هذه الشرعية الدولية».[9]
وتظل علاقة الحكومات العربية بشعوبها من أهم المعوقات التي تمنع تطور المنطقة، ويتمثل السبب الرئيسي في تنطع الحكام واتخاذ قرارات فردية، خاطئة أو متهورة. ففي ظل غياب المؤسسات المستقلة والضوابط الدستورية، يمكن للحاكم اتخاذ قرارات تسعى فقط لتأبيد سلطته؛ لذا فإن الديمقراطية هي إحدى أهم الآليات التي تجعل النظام الإقليمي العربي يتخطى موته البطيء، وهي وحدها القادرة على تسليح الشعوب بالإرادة لدرء كل هيمنة خارجية، خاصة وأن النظام العالمي الجديد ليس كله سلبيات و سعي متواصل للهيمنة، إذ ثبّت آلية الديمقراطية وجعلها احد محاوره الرئيسية «حتى أصبحت جزءً لا يتجزأ من منظومة القيم العالمية».[10]
صعوبة هضم الديمقراطية
لا تزال المشكلة تتمثل في صعوبة القبول بمبدأ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجعلهما نموذجًا متبعًا للحكم في المنطقة. ولا يتوقف الأمر على الحكومات فحسب، وإنما أيضا على مستوى الشعوب وحتى النخب الثقافية والسياسية. فانطلاقًا من تأسيس الأنظمة العربية لسرديتها استنادًا إلى الحكم الفردي وقمع كل الأصوات المعارضة ورفض الرأي المخالف؛ فإن الفكر الشمولي ليس حكرًا عليها، إذ أنه متجذر في الرأي العام العربي، وحتى داخل الفئات المثقفة التي أظهر جزء هام منها –خلال أزمة الخليج– أنه مع العنف والضم بالقوة والاستخفاف بالشرعية والقانون.
وربما أهم الدروس التي يجب أن تتعلمها المنطقة –أنظمة وشعوب– هو أنه لا يمكن ضمان الأمن والاستقرار دون «التدريب الجماعي على الديمقراطية».[11] ورغم أن الأمر يبدو صعبًا، نظرًا للعوامل التي أشرنا إليها سابقًا؛ إلا أن التعامل التدريجي مع قيمها واستصدار «إعلان عربي لحقوق الإنسان» يحتوي على الجوانب الأكثر جوهرية لهذه الحقوق ويعمل على التحديث على المستوى المتوسط بإمكانه أن يشكل بدايةً للنهوض العربي.
في حقيقة الأمر، لا تكمن أهمية الكتاب في الإحاطة المستفيضة بتداعيات أزمة الخليج على النظام الإقليمي العربي حاضرًا ومستقبلًا فقط؛ بل في تشريح واقع هذا النظام من جوانبه السياسية والاجتماعية والثقافية، والوقوف على أسباب وهنه ومواطن ضعفه وذلك من أجل إعادة بنائه على أسس أكثر صلابة في واقع عالم متغيّر. وهو كتاب يستحق القراءة المتأنية، ليس فقط لفهم ظروف وملابسات أزمة الخليج قبل أكثر من ثلاثة عقود؛ بل من أجل إدراك أسباب تفاقم العجز والتشتت اليوم.
[1] محمد السيد سعيد (1992). مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج. الكويت: دار عالم المعرفة.
[2] المرجع السابق، ص 13.
[3] المرجع السابق، ص 67.
[4] المرجع السابق، ص 69.
[5] المرجع السابق، ص 22.
[6] المرجع السابق، ص 158.
[7] المرجع السابق، ص 162.
[8] المرجع السابق، ص 275.
[9] المرجع السابق، ص 270.
[10] المرجع السابق، ص 271.
[11] المرجع السابق، ص 273.
Read this post in: English