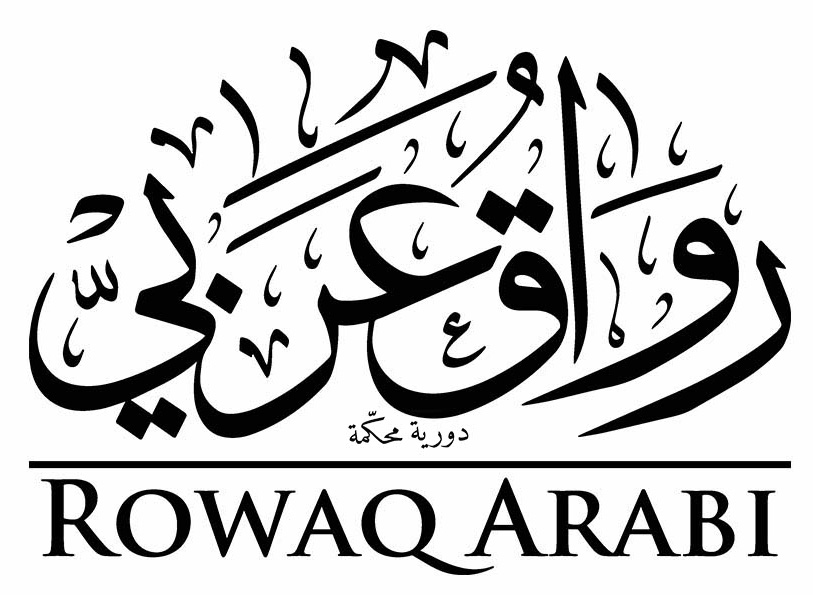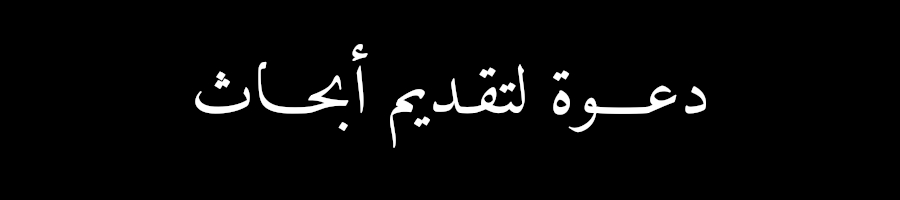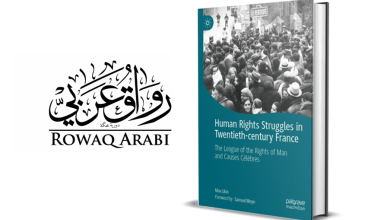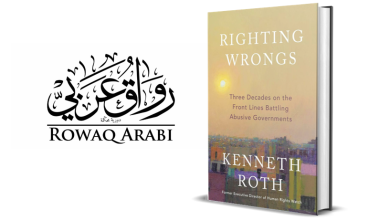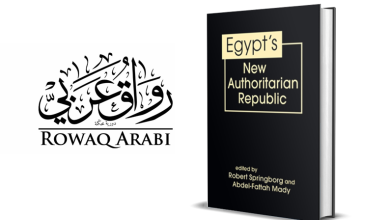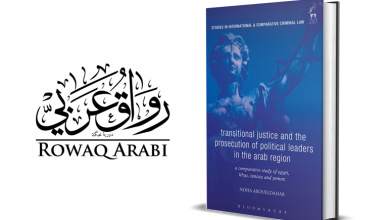مراجعة كتاب: «الاقتصاد السياسي والسلطة والتراث الثقافي في العالم العربي» لهشام العلوي وروبرت سبرينجبورج
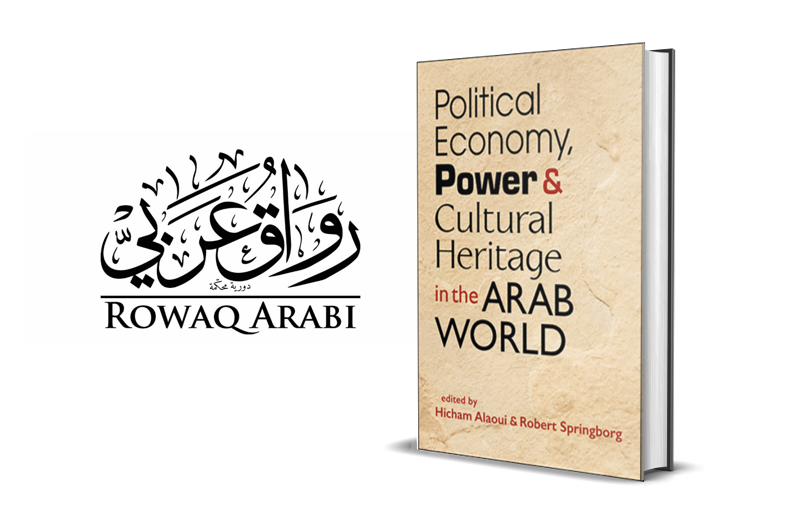
الإشارة المرجعية: الدردري، سيما. 2025. «مراجعة كتاب: الاقتصاد السياسي والسلطة والتراث الثقافي في العالم العربي لهشام العلوي وروبرت سبرينجبورج». رواق عربي 30 (2): 28-31. https://doi.org/10.53833/WUFI7690.
العنوان: الاقتصاد السياسي والسلطة والتراث الثقافي في العالم العربي
المحرران: هشام العلوي وروبرت سبرينجبورج
الناشر: دار لين رينير للنشر
سنة النشر: 2025
الرقم المعياري الدولي للنسخة الإلكترونية للكتاب: 9798896160052
لطالما اتسمت ديناميكيات الاقتصاد السياسي في الدول العربية، منذ الحقبة الإمبريالية الغربية، بالقمع والاحتكار. ورغم أن هذه الديناميكيات قد حظيت بدراسة واسعة؛ إلا أن دور التراث في إطارها لم يلقَ اهتمامًا يُذكر. يقدم كتاب «الاقتصاد السياسي، والسلطة، والتراث الثقافي في العالم العربي» رؤى قيّمة ومتعددة التخصصات تستكشف الأشكال المختلفة للتراث، سواء المادي، كالمقتنيات الفنية والمعالم الأثرية، أو غير المادي، كاللغة، والكيفية التي تُوظف بها السلطة هذا التراث من جانب جهات فاعلة حكومية أو غير حكومية؛ سعيًا لتحقيق الشرعية السياسية، وبناء الهوية الوطنية، وجني المكاسب المالية. وبناء عليه يجادل الكتاب بأن الاقتصاد السياسي للتراث يستلزم فحصًا دقيقًا لفهم كيفية توظيف السلطة له كأداة. ويقدم الكتاب ذلك من خلال ربط الديناميكيات الحالية للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في المنطقة العربية بالإرث الكولونيالي الذي لا يزال مؤثرًا على تصور التراث وإدارته حتى يومنا هذا.
يتألف الكتاب من اثني عشر فصلًا، يستهله ويختتمه فصلان بقلم محرريه: هشام العلوي وروبرت سبرينجبورج. وتغطي دراسات الحالة الرئيسية دولًا في جميع أنحاء المنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية ومصر والأردن ولبنان وليبيا وتونس، إلى جانب فصول ذات طابع إقليمي، مثل تلك التي تتناول الإنتاج الإعلامي، والتي تناقش سوريا كذلك. كما يتضمن الكتاب أيضًا فصلًا عن الصين، يقدم فيه مقارنة بين الدول السلطوية في المنطقة العربية وشكل آخر من السيطرة السلطوية على التراث تتسم بكونها أقل مركزية. بالإضافة إلى ذلك، يعرض الكتاب في فصل يتناول إيطاليا نموذجًا أكثر ديمقراطية لا مركزية، وهو النموذج الذي يتبناه المحرران كنهج للتعامل مع التراث، يُشرك المجتمعات المحلية ويعود عليها بالنفع، ويعكس تاريخها وهوياتها، حتى عندما يتباين هذا مع مفهوم الدولة للتراث.
يُقسِّم الكتاب المنطقة العربية إلى فئتين رئيسيتين من الدول: الأولى هي المتجانسة نسبيًا، التي تحكمها أنظمة سلطوية تستخدم التراث الثقافي لترسيخ شرعيتها؛ والأخرى الأكثر تباينًا، وهي الدول الأكثر ضعفًا، إذ تعمل الجهات الفاعلة المحلية، كالميليشيات، على إعادة إنتاج تصوراتها التنافسية للتراث الثقافي في ظل غياب دولة قوية قادرة على تولي هذا الدور.[1] ومع ذلك، يوظف كلا النوعين إنتاج التراث الثقافي لجني المكاسب الاقتصادية، ولإضفاء الشرعية على الصعيدين الداخلي والخارجي بدرجات متفاوتة.
على سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، شرعت الدولة في تنفيذ «رؤية 2030» لتنويع اقتصادها وبناء هوية وطنية جديدة، حيث يخضع إنتاج التراث الثقافي «لهيمنة دائرة ضيقة من سلطة الدولة تتمحور حول الملك وولي العهد»[2] ويُوظف «لإضفاء الشرعية على النظام خارجيًا، بما في ذلك صناعة الصورة العالمية».[3] الأمر الذي يتجلى في «اعتماد المملكة على مستشارين أجانب على حساب المشورة المحلية»، مما أسفر عن إصابة الرؤية بقدر من «الانفصال المحلي».[4] على الجانب الأخر، لا يُصنَّف الأردن ضمن الدول الغنية بالنفط، ما دفعه للاعتماد لأمد طويل على جهات فاعلة دولية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لتنمية قطاع السياحة في البلاد وتحديد ما يمثل قيمة للزوار الأجانب. ومن هنا يتواصل المنطق الكولونيالي، إذ أن المواقع التراثية التي تُعتبر قيّمة غالبًا ما «ترتبط بإرث العمل الأمريكي في مجال التراث في المنطقة، لا سيما في علم الآثار التوراتي»،[5] إذ يتم الترويج لـ «خريطة تاريخية متخيلة للأردن… مع تجنُّب تواريخ أخرى بشكل متعمد».[6]
وبالتالي فإن النفوذ الدولي في المنطقة ليس ظاهرة حديثة، وإنما يشكل استمرارًا للإرث الكولونيالي؛ ويتضمن ذلك «الاعتبارات المتعلقة بنوع التراث الذي ميّز الحضارات العظيمة».[7] ويتجلى ذلك في التركيز الإمبريالي على المواقع الأثرية الضخمة، مثل «أهرامات الجيزة، أو البتراء، أو تدمر»، والتي «استأثرت بها القوى الكولونيالية ذات يوم».[8] وقد تواطأت دول ما بعد الاستقلال في إدامة هذا الإرث الكولونيالي، مثلما شهدنا في تأكيد مصر على ماضيها الفرعوني باعتباره العنصر المحدد للتراث القومي. أيضًا ثمة ديناميكيات مماثلة تتجلى في لبنان، لا سيما من خلال الانقسام بين الفينيقي/المسيحي مقابل العروبة/الإسلام، والذي «جرى ترسيخه أثناء فترة الانتداب» لخدمة المصالح السياسية لفرنسا.[9] ولم يقتصر تأثير هذا الإرث على العلاقات الاجتماعية والطائفية فحسب، بل امتد أيضًا، حسبما توضح لينا طحان في الفصل السابع، ليشمل الهوية الوطنية والسرديات المتحفية. وقد استفحل هذا الأمر بسبب ضعف الدولة اللبنانية و«افتقارها لوجود لجنة رسمية للحقيقة والمصالحة» في أعقاب الحرب الأهلية.[10]
الفصل التاسع من الكتاب يتناول اللغة باعتبارها تراثًا ورصيدًا رمزيًا، لا سيما بين الجماعات الأمازيغية في ليبيا وتونس، والتي «تنم كذلك عن الاستمرارية المؤسسية للكولونيالية».[11] ففي تونس، ترك نظام التعليم الكولونيالي الفرنسي أثرًا دائمًا على السياسة والثقافة، على العكس من ليبيا التي لم يترسخ فيها إرث كولونيالي مماثل.[12] علاوة على ذلك، يوضح الكتاب أنه مثلما استخدمت القوى الكولونيالية التراث في السابق لخدمة مصالحها الخاصة، فقد واصلت دول ما بعد الاستعمار الممارسة ذاتها ، معتمدة في كثير من الأحيان على أدوات مماثلة للسيطرة والإقصاء. وكما يلاحظ إيثان في الفصل الثامن، فقد أسفر ذلك عن خلق «دوامة من الصدمة» في ليبيا –وجميع أنحاء المنطقة بالتبعية– تبدأ بالاستعمار الإيطالي وتستمر إلى الحرب الأهلية مرورًا بحكم القذافي.[13]
ختامًا، يجادل الكتاب بأن التراث ليس محايدًا، بل هو صنيعة السلطة، ويمكن تشكيله أو التلاعب به من جانب الجهات التي تهيمن عليه. وتتجلى أهميته في قدرته على توليد قيمة اقتصادية، ومنح الشرعية على الصعيدين المحلي والدولي، وبناء الهوية الوطنية. وبالتالي، فإن الكتاب في جوهره يدور حول السلطة: من يقرر قيمة التراث، ومن يحدد كيفية استثماره ماليًا، ولصالح من. ويعزز كل فصل من الكتاب هذه الحجة من خلال وضع التراث في سياقه التاريخي والسياسي والاقتصادي، مبيّنًا كيف يتحول معناه وقيمته مع كل نظام و/أو تغيير سياسي. وفي الوقت نفسه، يدعو الكتاب إلى التوازن، فرغم ضرورة وجود مؤسسات دولة قوية لصون التراث من أجل الصالح العام؛ فإنه يجب تطبيق اللامركزية في السياسات لضمان الشمولية والمشاركة المحلية. وفي هذا الصدد، فإن معظم أنحاء المنطقة تفتقد وجود مساحات يمكن للناس فيها مساءلة وتحدي سرديات الدولة عن التراث، الأمر الذي من شأنه أن يعكس التنوع اللغوي والثقافي للمنطقة. ومثلما يؤكد المحرران، من الضروري عدم النظر إلى هذه السرديات التاريخية المتعددة باعتبارها متضاربة؛ وإنما ينبغي لها لتكامل والتعايش في انسجام لضمان الاستدامة والسلام.
بيد أن ما يغفله الكتاب هو تأثير الاستعمار المستمر على التراث في المنطقة، لا سيما في فلسطين، حيثما تسعى ديناميكيات الاقتصاد السياسي الكولونيالي-الاستيطاني للاستحواذ على التراث المحلي وطمسه. ويمثل هذا الإغفال خللًا جوهريًا، إذ إن هياكل السلطة الكولونيالية التي نوقشت في جميع أنحاء الكتاب لا تزال متجذرة بعمق في هذا السياق، ولكنها لم تحظَ بمعالجة كافية. ومع ذلك، يظل الكتاب مساهمة قيّمة جاءت في الوقت المناسب لفهم كيفية تقاطع السلطة والإرث الكولونيالي والاقتصاد السياسي في صون التراث وتقديمه في جميع أنحاء المنطقة العربية، مما يؤدي غالبًا إلى تضخيم جوانب من التراث أو طمسها لخدمة غايات سياسية واقتصادية. إن سوء إدارة «التراث الثقافي الغني» للمنطقة يؤدي في النهاية، حسبما يرى المحرران، إلى تبديد «قيمته السياسية والاقتصادية المحتملة، مع العجز عن صون الكثير منه كما ينبغي».[14]
بيان الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
اقتصر استخدام برنامج شات جي بي تي على التدقيق اللغوي للنسخة الإنجليزية من مراجعة الكتاب.
هذا المقال كتب في الأصل باللغة الانجليزية لرواق عربي.
[1] هشام العلوي وروبرت سبرينجبورج، «نحو اقتصاد سياسي للتراث الثقافي في العالم العربي» (Toward a Political Economy of Cultural Heritage in the Arab World)، في «الاقتصاد السياسي، والسلطة، والتراث الثقافي في العالم العربي» (Political Economy, Power, and Cultural Heritage in the Arab World)، تحرير هشام العلوي وروبرت سبرينجبورج (دار لين رينير للنشر، 2025)، 15.
[2] كارين إكسل، المملكة العربية السعودية: الاستيلاء والمواءمة تحت مظلة مستقبلية (Saudi Arabia: Appropriation and Accommodation Under a Futurist Umbrella)، في «الاقتصاد السياسي، والسلطة، والتراث الثقافي في العالم العربي» (Political Economy, Power, and Cultural Heritage in the Arab World)، تحرير هشام العلوي وروبرت سبرينجبورج (دار لين رينير للنشر، 2025)، 27.
[3] المرجع السابق.
[4] المرجع السابق، 36.
[5] شارلوت فيكيمانس، الأردن: السعي إلى الشرعية والنمو الاقتصادي من خلال تنمية التراث (Jordan: Pursuing Legitimacy and Economic Growth Through Heritage Development)، في «الاقتصاد السياسي، والسلطة، والتراث الثقافي في العالم العربي» (Political Economy, Power, and Cultural Heritage in the Arab World)، تحرير هشام العلوي وروبرت سبرينجبورج (دار لين رينير للنشر، 2025)، 58.
[6] المرجع السابق، 64.
[7] المرجع السابق، 66.
[8] المرجع السابق، 49.
[9] لينا ج. طحان، المتاحف اللبنانية: سرديات انتقائية للتراث (Lebanese Museums: Selective Representations of Heritage)، في «الاقتصاد السياسي، والسلطة، والتراث الثقافي في العالم العربي» (Political Economy, Power, and Cultural Heritage in the Arab World)، تحرير هشام العلوي وروبرت سبرينجبورج (دار لين رينير للنشر، 2025)، 128.
[10] المرجع السابق، 133.
[11] ليندسي ج. بنستيد، ليبيا وتونس: الاقتصاد السياسي لاستخدام اللغة (Libya and Tunisia: The Political Economy of Language Use)، في «الاقتصاد السياسي، والسلطة، والتراث الثقافي في العالم العربي» (Political Economy, Power, and Cultural Heritage in the Arab World)، تحرير هشام العلوي وروبرت سبرينجبورج (دار لين رينير للنشر، 2025)، 164.
[12] المرجع السابق، 173.
[13] إيثان د. كورين، ليبيا: تراث ممزق، ودولة ممزقة (Libya: Fractured Heritage, Fractured State)، في «الاقتصاد السياسي، والسلطة، والتراث الثقافي في العالم العربي» (Political Economy, Power, and Cultural Heritage in the Arab World)، تحرير هشام العلوي وروبرت سبرينجبورج (دار لين رينير للنشر، 2025)، 145.
[14] العلوي وسبرينجبورج، نحو اقتصاد سياسي للتراث الثقافي في العالم العربي (Toward a Political Economy of Cultural Heritage in the Arab World)، 21.
Read this post in: English