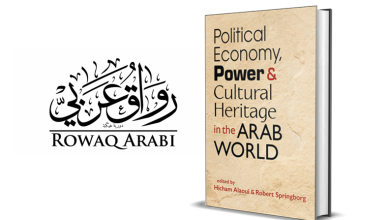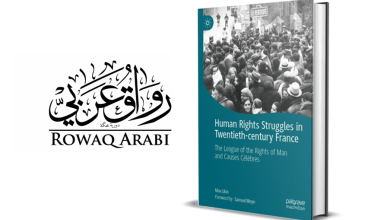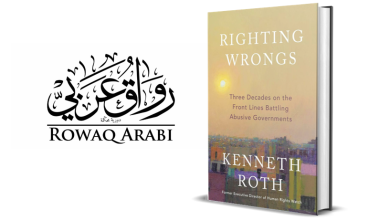مراجعة كتاب: «حكمة المصريين» لمحمد السيد سعيد
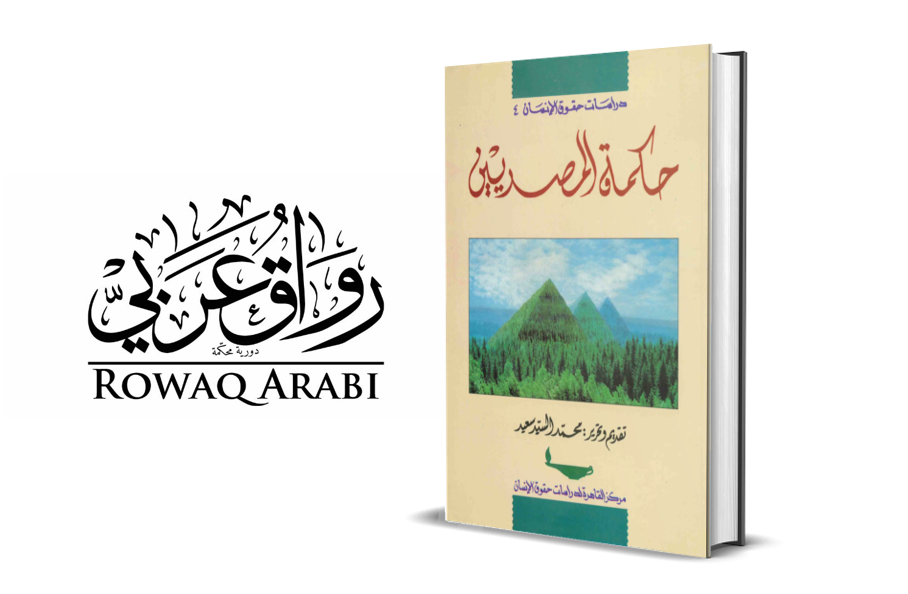
الإشارة المرجعية: الرمضاني، مسعود (2024). مراجعة كتاب: «حكمة المصريين» لمحمد السيد سعيد. رواق عربي، 29 (2)، 16-19. DOI: 10.53833/WFCZ7584.
إن المهتمين بالشأن العام من جيلنا، الأكبر سنًا في المنطقة العربية، تؤرقهم الهواجس بشأن كيفية تحفيز الشباب لإعادة قراءة تاريخهم الوطني بمعزل عن هالات التقديس الساعية لإعادة إنتاجه، أو تحقير يحيل بؤس الحاضر السياسي والاجتماعي لماضي حضاري وثقافي خاوي ومليء بالكوارث والمآسي والمظالم. بعبارة أخرى؛ كيف نحثّ شباب اليوم، الذين هم أنفسهم صنّاع المستقبل، على قراءة تاريخ بلدانهم بموضوعية، وهم فخورين بالإنجازات المحققة، منتبهين للعوائق والإخفاقات التي عرقلت البناء والتطور، ومستخلصين الدروس من نجاحاته وانكساراته.
كتاب «حكمة المصريين»[1] –الذي كتب فصوله عدد من أهم الكتاب المصريين،[2] وقدمه وحرره الفقيد محمد السيد سعيد، وأصدره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان منذ 25 سنة (1999)– يتناول هذا الإطار؛ فهو يتوجه لجيل الشباب كي يعيد استيعاب تاريخ مصر والتعلم من دروسه، عله يتمكن لاحقًا من صياغة مشروع حضاري للخلاص الوطني، يساهم في استعادة البلاد «حريتها وريادتها التاريخية»، بعيدًا عن التاريخ الذي شوهته الادعاءات الاستعمارية أو ذلك الذي نسجته الأيديولوجيات السياسية أو المزاعم الدينية.
يجادل الكتاب بأن الدارس المتمعن في المسار التاريخي والحضاري المصري يدرك أن مستقبل البلاد رهين ثلاثة مسارات متكاملة وغير قابلة للفصل، وهي استيعاب كل مقومات النهضة بأبعادها الثقافية والتكنولوجية والعلمية، إلى جانب الابتعاد عن الفتن الطائفية والدينية التي تسببت في اضطرابات قاتلة، وكذلك وتمتع المصريين بكل مقومات المواطنة، بما في ذلك الحقوق السياسية والمدنية. وبحسب الكتاب، فإن هذا هو السبيل لمناعة البلد «ضد غوائل الزمن وافتراء الطغاة من الداخل والخارج» وقطع دابر اليأس، حتى يستعيد «الأمل بريقه وروعته».
لكن لابد لهذا الشباب الطامح لبناء مستقبله من إدراك، عبر استقراء تاريخ بلاده، مكامن القوة للبناء عليها وعوامل الضعف لتجاوزها؛ فمصر تمتلك تاريخًا حضاريًا ومدنيًا يكاد يكون فريدًا، منح المصريين أبعادًا أخلاقية متميّزة في تعاملهم مع بعضهم البعض ومع الغير، أهم مقوماتها التسامح وحب الخير والمعروف. الى ذلك، يمتلك المصريون إبداعًا معماريًا وفنيًا وثقافيًا، انعكس في بناء الأهرامات وفي نشأة الكتابة وتطورها، كما تمثل في الاستيعاب المبكر لمقومات النهضة الفكرية والتنويرية، التي ظلت تعبيراتها تظهر من حين لآخر في كل مجالات الحياة المصرية؛ رغم محاولات الاستبداد والاستعمار خنقها وتدجينها في فترات عديدة.
وكاد امتلاك تلك المقومات الأخلاقية والحضارية والثقافية أن يؤسس لنقلة نوعية في تطور مصر تضعها بين مصاف الدول المتقدمة؛ لولا عوامل الضعف التي تكاد تكون متأصلة في حياة المصريين، والتي تتمثل في غياب التوازن بين العام والخاص، أو تلك النزعة التي تهتم بالمجال الاجتماعي في أدق تفاصيله، ولكنها في الوقت نفسه تهمل الجانب السياسي العام؛ خاصة فيما يتعلق بتلك العلاقة التعاقدية التي يجب أن تربط المواطن بالحكم القائم. بالإضافة لما شهدته مصر من فترات وهن وضعف، حينما سيطر الدين على الدولة وهيمنت المؤسسات الدينية على العلاقات العامة؛ ما نتج عنه استبداد السلطة وتقلص حيز التسامح وبروز مظاهر التطرف الديني.
تلك الاختلالات هي التي مكنت –في بعض مراحل تاريخ مصر الطويل– قوى استعمارية من احتلال البلاد. كما دفع إهمال الشأن العام الحكام المستبدين لاستغلال طيبة الشعب وسعة صدره؛ لفرض تسلطهم. فيما أفرزت تلك الإرهاصات الدينية المتشددة –في بعض الأحيان– اضطهادًا دينيًا وصراعات مذهبية، وهددت «التكوين الحضاري المصري» بل وأضرت بالاستقرار والتآلف بين مكونات المجتمع.
لكن ما الذي ينبغي على شباب مصر إدراكه بشأن تاريخ بلادهم حتى يكون لهم أداة فاعلة لبناء مستقبل قوامه الحرية والديمقراطية والعدالة؟ في البداية لابد أن يدركوا أن مصر هي أمة بذاتها لها حضارة وتاريخ، وأن حكمة المصريين القدامى جمعت بين الأخلاق والعقل «في رابط لا ينفصم»، وأن الوظيفة الأساسية للدولة يجب أن تبنى على إقامة العدل، وأن إساءة استغلال السلطة يؤدي إلى «خلل في نظام الكون والمجتمع».
ولأن الاعتزاز بالانتماء يساهم في اكتساب الثقة بالنفس ويعمق الإحساس بالمواطنة ويحفز للفعل السياسي والمدني؛ فلم يبخل الكتاب بالتذكير بمقومات المجتمع المصري عبر الفترات التاريخية الطويلة. إذ أظهر هذا الشعب صمودًا غير مألوف أمام تعدد نظم الحكم وتتالي الغزوات، كما حافظ على استمرار هيكلته وبنائه ومقوماته الحضارية حتى في أحلك فترات الاستبداد وفي واقع السيطرة الاستعمارية؛ لأن «المجتمع [المصري] يحقق استمراريته من خلال البناء الاجتماعي المدني، لا من خلال البناء السياسي الرسمي المتقلب».[3] وكذا بالنسبة للعقيدة الدينية التي ظلت شخصية وغير محددة في الهوية المجتمعية المصرية، ومعني ذلك أن يظل الشخص مصريًا قبل أي انتماء ديني أو عرقي أو إقليمي.[4]
ورغم أن الدين قد لعب دورًا مهمًا في حياة المصريين وثقافتهم؛ فانه لم يرتبط بالطقوس فقط ولا «بثقافة الموت» وحدها، وإنما أضفى المصريون عليه البهجة والسرور. ورغم تتالي المعتقدات الدينية على مصر؛ فقد ظل دائمًا الإنسان المصري يعتبر الدين جزءً من الحياة العامة، يمتزج فيه الخشوع بالمرح والتدين بالأخلاق، وتحيل الأخلاق هنا إلى معاني دنيوية إيجابية، جوهرها الرحمة والعدالة ورفض الظلم والقسوة في التعامل مع الأخر.
يحب الشعب المصري الإبداع والكتابة والفن والغناء بقدر حبه للحياة؛ فالمصريون وضعوا الكتابة في قمة المهن والأعمال، ووضعوا الرسوم والصور في أعلى المراتب الفنية لأنها تعيد إنتاج الحياة، وأحبوا الفن للفن لأنهم يؤمنون بالقيم الجمالية التي تحملها التعبيرات الفنية قبلما يؤمنوا «بالمصلحة المباشرة لأي عمل».[5] أما الطرب المعاصر فقد أعطى بعدًا أكثر روعة وجمالية، خاصة بتأثير أربعة رموز فنيّة فريدة: السيد درويش الذي نقل الفن من مخادع الأمراء وقصور الأغنياء إلى أبناء الشعب البسيط، ومحمد عبد الوهاب الذي مزج بين التراث الشرقي وحداثة النغم المعاصر، وأم كلثوم التي مثلت تجسيدًا حيًا لإبداعات كلا من درويش وعبد الوهاب. وأخيرًا عبد الحليم حافظ، الذي نشأ مع ثورة 1952 ومثّل تجسيدًا لملامح الوطنية الذي حملها ذاك الجيل.
هذا التاريخ الحضاري والثقافي المصري تفاعل مع عنصرين رئيسين؛ نهر النيل الذي طبع حياة المصريين وأثر في وجدانهم –وكذا قصصهم وحكايتهم الشعبية وفنونهم– وكان دائمًا «الظاهرة الجغرافية الفذة في حياة المصريين وأهم عوامل تكوينهم الحضاري».[6] إلى جانب «الفتح الإسلامي» الذي شكل منعطفًا مهمًا في تاريخ المصريين، وما كان لهذا الدين الإسلامي أن يؤثر لولا استيعابه –ولو جزئيًا– لقيم الحداثة بأبعادها الثلاثة، أي «الحرية والنهضة والتنوير» من خلال أباء المشروع النهضوي من أمثال محمد عبده وقاسم أمين وفتحي زغلول وأحمد لطفي السيد وصولًا إلى طه حسين.
ولكن التحديث ليس أمرًا سهلًا، فهو يشكل في بعض الأحيان «معاناة فادحة» تستوجب التخلص من الحكم المطلق الذي يستبيح ثقافة المجتمع ويشوهها؛ إذ أن الحرية هي طريق الإبداع وأهم شروط التحديث وعصرنة المجتمع. وقد ارتبطت الحياة العصرية لدي المصريين بثلاثة عناصر رئيسية: أولها الغرف من القديم (التراث) واستلهام ما يمكن أن يكون مصوغًا للحياة المعاصرة. وثانيًا التواصل مع العقلية المعاصرة في المجتمعات المتقدمة لجلب ما يمكن أن يلائم مزاج الشعب حتى يتمكن من النمو والإنتاج والتطور. وأخيرًا التفاعل والانسجام مع السمات الخاصة التي تنحت الشخصية المصرية بما تحمله من عواطف وميول وأفكار وأراء.
ولا تزال مصر تصارع من أجل «إتمام تحديث ذاتها»، رغم دخولها الحداثة مبكرًا؛ إذ أن العلم والتعليم الإبداعي العلمي هما أهم مقومات النهضة. وفيما أقرت مصر، منذ أربعينيات القرن الماضي، بضرورة إصلاح التعليم، وشكلت لجان لتحديث برامجه وتبنت ثورة يوليو (1952) صيغة إلزامية التعليم، كما أقرت مجانيته في كل المراحل؛ إلا أن بناء المدارس والمعاهد والجامعات، رغم مساهمته في انتشار التعليم بشكل واسع، فقد استمرت النوعية في التدهور، ولم يواكب الكيف غزارة الكم. وظلت «المهمة الرئيسية للتعليم العالي هي إنتاج موظفين للدولة ولم تتغيّر هذه المهمة رغم أن الحكومة توقفت عن التوظيف».[7]
وبقي التحديث منقوصًا ومهمشًا نظرًا لغياب الديمقراطية، ذاك «الشوق الإنساني الرفيع»، فهي شرط النهوض المصري وهي كذلك الأداة الناجعة التي تفضي للتفاعل بين عناصر التكوين الوطني من «حضارات مختلفة وثقافات عديدة وديانات وقيم اجتماعية وسياسية وتيارات فكرية ومدارس علمية وإبداعية».[8]
وبالنظر إلى ثورة يوليو نظرة فاحصة، فرغم أنها حاولت تطبيق مشروع نهضوي أنضجته الحركة الوطنية المصرية قبلها؛ الا إنها باحتكارها المطلق للسلطة، قد حرمت تيارات فكرية وسياسية من النمو، ومنعتهم من المشاركة في إدارة شئون البلاد. والدرس العصيب الذي يجب أن تتعلمه مصر وهي تدلف للقرن الواحد والعشرين هو «ألاّ تتيح لتيار منفرد –مهما كانت سطوته– أن يخرج من حيز الفكر البشري –الذي يقبل الخطأ والصواب– لادعاء العصمة واحتكار الصواب».[9] وهذا الأمر لا يتعلق بأسلوب الحكم وإرادة السلطة فقط، إنما بالتربية الاجتماعية التي يجب أن تدافع عن التنوع الفكري والتعدد في الداخل والخارج، على حد سواء.
ويرى الكتاب –الذي طبع سنة واحدة قبل القرن الواحد والعشرين– أن مصر ستدخل منعرجًا تاريخيًا مهمًا وهي تحمل الكثير من الآمال، ولكنها تعاني في الوقت نفسه من تركة ثقيلة من المشاكل؛ فقد حققت بعض النجاح الاقتصادي خلال النصف الثاني من القرن العشرين ولم تفقد تقليدها الحضاري الضارب في القدم. كما لم تؤثر الخلافات الفكرية والسياسية على وحدة الأمة وتماسكها، مما يثبت أن مصر «قادرة على الاجتماع على قلب واحد من حيث الدفاع عن مبادئها وقيمها ومصالحها».[10]
ولكن يظل التحدي الأكبر أن التقدم الاقتصادي والنهوض الثقافي والاستقرار السياسي، كلها مرتبطة بتمتع جميع المصريين بحقوق الإنسان الأساسية وحقوق المواطنة الفعلية، بما فيها حرية الضمير والاعتقاد والتعبير والتجمع والمشاركة في إدارة شئون البلاد وصياغة تشريع وطني «يحيط حقوق الإنسان بسياج من الاحترام والتوقير بما يجعل انتهاك هذه الحقوق جريمة أخلاقية بالقدر نفسه الذي يجعله جريمة قانونية».[11]
صحيح أن الكتاب موجه للشباب ليكون مصدر إلهام عبر معرفة تاريخ بلادهم، ولكن يمكن أن يفيد عموم الشعب وكذلك شعوب المنطقة، خاصة أولئك الذين لهم قراءة أحادية للتاريخ، تمجيدية أحيانًا وانتقائية في أحيان أخرى؛ إذ يتضمن رسالة بأن مصر كانت حضارة مهمة ومصدر العديد من القوانين الوضعية التي ألهمت العالم، لكن على الجميع –خاصة الشباب– إدراك ثلاثة أمور أساسية: أن التاريخ هو خزّان دروس، وهو سيرورة لا يمكن استعادته أو قراءته انتقائيًا باستحضار «فترة أو حالة». وثانيًا أن صياغة مشروع مستقبلي، يستوجب، إلى جانب الاستفادة من دروس الماضي، الانفتاح على الحضارات الأخرى والغرف منها، مثلما حاول رواد النهضة. وأخيرًا أن التماسك الداخلي، المستند على الحرية والمواطنة، هو صمام الأمان ومفتاح التقدم. إذ كانت فترات ازدهار مصر كانت مرتبطة بتفاعلاتها الداخلية «التي أثرت تأثيرًا إيجابيًا في ازدهار البلاد»، ولكن مصر عرفت «فترات تاريخية من الخمود والانهيار عندما عرفت تفاعلاتها الداخلية الاختلال بسبب الاحتكار أو القمع أو إنكار ما لشخصيتها من جوانب متعددة وزاخرة بمعان تاريخية وعقيدية متنوعة».[12] وتلك أفكار لم تكن أكثر راهنية مما هي عليه اليوم، بعد ربع قرن.
[2] الكتاب هم: أحمد أبو زيد، احمد زايد، اسحق عبيد، حامد عبد الرحيم، حسن طلب، حلمي سالم، رؤوف عباس، عبد المنعم تليمة، وقاسم عبدة قاسم.
[3] ص 71.
[4] ص 77.
[5] ص 118.
[6] ص 172.
[7] ص 223.
[8] ص 193.
[9] ص 195.
[10] ص 262.
[11] ص 269.
[12] ص 196.
Read this post in: English