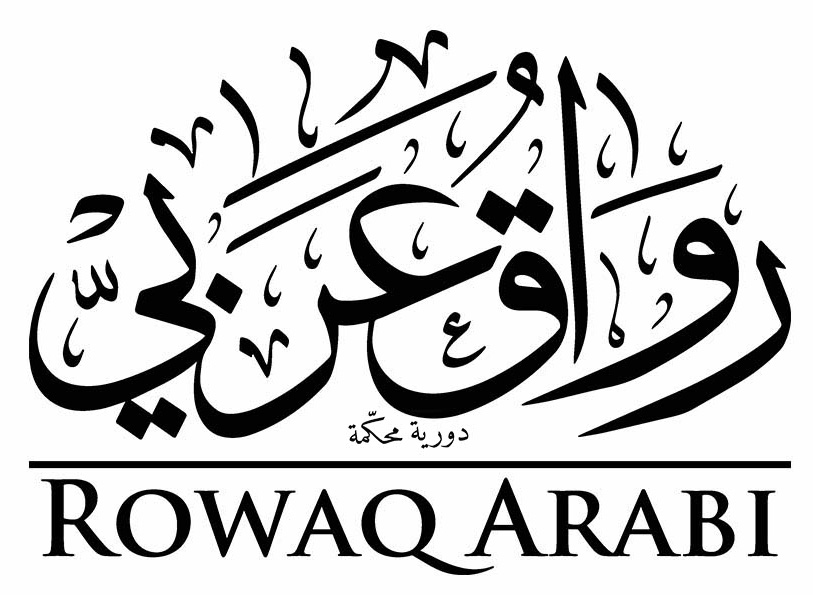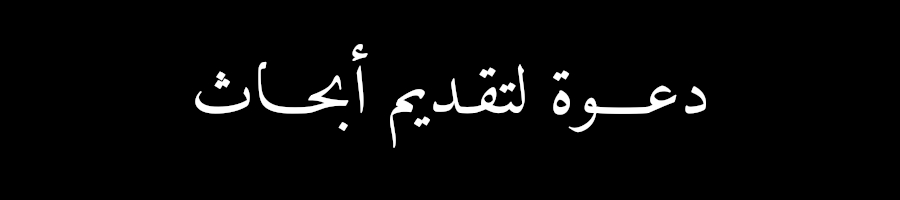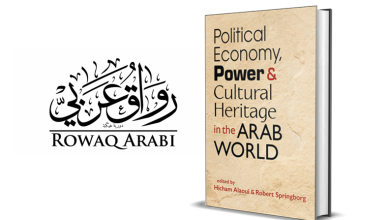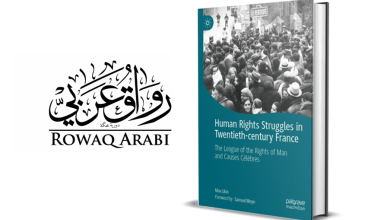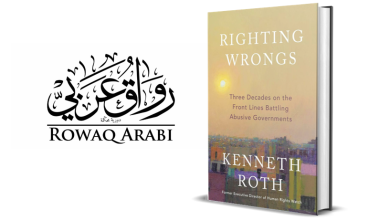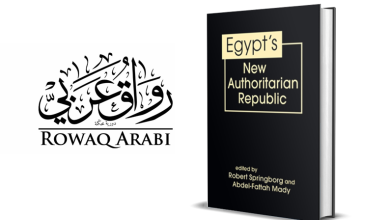مراجعة كتاب: العدالة الانتقالية ومحاكمة القادة السياسيين في المنطقة العربية لنهى أبو الدهب
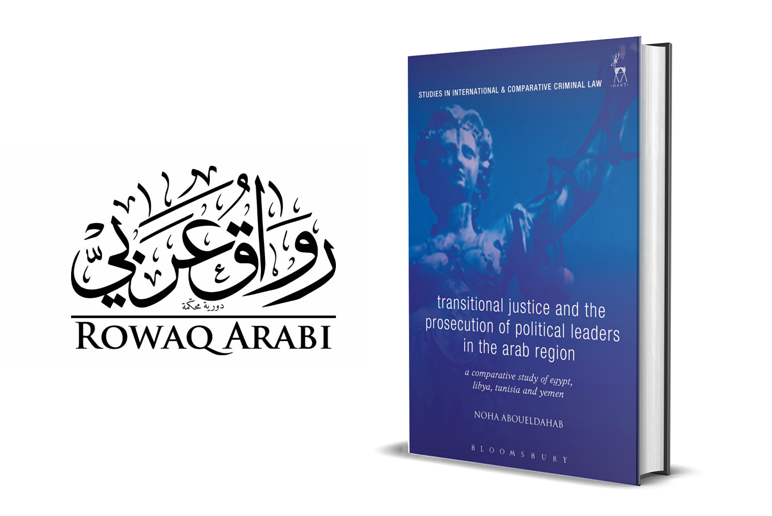
الإشارة المرجعية: الدردري، سيما (2025). «مراجعة كتاب: العدالة الانتقالية ومحاكمة القادة السياسيين في المنطقة العربية لنهى أبو الدهب.» رواق عربي، 30 (1): 58-62. https://doi.org/10.53833/YSNQ6208.
العنوان: العدالة الانتقالية ومحاكمة القادة السياسيين في المنطقة العربية: دراسة مقارنة بين مصر وليبيا وتونس واليمن
السلسلة: دراسات في القانون الجنائي الدولي والمقارن
الناشر: دار هارت للنشر
سنة النشر: 2017
الرقم الدولي المعياري للكتاب (ISBN): 9781509936403
المُعرّف الرقمي الموحّد (DOI): https://doi.org/10.5040/9781509911363.
رغم محدودية نطاق العدالة الانتقالية وتطبيقها؛ شهدت المنطقة العربية بضعة دعوات لتطبيق العدالة الانتقالية قبل انتفاضات عام 2011. إلا أن هذا الأمر اكتسب أهمية بارزة بعد عام 2011؛ إذ أنه في خلال عام واحد، مثُل الرئيس المصري حسني مبارك أمام المحكمة، وحوكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي غيابيًا. فيما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي، وتنحى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بموجب اتفاق توسط فيه مجلس التعاون الخليجي وحصل بموجبه على الحصانة.
لكن هل أسفرت هذه التطورات عن تحسين ملموس في حياة الناس اليومية؟ في كتابها «العدالة الانتقالية ومحاكمة القادة السياسيين في المنطقة العربية: دراسة مقارنة بين مصر وليبيا وتونس واليمن»، تُبرهن نهى أبو الدهب أن ذلك لم يتحقق. تُعرّف أبو الدهب العدالة الانتقالية بأنها «العمليات التي يمارسها مختلف الفاعلين»، بما في ذلك «الدولة، والمجتمع المدني، والضحايا»، والمحامون والقضاء،[1] لمعالجة الفظائع التي حدثت في الماضي من خلال آليات متعددة؛ مع أن تركيزها الأساسي ينصب على المحاكمات. وهي تجادل بأن العدالة الانتقالية في مصر وتونس وليبيا واليمن كثيرًا ما تم استغلالها من جانب النخب السياسية لخدمة مصالحهم الخاصة. إلا أن هذا لا ينفي حدوث تغييرات، ولكنها ببساطة اتجهت نحو مسار أكثر قمعًا. ويسهم بحث أبو الدهب في سد فجوة في الأدبيات من خلال تقديم «تأمل مقارن صارم» يتحدى الافتراض الأكاديمي بأن «المنطقة العربية لم تشهد انتقالات أو أنها اختبرت انتقالات متعثرة».[2] وهي تستند بشكل أساسي إلى عمل ميداني أجرته في البلدان الأربعة بين عامي 2012 و2017، استنادًا إلى مقابلات مع أربعة وأربعين من أصحاب الخبرة، مما منحها وصولًا فريدًا إلى المعلومات والمقابلات والأحداث الرئيسية.[3]
تتمثل المساهمة الجوهرية لهذا الكتاب في تبنيه نهجًا مغايرًا للعدالة الانتقالية عن النموذج الغربي السائد الذي تشكل بفعل التحولات في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.[4] ويميل هذا النهج إلى منح الأولوية للحقوق السياسية على حساب الحقوق الاقتصادية، ويفترض وجود تحول خطي من حالة انعدام الأمن إلى السلام، ومن السلطوية إلى الديمقراطية الليبرالية. ويعتمد على معايير المساءلة العالمية، ويركز على الجهود المبذولة بعد الانتقال، ويفترض وجود مؤسسات قوية ومستقلة لضمان التنفيذ الناجح. ومن خلال فحص الجهود السابقة واللاحقة للفترات الانتقالية في المنطقة العربية، تجادل أبو الدهب بأن دراسات الحالة التي أجرتها تتحدى نموذج العدالة الانتقالية السائد بأربع طرق رئيسية. أولاً، لم تحدث جهود العدالة الانتقالية في سياقات تحول من السلطوية إلى الديمقراطية. ثانيًا، غالبًا ما اتبع مختلف الفاعلين المحليين والدوليين مقاربات متناقضة لتحقيق العدالة. ثالثًا، كانت التحقيقات محدودة النطاق وتركزت على القضايا الاقتصادية، الأمر الذي صرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأخيرًا، نُفذت جهود العدالة الانتقالية من خلال أنظمة قانونية ضعيفة وتخضع للتأثير السياسي.
يتكون الكتاب من سبعة فصول، بما في ذلك المقدمة والخاتمة. وتضطلع المقدمة بوظيفة مزدوجة، إذ تُقدم مراجعة للأدبيات ذات الصلة، وتُوضح في الوقت نفسه الإطار النظري الذي يعتمد عليه البحث؛ إذ تضع أبو الدهب بحثها ضمن الافتراضات المعيارية للعدالة الانتقالية، كما تستعرض منهجيتها وإطارها التحليلي. ويتمثل الإطار في آلية «المحفّز–الدافع–المُشَكِّل»، وهو منهج لتعقب المسار يعمل على تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر في جهود العدالة، متجاوزًا التقييمات القائمة على النتائج ليسلط الضوء على القرارات المبكرة المحورية في مسار العدالة. ويقدم الكتاب دراسات حالة وصفية عن مصر وتونس وليبيا واليمن، جميعها منظمة بطريقة متشابهة، مستعرضة المحفزات والدوافع والعوامل المُشكِّلة لكل منها. ويستكشف الفصل السادس الآثار الأوسع لهذه الحالات على العدالة الانتقالية من خلال تحليل مقارن. وتتضمن الموضوعات المتواترة في جميع أنحاء الكتاب كل من: الدولة العميقة، الأنظمة القضائية الفاسدة والضعيفة، ودور المحامين والنشطاء المحليين.
الدولة العميقة
في جميع دراسات الحالة الأربع، يكمن أحد الأسباب الرئيسية لإخفاق العدالة الانتقالية في استمرار الدولة العميقة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمؤسسة العسكرية والأمنية. فقد ورثت حكومات ما بعد عام 2011 هياكل الدولة القديمة وغالبًا ما أبقت على الأفراد أنفسهم. ونتيجة لذلك، تم تطبيق العدالة الانتقالية بشكل انتقائي؛ إذ جرى التضحية بالبعض ككبش فداء، بينما تم تجاهل الجرائم المنهجية التي ارتكبتها مؤسسات الدولة وقادتها على مدى عقود. وقد أُتيح ذلك من خلال التلاعب القانوني، واستخدام قوات الأمن، وتدمير الأدلة، والتركيز الحصري على الجرائم الاقتصادية.
على سبيل المثال، ظلّت الدولة العميقة في مصر قائمة إلى حد كبير بعد الإطاحة بمبارك، الأمر الذي كفل بقاء التحقيقات والمحاكمات ضمن حدود معينة، مما ساهم في الحفاظ على المصالح السياسية، ووفّر الحماية للدولة من المحاكمات من خلال التضحية بأشخاص مثل مبارك والتركيز على قضايا الفساد.[5] كما ساد الخوف من ملاحقة المسئولين رفيعي المستوى بسبب استمرار الترهيب من جانب أجهزة أمن الدولة.[6] وبالمثل، استمرت الدولة العميقة في تونس بعد بن علي، إذ عاد بعض رموز النظام السابق إلى الظهور مجددًا، وظلوا يقظين إزاء دعوات المحاسبة عن الجرائم السابقة. ولذلك، ضحى النظام «الجديد» أيضًا ببعض الأفراد، مثل وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال، لحماية آخرين.
على خلاف مصر وتونس، شهدت الدولة الليبية انقسامًا بين حكومات متنافسة بعد عام 2011. ومع ذلك، ظل بعض مسئولي النظام السابق حاضرين، ومارسوا «دورًا مباشرًا في توجيه مسار المحاسبة الجنائية لبعض القادة السابقين، وعلى رأسهم سيف الإسلام القذافي، في اتجاهات مختلفة».[7] وفي دولة أخرى منقسمة، هي اليمن، «تغيّرت وجوه النظام»، إلا أن عقليته «ظلت قائمة».[8] فقد عمل حلفاء صالح على تعيين أشخاص يدينون لهم بالولاء في مناصب رئيسية في المجلس الأعلى للقضاء، واستخدموا قوات الأمن لتدمير الأدلة، مما قوّض جهود المحاكمات وحوّل التركيز إلى الجرائم الأحدث عهدًا.
الأنظمة القضائية الضعيفة والفاسدة
ومن الموضوعات الرئيسية الأخرى ضعف وفساد الأنظمة القضائية «المُعطلّة بفعل تدخل السلطة التنفيذية»، فضلًا عن افتقارها للأطر القانونية الملائمة.[9] ففي دراسات الحالة الأربعة، أدت هشاشة المؤسسات القانونية، قبل وبعد الفترات الانتقالية، إلى الحد بشكل كبير من إمكانية إجراء المحاكمات القضائية. في مصر، ينص قانون السلطة القضائية على أن يُعيِّن الرئيس النائب العام ورئيس محكمة النقض، كما تسيطر السلطة التنفيذية على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.[10] الأمر الذي أسفر عن إخفاقات متكررة في التحقيق العادل في قضايا التعذيب، لاسيما وأن مكتب النائب العام يعمل بشكل وثيق مع الشرطة المتورطة في الانتهاكات. وفي أعقاب المرحلة الانتقالية، ظلت بنية النظام دون مساس، وتم تجميد العديد من القضايا ضد المسئولين رفيعي المستوى. وفي تونس التي تعاني من نيابة عامة مُسيسة وكذلك من ضعف الإطار القانوني، وفي ظل غياب الإصلاحات الرئيسية لقانون العقوبات؛ عُقدت العديد من محاكمات العدالة الانتقالية في المحاكم العسكرية، مما قوّض استقلال القضاء، كما أسفر غياب مبدأ مسئولية القيادة عن الحد بشكل متزايد من المحاسبة.
في ليبيا، افتقر القضاء في ظل حكم القذافي إلى الاستقلالية، مما عزز فقدان ثقة الجمهور به وأدى إلى تقييد عدد الشكاوى التي يقدمها الضحايا. ولا تزال البلاد تفتقر إلى إطار قانوني يسمح بمحاكمة مرتبكي بعض الجرائم، مثل الجرائم ضد الإنسانية، فضلًا عن ضعف مؤسساتها القضائية. واليوم، لا يزال «إرث العدالة التعسفية وانعدام ثقة العامة في القضاء» يقوضان تحقيق العدالة، ما سمح للميليشيات بالهيمنة على المشهد، كما تجلى في الاحتجاز المطول لسيف الإسلام القذافي في الزنتان،[11] الأمر الذي أضعف نطاق المحاكمات وجوهرها. أما في اليمن، فرغم أن الدستور يضمن استقلال القضاء؛ إلا أن تدخل السلطة التنفيذية واسع النطاق ظل مستمرًا. إذ يُعيّن القضاة ويُعزلون من قبل وزارة العدل والرئيس، و«يتم نقلهم قسريًا إذا أصدروا أحكامًا غير مرغوبة من جانب الحكومة»؛ بل إن صالح نفسه ترأس المجلس الأعلى للقضاء حتى عام 2006. ويواجه القضاء اليمني ضعفًا متواصلًا، ويعاني من نقص الكوادر. كما ينقسم على أسس قبلية، ويتفشى فيه الفساد والمحسوبية، الأمر الذي يعوق الكثيرين عن اللجوء إلى العدالة.
دور الجهات الفاعلة المحلية
يُولي الكتاب أهمية بالغة لدور المحامين الأفراد ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك أولئك المنخرطين في الحركات العمالية، في إطلاق ودفع مبادرات العدالة الانتقالية قبل وبعد انتفاضات الربيع العربي. ففي مصر، أدت الإضرابات العمالية إلى نشأة حركة شباب 6 أبريل في 2008، وتأسيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في عام 2011؛ وقد مارس كلاهما دورًا حاسمًا في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والسياسية. ورغم تعرض المنظمات غير الحكومية والنشطاء والمحامين للقمع؛ إلا أن المجموعات العمالية كانت تحظى بقدر من التسامح النسبي. ومع ذلك، واصل المجتمع المدني توثيق الانتهاكات أملًا في استقلال القضاء مستقبلًا. وقد أكد من أُجريت معهم المقابلات أن الضغط الشعبي والمساهمات الفردية للمحامين كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحفيز المحاكمات القضائية عقب الانتفاضة.
في تونس، شكّل الحراك العمالي قوة معارضة رئيسية إلى جانب نقابة المحامين ونشطاء حقوق الإنسان ومجموعة الـ25 المُشكّلة من المحامين. فقد كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد تحدى سياسات الدولة التي أدت إلى احتجاجات جماهيرية في قفصة عام 2008، والتي أشعلت شرارة انتفاضة 2010. وبعد سقوط بن علي، تقدمت نقابة المحامين ومجموعة الـ25 بشكاوى نيابة عن الضحايا. وفي 2012، أنشأت النقابة مجموعة عمل معنية بالعدالة الانتقالية. وكما هو الحال في مصر، دفعت الحركات العمالية في تونس جهود المحاسبة الجنائية، فيما واصل نشطاء حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات. وقد أصبحت هذه المهمة أكثر صعوبة بعد المرحلة الانتقالية، مع تصاعد قمع الحقوق السياسية في عهد الرئيس قيس سعيّد.[12]
في ليبيا، كان النشاط الحقوقي في ظل حكم القذافي يواجه قمعًا شديدًا. ورغم ذلك؛ تمكن ضحايا عنف الدولة، خاصة ضحايا مذبحة سجن أبو سليم عام 1996،[13] إلى جانب بعض المحامين، من الحصول على تعويضات مالية رغم العقبات القانونية، كما سعوا إلى تحريك دعاوى قضائية بعد المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ضد رئيس الاستخبارات العسكرية السابق. لكن بعد سقوط القذافي، دفع الخوف من الاغتيال المحامين ونشطاء المجتمع المدني إلى تحويل تركيزهم من المحاكمات إلى المصالحة. وفي اليمن، أتاحت القوانين الداعمة وجود مجتمع مدني قوي، بما في ذلك حركة الحراك.[14] وقد أدى الضغط الشعبي إلى شن حملة اعتقالات في قضية قتل حدثت عام 2010، وكذا إضراب عام أسفر عن إجراء إصلاحات في شروط العمل بالقطاع العام. ومع ذلك، فإن تفاقم انعدام الأمن قد أعاق بشكل كبير تقدم مسيرة العدالة الانتقالية.
خلاصة
بينما يقدم الكتاب أدلة تجريبية قيّمة، إلا أن بعض النقاشات النظرية الرئيسية، مثل جدلية السلام مقابل العدالة ومعيار المحاسبة العالمي، قد طُرحت في موضع متأخر من التحليل، وكان من الأجدى تضمينها في المقدمة. كما أن مراجعة أكثر وصفية للأدبيات الخاصة بالعدالة الانتقالية في المنطقة العربية، حتى وإن كانت محدودة، كانت ستساعد أيضًا في وضع البحث في سياقه منذ البداية. ومع ذلك، تقدم أبو الدهب رؤى مهمة حول العمليات القضائية في المنطقة. وبينما يشيد الكتاب بجهود المحامين في توثيق انتهاكات الحقوق، فإن كتابها يُعد أيضًا سجلًا يمكن الاستفادة منه في تطوير مبادرات ونظريات العدالة الانتقالية المستقبلية.
ورغم تعثر العدالة الانتقالية في الحالات الأربع؛ فإن سوريا اليوم تمثل فرصة لتطبيق الدروس المستفادة من هذا الكتاب وتجنب الإخفاقات المماثلة. فقد انعتقت سوريا من هيمنة الدولة العميقة، مما خلق إمكانية بناء دولة جديدة ونظام قضائي وعقد اجتماعي جديدين، مع إتاحة المجال للنشطاء والمحامين لأن يمارسوا أدوارًا فاعلة لأول مرة منذ عقود. وبالنظر إلى أن «بناء مؤسسات الدولة –حتى من الصفر– هو مهمة صعبة لكنها ضرورية للغاية بالنسبة للدول التي تمر بفترات انتقالية وتسعى لتحقيق أي شكل من أشكال العدالة ذات المغزى»؛[15] فقد تكون لدى سوريا فرصة أفضل للنجاح. إذ سقط النظام القديم بالكامل، وتقع المسئولية الآن على عاتق النظام الجديد لتحقيق العدالة ووضع نموذج إيجابي للمنطقة.
ملاحظة
استخدمت الكاتبة أحد أدوات الذكاء اصطناعي للمساعدة في المراجعة اللغوية للنسخة الانجليزية للمقال.
هذا المقال كتب في الأصل باللغة الانجليزية لرواق عربي.
[1] نهى أبو الدهب، العدالة الانتقالية ومحاكمة القادة السياسيين في المنطقة العربية: دراسة مقارنة بين مصر وليبيا وتونس واليمن (Transitional Justice and the Prosecution of Political Leaders in the Arab Region: A Comparative Study of Egypt, Libya, Tunisia and Yemen) (دار هارت للنشر، 2017)، 3،http://dx.doi.org/10.5040/9781509911363 .
[2] أبو الدهب، العدالة الانتقالية، 15.
[3] على سبيل المثال، أقامت في الفندق الذي استضاف المرحلة الأخيرة من مؤتمر الحوار الوطني اليمني.
[4] أبو الدهب، العدالة الانتقالية، 19.
[5] المرجع السابق، 32.
[6] المرجع السابق، 29.
[7] المرجع السابق، 22.
[8] اقتباس من المحامي الحقوقي عبد الرحمن برمان. المرجع السابق، 112.
[9] المرجع السابق، 155.
[10] المرجع السابق، 155.
[11] المرجع السابق، 94.
[12] ميشيل عياري وريكاردو فابياني، «تونس قيس سعيد: تجربة في السلطوية الهشّة» (Saïed’s Tunisia: An Experiment in Fragile Authoritarianism)، المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، 4 أكتوبر 2024، تم الاطلاع في 1 يونيو 2024، https://www.ispionline.it/en/publication/saieds-tunisia-an-experiment-in-fragile-authoritarianism-185785.
[13] ورد في: أبو الدهب، العدالة الانتقالية، 81؛ هيومن رايتس ووتش، «ليبيا تتذكر مذبحة سجن أبو سليم» (Libya: Abu Salim Prison Massacre Remembered)، 27 يونيو 2012، www.hrw.org/news/2012/06/27/libya-abu-salim-prison-massacre-remembered.
[14] الحراك هو حركة انفصالية في الجنوب بدأت في عام 2007، وأشعلت مواجهات عنيفة بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الجيش والأمن الموالية لصالح.
[15] أبو الدهب، العدالة الانتقالية، 159.
Read this post in: English