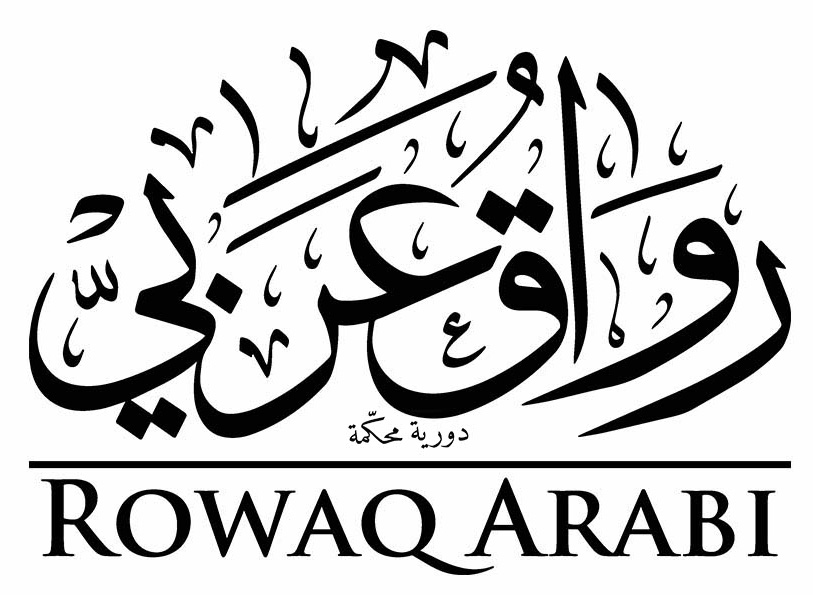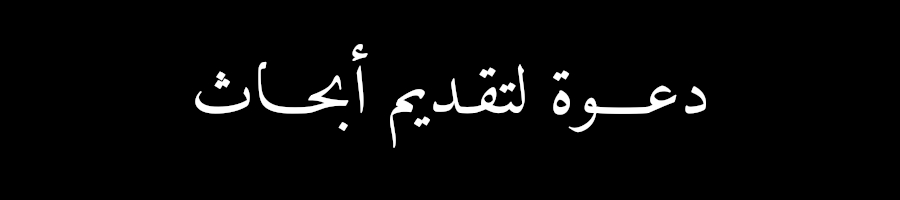شبكات الأمان الاجتماعي بمنطقة الخليج العربي: النماذج والرهانات

الإشارة المرجعية: زعنون، عبد الرفيع. 2025. «شبكات الأمان الاجتماعي بمنطقة الخليج العربي: النماذج والرهانات.» رواق عربي 30 (2): 5-19. https://doi.org/10.53833/RJHF3718.
خلاصة
حظيت الرعاية الاجتماعية باهتمام خاص في مختلف مراحل نشأة وتطور الدولة الحديثة بمنطقة الخليج العربي؛ إذ حتمت عليها ظرفيات حرجة آنذاك استيعاب متطلبات تحديث الفعل الاجتماعي للدولة دون المساس بالقاعدة الاجتماعية للنظام السياسي. تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف محاولات الدول الخليجية تصميم شبكات الأمان الاجتماعي من خلال الإجابة عن السؤال المركزي التالي: ماهي الرهانات الكامنة وراء تصميم وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي بالمنطقة الخليجية في ضوء التحولات المحلية والدولية؟ تتألف الدراسة، بالإضافة إلى الإطار النظري والمفاهيمي، من أربعة محاور أساسية تشمل تتبع السياقات المؤسسة لنشأة وتطور شبكات الأمان الاجتماعي في كل من السعودية والكويت والبحرين، ورصد مظاهر الاختلاف والتشابه بين التجارب الثلاث، مع إبراز الحصيلة الحالية لتمويل وتنفيذ برامج المساعدة والحماية الاجتماعيتين، إلى جانب استشراف إمكانيات الارتقاء بشبكات الأمان الاجتماعي انطلاقًا من نماذج الدول الخليجية موضوع الدراسة. وتخلص الورقة لامتلاك الدول الثلاث أكبر شبكات أمان من حيث حجم الإنفاق الاجتماعي مقارنة بباقي الدول العربية. إلا أنه في الوقت نفسه، فإن حجم التمويلات «السخية» لا يتوافق مع التأثيرات المرغوبة في ظل تفاقم وضعيات اللامساواة واللاحماية في صفوف العديد من الفئات الهشة. وفي ظل استمرار عدة عقبات تحول دون تحقيق إقرار تحول منهجي في الدور الاجتماعي للدولة بالانتقال من المنطق «الرعوي» إلى استحقاقات دولة العقد الاجتماعي.
مقدمة
تتضمن شبكات الأمان الاجتماعي (Social safety nets) مجموع التدابير الرامية لحماية المواطنين من مختلف مخاطر دورة الحياة، كالمرض والفقر والعجز والإعاقة والبطالة. ضمن منظومة حماية اجتماعية متكاملة تنطوي على تدخلات متعددة في شكل صناديق للضمان الاجتماعي وبرامج للمساعدة الاجتماعية. وقد تفاوتت الاستجابات العربية لمعضلة اللاحماية حسب مرجعيات ورهانات السياسات الاجتماعية وسقفها التمويلي، وكذا التركيبة الاجتماعية والديموغرافية، فضلًا عن درجة التزامها بالأطر المعيارية الدولية، وخاصة اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية.
وقد خطت دول الخليج العربي خطوات هامة نحو مأسسة وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي؛ إذ تُعَد من أكبر الدول العربية تمويلًا للبرامج الاجتماعية، لكنها رغم ذلك تواجه عدة تحديات تحد من كفاءتها؛ كاتساع فجوات توزيع الدخل، وتمدد الأنشطة غير المُنظَّمة، وعدم جاهزية قواعد المعطيات الخاصة بتتبع وقياس الأوضاع السوسيواقتصادية للأسر على نحو يُعقِّد من إعمال منهجية الاستهداف الاجتماعي. ناهيك عن استمرار حالات إقصاء الفئات الهشة، كالنساء والمهاجرين والأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة للحفاظ على السلم الاجتماعي في ظل التهاوي التدريجي لأطروحة تعميم الرفاه الاجتماعي مقابل تكميم الحريات السياسية.
لمواجهة هذه التحديات، شهدت التجربة الخليجية تحولات مفصلية؛ فالسعودية تمكنت منذ 2017 –عبر برنامج حساب المواطن– من إرساء آلية موحدة لتعويض الأسر عن الآثار السلبية للإصلاحات المالية، إضافة إلى الإعانات المالية المخصصة لرفع الدعم عن منتجات الطاقة. على جانب أخر، تشهد الكويت حاليًا مرحلة مفصلية في سعيها لاستبدال نظام الدعم القائم على الدخل الأساسي الشامل بمنظومة شبكات أمان اجتماعي ترتكز على خدمات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، مع إعادة النظر في آليات الاستفادة من الدعم النقدي وفق مقاربة قائمة على الاستهداف. في السياق نفسه، ورغم محاولة البحرين الموازنة بين دعم المواد والخدمات الأساسية من جانب، وبين الدعم النقدي في شكل إعانات مالية مباشرة لمحدودي الدخل من جانب أخر؛ فقد أصبحت تميل نحو توجيه مخصصات الدعم العيني لتمويل التحويلات النقدية المباشرة لصالح الأسر المستحقة، مع مأسسة الإشراف على برامج الرعاية الاجتماعية: كاللجنة الوطنية لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة الوطنية للطفولة واللجنة الوطنية للمُسنِّين.
في ضوء ذلك، يبرز السؤال المركزي التالي: كيف تطورت مسارات شبكات الأمان الاجتماعي بمنطقة الخليج العربي وماهي الرهانات الكامنة وراء تصميمها وإعادة بنائها في ضوء التحولات السياسية والاقتصادية؟ انطلاقًا من هذا الإشكال يمكن صياغة فرضية الدراسة على النحو التالي: تنطلق محاولات تصميم شبكات الأمان الاجتماعي بدول الخليج من حسابات سياسية في ظل تضاؤل العائد السياسي للأشكال التقليدية للرعاية الاجتماعية، واقتصادية في ضوء تفاقم إكراهات الموازنة التي أضحت تدفع نحو تقليص الدور الاجتماعي للدولة بالاعتماد على منظومة استهداف تُشكل قاطرة للانتقال نحو تدخلات انتقائية تقتصر على الفئات الأشد تأثرًا باختلالات السوق.
لمعالجة إشكالية الدراسة وفحص فرضياتها، سنعتمد بشكل أساسي على أداة المقارنة لرصد أوجه التشابه والاختلاف بين مختلف التجارب الخليجية. يشمل الإطار المكاني للدراسة منطقة الخليج العربي بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية؛ لكونها من أولى التجارب الخليجية في تصميم شبكات الأمان الاجتماعي. فيما ينحصر إطارها الزمني في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد–19، مع الرجوع للسياقات المُؤسِّسة والمحفزة على مأسسة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك التطبيقات التي وضعت قبل الجائحة أو أثناءها.
يتألف هيكل الدراسة، فضلًا عن الإطار النظري، من أربعة محاور تشمل تتبع السياقات المؤسسة للشبكات الخليجية للأمان الاجتماعي، ورصد مكاسبها الكمية والنوعية وكذا استخلاص أبرز تقاطعاتها وتمايزاتها، مع استشراف سبل رفع تحدياتها وإمكانات تعزيز فعاليتها في ضوء الإطار المعياري الدولي.
إطار نظري للدراسة
تتألف شبكات الأمان الاجتماعي من ثلاثة مكونات أساسية، أولها تدخلات الرعاية الاجتماعية (Social Care)، التي لا تتطلب اشتراكًا؛ كدعم السلع الأساسية والتحويلات النقدية. وثانيًا التأمين الاجتماعي (Social Insurance)، الذي يستهدف توفير الحماية من مخاطر الحياة، كالشيخوخة والوفاة والترمل واليتم والبطالة والمرض وإصابات العمل.[1] وأخيرًا برامج الولوج إلى سوق العمل من خلال منح حوافز لخلق فرص العمل وتنمية المهارات، والتي تعتبر المحك الأساسي للحكم على متانة شبكة الأمان الاجتماعي؛ لكونها تستهدف الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأفراد بدلًا من كونهم في تبعية مستمرة لإعانات الدولة. وفق هذا المنظور، تمثل شبكات الأمان الاجتماعي التجلي الجوهري لمدى فعالية السياسات الاجتماعية، وقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والحماية والعمل والسكن اللائق والعيش الكريم.
من زاوية المسئولية المالية للدولة في تمويل شبكات الحماية الاجتماعية، أفرزت التجارب الدولية تطبيقات متفاوتة يتراوح مداها بين نموذجين أساسيين: النموذج البسماركي (Bismarckian) الذي يرتكز على دفع اشتراكات من جانب المواطنين مقابل الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، والنموذج البفريدجي (Beveridgean) الذي يقر بمسئولية الدولة في شمول الجميع بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك الفئات محدودة أو معدومة الدخل، والتي تفتقر للموارد اللازمة لدفع الاشتراكات. ورغم كون هذا النموذج هو الأقرب لمثالية «الدولة الاجتماعية»؛ فإن تطبيقه تكتنفه عدة إشكالات تتعلق باستدامة الإطار المالي، وبمقاومات الطبقات الغنية والوسطى،[2] التي ترى نفسها مرغمة على ممارسة دور اجتماعي هو من صميم عمل الدولة، خاصة مع تصاعد نزعات «لبرلة» (Libéralisation) أنظمة الحماية الاجتماعية على الصعيد الدولي بتخفيض الإنفاق العمومي على القطاعات الاجتماعية بما يقلص من مجالاته وعدد المستفيدين منها مقابل تشجيع أشكال جديدة من الحماية الاجتماعية يمارسها الخواص والمهنيون،[3] مع احتفاظ الدولة ببعض الأدوار التنظيمية، بإصدار النصوص والمؤشرات المعيارية، والضبطية باستحداث مؤسسات رقابية بالشراكة مع أصحاب المصلحة لضمان مراعاة قواعد المنافسة والمساواة في تقديم خدمات الضمان الاجتماعي.
من ناحية أخرى، وارتكازًا على معيار المشاركة، يمكن تصنيف برامج شبكات الأمان الاجتماعي إلى فئتين، شبكات رسمية يُفترض أن تتيح الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين بموجب قانون الميزانية السنوي، وشبكات أمان غير رسمية تعمل على مساعدة الفئات التي لا تتمتع بالحد الأدنى من الضمان الاجتماعي، والتي قد تُشكِّل، في بعض السياقات، أنظمة رعاية اجتماعية منفصلة تتجاوز الدولة، كما هو الحال مع بعض التشكيلات العرقية والدينية في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء.[4] وفيم يتعلق بتأثير الفاعلين غير الدَّولتِيين (non-state actors)، يميز بعض الباحثين بين أنظمة «أبوية» تنظر إلى أصحاب المصلحة كمنافسين ضمن مجال خصب لتدعيم وتجديد شرعية النظام السياسي، وتحصين قاعدته الاجتماعية من كل تيار قد يستثمر في مؤشرات الخصاص والهشاشة لبناء شرعية مضادة. في مقابل أنظمة ديمقراطية تعتبر مشاركة المنظمات المدنية والمهنية والنقابية شرطًا حاسمًا لجعل العقد الاجتماعي أكثر عدالة، عبر عمليات المراقبة والمساءلة لاختبار جودة وكفاءة البرامج الاجتماعية. وبين هذين المسارين ثمة أنظمة هجينة تحصر مساهمة الفاعلين غير الرسميين في ضخ التمويلات التطوعية وتنفيذ الأجندة الحكومية، دونما تتجاوز ذلك إلى المشاركة في صياغة المرجعيات المؤسسة أو مساءلة السلطات العمومية عن منهجية التدخل والآثار الفعلية.[5]
على مستوى الرهانات، ترتهن أطر توجيه وتمويل شبكات الأمان الاجتماعي بالعائد المتوخى منها. فمن الناحية الدستورية، من المفترض أن تشمل خدمات الحماية والرعاية الجميع، استنادًا إلى التفضيلات والحاجيات التي يُعبِّر عنها دافعوا الضرائب،[6] طالما أنهم يوفرون الوعاء المالي الضروري لتمويل شبكات الأمان الاجتماعي، وطالما أن الدولة لا تعدو أن تكون آلية لتخصيص الموارد وإعادة توزيعها. إلا أن التوظيف «السياسوي» (Politicization) للمسألة الاجتماعية قد يكرس حالة من مقايضة الحقوق السياسية بالرعاية الاجتماعية، وهو المنطق المهيمن في الدول الريعية التي تنظر إلى الخدمات الاجتماعية كآليات لإعادة إنتاج الولاء، وتعزيز الرابط الاجتماعي بين المجتمعات والأنظمة السياسية، بحيث تغدو الطاعة المطلقة مُعادلًا للاستفادة الدائمة من الإعانات ولو كانت غير مُستحقَّة.
من خلال تتبع المعايير الدولية ذات الصلة، يتضح وجود تباين كبير في نمذجة (Modelling) شبكات الأمان تبعًا لاختلاف السياقات التاريخية والاقتصادية المتحكمة في تصميمها. وبشكل عام يمكننا التمييز بين ثلاثة نماذج كبرى: نهج قائم على العقد الاجتماعي يستهدف تصحيح التفاوت في توزيع الدخل وحماية القدرة الشرائية لدافعي الضرائب، بحيث تعمل الدولة على إعادة توزيع الموارد الضريبية لتصحيح الاختلالات التي تمس بنيان النسيج الاجتماعي (Social Fabric). ونهج يرتكز على التنمية البشرية يهدف لجعل دور شبكات الأمان يتجاوز مجرد تخفيف حدة الفقر إلى كسر حلقته ومنع توارثه، عن طريق زيادة التمويلات المخصصة للقطاعات الاجتماعية وخاصة العمل والصحة والتعليم والتدريب.[7] وأخيرًا نهج قائم على الحقوق، يستهدف توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل جميع السكان مواطنين كانوا أم مهاجرين، بغض النظر عن قدرتهم على المساهمة، أو عملهم بالقطاعات الرسمية أو بالاقتصاد غير الرسمي؛[8] وذلك ارتكازًا على معايير مُحصَّنة بموجب الدستور والتشريعات الدولية والمحلية، كالمساواة والاستدامة وعدم التمييز والتمكين.
فيما يتعلق بأدبيات السياسات الاجتماعية بالخليج العربي وبالمنطقة العربية بشكل عام، يتضح أن معظمها يستند على مقترب الريع كإطار تحليلي لإبراز آليات توظيف الأنظمة السياسية للخدمات والمزايا الاجتماعية في سعيها لتجديد شرعيتها، إذ يعتقد لوسياني جياكومو أن نهج الدولة الريعية بالدول النفطية العربية يعتمد بالأساس على توجيه مكاسب التنمية الاجتماعية والاقتصادية لخدمة رهانات التنمية السياسية، على اعتبار أن دعم الدولة لمختلف للفئات الاجتماعية وإعفاءها من المساهمة في التمويل الجبائي لشبكات الأمان الاجتماعي يخدم بالضرورة رهانات عدم التسييس وتثبيت الولاء.[9] فيما يرى مروان قبلان أنه على النقيض من نظريات الدولة الريعية، لم تفض الموارد النفطية بالمنطقة الخليجية لتأسيس دول ريعية مستقلة عن مجتمعاتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وإنما نجم عنها اعتماد متزايد للأنظمة السياسية القائمة على توزيع الريع بين المواطنين، على نحو مكَّن الدولة الحديثة من إعادة تشكيل البنية الاجتماعية وخلق تحالفات جديدة ملتفة حولها.[10]
الدراسات السابقة
يعاني البحث في هذا المجال من ندرة ملحوظة، فالأبحاث التي تناولت سياقات تَشكُّل شبكات الأمان بدول الخليج العربي ومحاولات نمذجتها وإبراز رهاناتها ومآلاتها، قليلة للغاية. عدا بعض الأعمال التي اقتصرت على دولة بعينها دون استقصاء خصوصية كل تجربة وتقاطعاتها مع السياقات الدولية والإقليمية. وعلى هذا الصعيد فقد اختلفت المنطلقات والمقاربات.
من زاوية تاريخية، اهتم بعض الدارسين بتتبع الارتدادات الاجتماعية للتحولات السياسية، ويرجع جودي سانجر عدم جاهزية المنظومة الحديثة للبرامج الاجتماعية إلى تأخر حصول دول الخليج على الاستقلال وضعف الموارد المالية؛ إذ لم تنطلق اللبنات الأولى لتشييد شبكات الأمان الاجتماعي الخليجية بشكل فعلي إلا مع الشروع في استغلال النفط، الذي اعتبر بمثابة صمام أمان للتخفيف من مخاطر الاستقرار السياسي والاجتماعي في سياق التحول من النظام القبلي إلى النسق السياسي الحداثي.[11] وفي هذا الصدد، ترصد نهى أبو الدهب تأثيرات ريع النفط على فلسفة الحماية الاجتماعية، إذ لم تسمح التباسات تأسيس الدولة القومية بصياغة «عقد اجتماعي صريح» في الوقت نفسه لا يعني هذا عدم وجود «عقود اجتماعية سلطوية» بين مواطني الخليج ودولهم ترتكز على منح دخول ريعية للمواطنين مقابل القبول بهامش ضيق من الحريات المدنية والسياسية.[12] كما اعتبر البعض أن التخصيص الاجتماعي لجزء من الريوع النفطية بدول الخليج العربي يندرج ضمن مساعي بناء «عقد اجتماعي أحادي الجانب» حاولت من خلاله الدول الخليجية تكريس سردية التقاسم العادل لعائدات الثروة النفطية. بينما يرى فريد غازمي أن «لعنة» الموارد النفطية قد أنتجت عقودًا اجتماعية ريعية، أعطت الأولوية لتوفير الفوائد الاجتماعية على حساب مشاركة المواطنين في القرارات السياسية والاقتصادية الحاسمة.[13]
من منظور سياسي، وحسب دراسة مشتركة لكل من بلال شحيطة وجومانا كيال، فإن ضعف نطاق البرامج الاجتماعية وتراخي كفاءة شبكات الأمان الاجتماعي بالمنطقة يعود إلى احتكار الدولة للفعل الاجتماعي مع إغلاق مختلف منافذ المشاركة المجتمعية في تدبير هذا الشأن «السيادي» من منظور الأنظمة السياسية، إذ شكلت عائدات المحروقات مصدرًا لتمويل ريعي للبرامج الاجتماعية خارج المنطق الضريبي، إلا أن حالة عدم اليقين التي تطبع الموارد النفطية أصبحت تفرض خيارات صعبة في تدبير الاقتصاد السياسي للحماية الاجتماعية، بالتخلي عن النمط السائد لدولة الرعاية مع إلزام المواطن بالمساهمة في التمويل التضامني للمسألة الاجتماعية، وهو الأمر الذي قد يعزز من مشاركته في صياغة البرامج الاجتماعية ومساءلة القائمين عليها.[14] انطلاقًا من هذه الخلفية، يؤكد لوي ماركوس وتينا زينتل على الحاجة الماسة لإعادة التفاوض بشأن عقود اجتماعية جديدة تكفل فهمًا أعمق للحاجيات الاجتماعية الأساسية للمواطنين، بما يضمن الارتقاء بفعالية برامج الحماية والمساعدة، وعدالتها وفعاليتها التوزيعية.[15]
من وجهة نظر ديموغرافية، يعتبر بعض الباحثين أن هيمنة العمالة غير المواطنة شكّل رافعة لتدعيم استقلالية السلطة السياسية عن المجتمع، إذ يمثل العمال الأجانب نسبة مهمة من مجموع الكتلة العاملة، مع ما يرافق ذلك من هشاشة الإطار القانوني للحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، على نحو يجعل الدولة في حِلٍّ من تنفيذ كافة استحقاقات الحماية لأشخاص لا يمتلكون القوة التفاوضية اللازمة لتحصين حقوقهم الاجتماعية، الأمر الذي أورث فجوات بارزة بشبكات الأمان الاجتماعي الخليجية بين السكان المواطنين والمهاجرين.[16] وقد شكلت جائحة كورونا محكًا لاختبار عدالة شبكات الأمان الاجتماعي الخليجية، إذ اعتبرت العديد من الأبحاث أن التدابير التقشفية بمجلس التعاون الخليجي المُوجَّهة بحق العمالة الوافدة لم تراع فلسفة العدالة الاجتماعية، ورسخت بدلًا من ذلك التفاوت في سياسات الاستجابة للأزمات الاجتماعية بين المواطنين والمقيمين.[17] في ضوء ذلك نبهت الباحثة اللبنانية ليا بو خاطر رفقة باحثين آخرين إلى ضرورة سد الفجوات الكبيرة في الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين بإزالة القيود التشريعية والعملية التي تكتنف الوصول إلى أنظمة الضمان الاجتماعي، مع الاستناد في ذلك في ضوء المعايير الدولية وخاصة التضامن والتغطية والشمول والمساواة . في هذا السياق يوصي أنيس بن بريك، الأستاذ بكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، من خلال تتبعه لاستجابات الحماية الاجتماعية بدول الخليج العربي بضرورة تبني إصلاحات هيكلية وتشريعية طويلة الأمد لتصميم شبكات أمان اجتماعي شاملة تستوعب جميع السكان مواطنين كانوا أم مقيمين.[19]
كما انبرت أبحاث أخرى للمقارنة بين استجابات الدول الخليجية للتأثيرات الاجتماعية لجائحة كوفيد-19، ودعت لاستلهام الدروس من التحديات التي كشفت عنها هذه الأزمة الوبائية؛ بهدف الارتقاء بعدالة شبكات الأمان الاجتماعي الخليجية، من خلال مضاعفة الاهتمام بتعزيز وصول الفئات السكانية الضعيفة والمهمشة إلى الخدمات الاجتماعية كالعمال المهاجرين،[20] مع التوظيف الأمثل لمكاسب التحول الرقمي في تعزيز حوكمة البرامج الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء قواعد بيانات اجتماعية موحدة تكون منطَلقًا للحصر الموضوعي والمنصف لمستحقي الرعاية الاجتماعية، وباستثمار أفضل للابتكار التكنولوجي في إدارة منظومة الحماية الاجتماعية، وبتدعيم مرونة أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية، لا سيما في مجالات الحوكمة والتمويل والموارد البشرية.[21]
من خلال استعراض أبرز نتائج الدراسات السابقة بشأن الموضوع، يتضح بشكل جلي أنها تتسم بنوع من الانتقائية؛ إذ تركز على فترات زمنية محددة لها سياقاتها الخاصة دون تتبع منطق تطورها ورهاناته، أو تنطلق من حالات معينة كاستفادة الأطفال من برامج الرعاية الاجتماعية، أو دراسة تأثير برامج تشغيل الشباب على الحماية الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة بدون ربط هذه التدخلات الجزئية بالرهانات السياسية والاقتصادية المنشودة في معالجة القصور الذي تشهده الشبكات الخليجية للأمان الاجتماعي. على هذا الأساس، ستحاول هذه الدراسة تغطية جانب من هذه الفجوة من خلال تتبع البرامج الخليجية للرعاية في ضوء التحولات السياسية والاقتصادية، مع فحص حدود الأثر الضاغط لمتطلبات الاقتصاد السياسي على تماسك شبكات الحماية الاجتماعية وكفاءتها في الاستجابة للتحديات المستجدة.
سياقات تطور شبكات الأمان الاجتماعي بدول الخليج العربي
مرت محاولات بناء شبكات الأمان بمنطقة الخليج، انطلاقًا من تجارب الدول الثلاث، بمراحل متعددة. وبشكل منهجي يمكن تقسيم التحقيب التاريخي لهذه المساعي إلى أربعة مسارات فاصلة لكل منها سياقاتها ورهاناتها الخاصة، تبعًا لطبيعة ومدى تأثير المتغيرات المحلية والدولية، ولمستوى تمثل النظام السياسي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عنها.
دولنة التضامنات الاجتماعية
حرصت الدول الخليجية على فرض نفسها كفاعل محتكر للفعل الاجتماعي طيلة الفترة الممتدة من الخمسينيات إلى أواخر الستينيات، بإقرار مجانية وصول جميع السكان إلى الخدمات الاجتماعية عبر مشاريع الإسكان الاجتماعي وأنظمة الرعاية الطبية والتعليم الأساسي، إلى جانب شبكة واسعة من برامج الدعم الاجتماعي المخصصة للفقراء وذوي الدخل المنخفض. وقد ساهمت الوفرة المالية المتولدة عن الطفرة النفطية طيلة عقد السبعينيات في تعزيز الإنفاق السخي على الخدمات الصحية والاجتماعية ومضاعفة المساعدات العينية والنقدية المخصصة للفقراء وللعاطلين.[22] في ضوء ذلك، عملت دول الخليج على توسيع نطاق الفعل الاجتماعي «الدولتي» لقطع دابر أي توترات اجتماعية محتملة في ظل مناخ دولي مطبوع بالاستقطاب والاصطفاف الأيديولوجي، مع المأسسة المتزايدة لشبكات الأمان. ففي الكويت استحدثت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م، وبالبحرين تم إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. فيما عملت السعودية على تطوير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية –التي تم استحداثها منذ 1969– كهيئة حكومية متخصصة في تدبير منظومة الضمان الاجتماعي، بما في ذلك تقديم معاشات شهرية منتظمة للفئات الهشة، كالعاجزين وكبار السن والأيتام والأرامل ومعدومي الدخل، مع إعفاء هؤلاء من دفع أية مساهمة.[23]
تجذير الريع الاجتماعي
أتاح ارتفاع أسعار النفط في بداية الثمانينيات الاستمرار في توسيع نطاق المشمولين برعاية الدولة، بما يساعد على النأي بهم عن أية مسالك احتجاجية للمطالبة بالحقوق أو تأييد توجهات مخالفة للخط الرسمي للسياسات العامة، إلا أن انخفاض أسعار النفط بعد هذه الفترة شكَّل تحديًا حقيقيا لبلدان الخليج لتأمين الجوانب التوزيعية لدولة الرفاه.[24] وقد حفزت عدة أزمات إقليمية على تعميق الهاجس الريعي في التوزيع السلطوي للمنافع الاجتماعية، إذ بادرت الدول الخليجية –في سياق محاولة الحد من التوترات الاجتماعية التي أعقبت حرب الخليج الأولى– إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة حالة الغضب الاجتماعي المتزايد، كتعميم نظام البطاقات التموينية بالبحرين وضخ المزيد من التمويلات الاجتماعية بالسعودية رغم الاختلالات الهيكلية التي مست بالاقتصاد السياسي لتوزيع الموارد.[25] فيما راهنت الكويت على تقوية شرعية النظام السياسي من خلال إرساء نموذج متقدم لدولة الرفاه الاجتماعي بمنطقة الخليج مستفيدةً في ذلك من فوائض ارتفاع أسعار البترول والدعم الدولي والإقليمي لعمليات إعادة الإعمار.[26] لكن بمجرد تجاوز تداعيات حرب الخليج الأولى وما طبع ذلك من تراخ واضح في إيقاع تمويل وتنفيذ البرامج الاجتماعية حتى حلت حرب الخليج الثانية، التي وضعت الشرعية السياسية على المحك في خضم مناخ إقليمي دولي مضطرب، الأمر الذي حتم ضخ المزيد من التمويلات الاجتماعية لشمل الجميع بمنظومة الريع الذي أصبح يُنظر إليه كصمام أمان للاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال تغذية آليات إعادة التوزيع التي تضمن ترابط الدولة بالمجتمع بالممالك العربية النفطية.[27]
التكييف النيوليبرالي لشبكات الأمان
شكَّل عام 2008 نقطة مفصلية في مسار تحول الدور الاجتماعي للدولة عبر العالم؛ إذ ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على الوضع الاجتماعي بمنطقة الخليج العربي في ظل تراجع الإيرادات النفطية مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم معدل البطالة،[28] وهو ما منح الفرصة للمؤسسات المالية الدولية للضغط من أجل تقليص الإنفاق الاجتماعي. ففي السعودية، تزايدت الضغوط على التخلي عن الدعم الحكومي لأسعار منتجات الطاقة و السلع الغذائية وفق تصور نيوليبرالي للرعاية الاجتماعية تنقل فيها الخدمة من الدولة الى الخواص.[29]
إلا أن هذه الديناميكية سرعان ما كبحتها تأثيرات الربيع العربي وما أثارته من توجسات حول تشكل بنيات موازية للرفاه الاجتماعي،[30] إذ ازداد سخاء الدول الخليجية في سعيها للتضحية بالتوازن الاقتصادي لشراء الاستقرار السياسي. ففي السعودية عرض الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز على المواطنين هدايا وتحويلات نقدية تناهز 37 مليار دولار،[31] فيما اعتمدت الكويت على الاستهداف الأسري المباشر في سعيها لإطفاء شرارة الاحتجاجات بمنح دعم نقدي يقدر بـ 3500 دولار لكل أسرة. والأمر نفسه بالبحرين التي تصاعد منسوب الاحتجاجات بها إلى درجة غير مسبوقة كادت تهدد تلاحم الاستقرار السياسي، الأمر الذي حذا بملك البلاد إلى منح 2650 دولار لكل عائلة بحرينية،[32] مع الاستمرار في دفع مخصصات نظام المساعدات الاجتماعية بفضل استفادتها من دعم مالي سخي يناهز 10 ملايين دولار في إطار خطة مارشال لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC Marshall Plan).[33] عقب تجاوز تداعيات هذه المرحلة تفاقمت مؤشرات العجز المالي بصورة أكبر في خضم أزمات اقتصادية خانقة، في ظل تراجع ضخم في إيرادات النفط، مما وضع استدامة التمويل العمومي للبرامج الاجتماعية على المحك،[34] الأمر الذي أوجد بيئة خصبة للتأثير الخارجي في هندسة الشبكات الخليجية للأمان الاجتماعي. ففي مقابل تراجع مداخيل الموارد الاستخراجية، تنامت ضغوط المؤسسات المالية الدولية لتكريس المنطق النيوليبرالي في تصميم السياسات الاجتماعية.[35] ونشير على سبيل المثال إلى تقرير البنك الدولي في أبريل من العام2015 الذي أوصى فيه دول مجلس التعاون الخليجي بتقليص الإنفاق الاجتماعي وتعزيز التعاون الدولي في تدبير منظومة الرعاية الاجتماعية.[36]
عقلنة منظومة الاستهداف
مع نهاية العقد الثاني للألفية الثالثة، تسارعت مساعي إعادة تصميم شبكات الأمان الخليجية. ففي الكويت، اقترح المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في سنة 2019 خريطة طريق لتسريع الانتقال من دولة الرعاية إلى دولة العقد الاجتماعي، كما نصت رؤية الكويت 2035 (New Kuwait) على استبدال الإعانات النقدية غير المنتجة بنمط جديد من الدعم الاجتماعي يركز على ضعاف الدخل ويربط الإعانات المقدمة بالعمل أو البحث عن فرص عمل، مع استبعاد الفئات الأعلى دخلًا التي طالما استفادت بدون وجه حق من نظام الحماية الاجتماعية السخي.[37] وفي البحرين، ترتَّب على برنامج التوازن المالي لسنة 2018 إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تضمنت عدة مشاريع لعقلنة تدبير شبكات الأمان الاجتماعي، كتعميم التأمين الصحي، وإصلاح الدعم المخصص للفئات محدودة الدخل.[38] على جانب أخر، كان النموذج السعودي أكثر التزامًا بالتحول نحو الدعم المستهدف تحت تأثير تراجع الموارد الاقتصادية.[39] فانسجامًا مع برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يندرج ضمن رؤية المملكة 2030؛ تم إطلاق «حساب المواطن» في عام 2017 من أجل مساعدة الأسر الهشة على مواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن التحولات الدولية والإصلاحات الاقتصادية،[40] في صورة منصة رقمية لحصر قوائم الأسر المستحقة للدعم المالي المباشر في سياق توسعة نطاق البرنامج ليتحول إلى قاعدة شاملة لتجميع كافة المساعدات الحكومية الموجَّهة للأسر الضعيفة بما فيها خدمات الضمان الاجتماعي ودعم السكن والتعليم. إذ تم التنصيص على توحيد كافة تعبيرات الفعل الاجتماعي العمومي ضمن شبكة مُرقمنة تكون ظهيرًا لعقلنة تدبير البرامج الاجتماعية، ووفق منهجية استهداف تنطلق من المعالجة الإلكترونية للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية في حصر قوائم المؤهلين للاستفادة من دعم الدولة.[41]
النماذج الخليجية لشبكات الأمان الاجتماعي: التقاطعات والتمايزات
تُؤشِّر الحصيلة المرحلية لنمذجة شبكات الأمان الاجتماعي بمنطقة الخليج على وجود عدة تقاطعات في مختلف مستويات التدبير والتمويل، بحكم تشابه السياقات المؤسسة والرهانات المتوخاة. وبشكل عام يمكن القول أن الدول الخليجية قد سعت باستمرار نحو تعزيز التمفصل بين أربعة مستويات.
الملاءمة بين المحلي والكوني
استلهمت التجارب الخليجية الثلاث العديد من الآليات من الرصيد الاجتماعي/الديني لتعزيز الاستدامة المالية لبرامج الرعاية الاجتماعية، كالزكاة والصدقات والأوقاف والهبات. كما مارست القيم التقليدية دورًا مهمًا في تحفيز رأس المال الاجتماعي اللازم لشحذ ديناميكيات التضامن الاجتماعي.[42] بالموازاة، صادقت الدول الخليجية المذكورة على النصوص الدولية المؤسِّسة، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوصية مكتب العمل الدولي رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية. كما فرضت استحقاقات الملاءمة دسترة المعايير الدولية، إذ نص النظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية في مادته الرابعة والعشرين على الحرية والتضامن وتكافؤ الفرص كمبادئ مشتركة للعدالة الاجتماعية، مع التأكيد على دور الدولة في ضمان استفادة المواطنين من نظام الضمان الاجتماعي مع تشجيعها لمساهمة الفاعلين غير الرسميين في تقديم الدعم الاجتماعي. فيما أكدت المادة الخامسة من الدستور البحريني على دور الدولة في تحقيق الضمان الاجتماعي وخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية لكافة المواطنين. في حين نص دستور الكويت في مادته الحادية عشرة على المسئولية الاجتماعية للدولة من خلال توفير خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والمعونة الاجتماعية.
التقاطع بين برامج الحماية والمساعدة
استندت عمليات تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي بالتجارب الخليجية المدروسة على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في التوظيف العام والرعاية الصحية الشاملة والدعم السخي للمواد والخدمات الأساسية.[43] فبالتوازي مع توسيع القاعدة المستفيدة من التأمين ضد المرض والبطالة؛ تنوعت آليات المساعدة الاجتماعية الشاملة بين منح بطاقات تموينية للتقليص من تكلفة السلع الغذائية الأساسية وموازنة أسعار المحروقات ودعم تملك السكن، بالإضافة إلى أنظمة الإعانات الخاصة بفئات معينة كالأرامل والأيتام وأسر السجناء وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. مع السعي التدريجي للدول الثلاث إلى تعميم العمل بمنهجية الاستهداف الاجتماعي، مُعتمِدة في ذلك على بعض الشروط المواتية، كانكشاف الأنشطة الاقتصادية ومحدودية القطاعات غير المهيكَلة، وامتلاكها لبنية تحتية معلوماتية متطورة تساعدها على الفرز الإلكتروني للأشخاص المؤهلين للاستفادة من البرامج الاجتماعية.[44]
المراوحة بين دور الدولة والتشكيلات غير الرسمية
بحكم السياق الأبوي لتشكل التطبيقات الخليجية لدولة الرعاية، فقد حافظت الدولة على مركز الثقل في قيادة شبكات الأمان؛ وذلك بتوظيف التصور التقليدي للرعاية الاجتماعية لبناء تحالفات بين النظام السياسي والمؤسسات الفاعلة عبر سياسة توزيعية تستند إلى مبادلة الولاءات بالمنافع.[45] ففي السعودية يُمسك الديوان الملكي بتلابيب شبكة الأمان الاجتماعي في محاولة لتوجيه عمليات الرعاية الاجتماعية للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي،[46] وهو النهج الذي أصبح أكثر رسوخًا في ظل التطبيقات الاجتماعية لرؤية 2030 التي تنحو في اتجاه إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمواطن وفق معادلة توفير المزايا والخدمات مقابل التخلي عن الحقوق السياسية.[47] ورغم التقدم النسبي للممارسة الديمقراطية بالبحرين والكويت، فإن «السلطة الأميرية» لا تزال تحظى بدور شبه حصري في قيادة البرامج الاجتماعية؛ بالنسبة للبحرين، ساهم تراجع المسار الديمقراطي بعد 2011 في تعميق الفجوة بين الأقلية السنية الحاكمة والأغلبية الشيعية المحرومة،[48] وفي الكويت، يعتبر الباحث لؤي علي –في مقاربته لمفهوم الدولة الريعية– أن التخصيص السلطوي لموارد النفط يفيد أمير البلاد في توظيف امتيازات الرعاية الاجتماعية لاحتواء المجموعات الاجتماعية المختلفة، مع دور محدود لمجلس الأمة بسبب أصوله الاجتماعية، التي تسعى من خلاله إلى تحصيل منافع ريعية تفضيلية أكثر من الوفاء لاستحقاقات العدالة الاجتماعية.[49] فضلًا عن ذلك، فإن الحل المتكرر للمجلس يؤثر سلبًا على استقرار وظيفته التشريعية وعلى مستوى رقابته على أوجه الإنفاق الاجتماعي.
في المقابل، تنفتح معظم التطبيقات الخليجية بشكل محسوب على مساهمة المنظمات المدنية والجمعيات الخيرية بحكم التوجس من منافسة دولة الرعاية في تقديم الخدمات للمواطنين،[50] مع حصر دورها في مواكبة تنفيذ التدخلات الحكومية. كما هو حال الكويت التي أطرت دور الجمعيات التعاونية والخيرية ضمن إطار وظيفي محدود، كمساعدة القطاعات الوزارية في برامج دعم السكن أو النيابة عنها في تقديم بعض الخدمات الاجتماعية لصالح المهاجرين.[51] الوضع نفسه بالبحرين، عبر استثمار شبكات الحماية الاجتماعية شبه الرسمية لتعويض معضلة التوازن المالي للبرامج الاجتماعية، بالشراكة مع الجمعيات الخيرية الموالية للحكومة التي يتجاوز عددها 600 جمعية. وفي السعودية تسهم جمعيات شبه حكومية في تغطية تكاليف المرضى الذين لا يمتلكون تأمين صحي رسمي، أو مسجلين بتأمين لا يغطي الأمراض المزمنة. فيما تتكفل جمعيات ومؤسسات خيرية أخرى بتقديم المساعدات الاجتماعية لمعدومي الدخل تحت مراقبة الدولة وبتشجيع منها، سواء بتقديم إعانات نقدية وعينية، أو بإتاحة سلة متنوعة من الخدمات الاجتماعية.[52]
التأرجح بين رهانات الرعاية ونزوعات التأهيل
حاولت دول الخليج إضفاء مُسحة حداثية على إرادة توجيه البرامج الاجتماعية لترسيخ الشرعية السياسية للأنظمة القائمة، ولتعضيد التماسك الاجتماعي وحمايته من مخاطر الانقسام والتفكك.[53] على هذا الأساس، يعتبر البعض أن الاستمرار في دعم الأسعار وفي تنويع المساعدات العينية والمالية يندرج ضمن الاشتراطات السلطوية لعقود اجتماعية «غير اجتماعية» (unsocial SC) تقوم على توسيع تيسير الاستفادة الامتيازية من الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والسكن وغيرها مقابل التخلي عن الحريات السياسية والمدنية، بحيث تراهن الدولة من خلال آليات تخصيص الريع على «تثبيط» العوامل المثيرة للسخط والانتفاض بما يساعدها على استدامة هيمنتها على القاعدة الاجتماعية للنظام السياسي.[54] ووعيًا بمحدودية العائد السياسي لهذا التوجه، فقد تسارعت جهود تمكين الفئات الهشة وإعادة تأهيلها اقتصاديًا واجتماعيًا بدلًا من استمرارها في الاعتمادية المطلقة على الدولة، على غرار برنامج التأهيل المهني لذوي الإعاقة بالكويت، والمشروع الوطني لتطوير ودعم الأسر المحتاجة بالبحرين، ومشروع تمكين الأيتام ذوي الظروف الخاصة بالسعودية.
قياس أثر الأنظمة الخليجية للحماية والمساعدة: الفرص والمخاطر
فيما أسفرت التطبيقات الخليجية لإعادة هيكلة شبكات الأمان الاجتماعي عن حزمة متنوعة من التدخلات تتباين من حيث منهجية الاستهداف ونطاق تمويلها وتدبيرها؛ إلا أنها جميعًا تندرج ضمن منظور جديد للاقتصاد السياسي للمسألة الاجتماعية، يهدف إلى وضعها ضمن مساعي تثبيت السلم الأهلي بأقل كلفة ممكنة، مع ربط برامج الحماية والمساعدة الاجتماعية، بشكل متزايد، ببرامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
في هذا السياق، تبرز الهندسة المالية لشبكات الأمان الاجتماعي في دول الخليج تخصيص مبالغ كبيرة لتمويل منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتتصدر السعودية هذه الدول، فرغم التراجع النسبي للميزانية المخصصة للإنفاق الاجتماعي نتيجة تأثير برامج الإصلاح الاقتصادي؛[55] لا تزال تمتلك أكبر شبكة أمان اجتماعي بالمنطقة الخليجية، بميزانية سنوية تقارب 181 مليار ريال. موزعة بين 41.5 مليار ريال لحساب المواطن و35.8 مليار ريال للضمان الاجتماعي و23.5 مليار ريال لنفقات أدوية ومستلزمات طبية، فيما يتوزع الباقي على دعم أسعار المواد والخدمات الأساسية، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساعدة على امتلاك السكن بتخصيص ضمانات للتمويل العقاري وحوافز للقطاع الخاص لتطوير منتجات سكنية مخصصة للفئات محدودة الدخل.[56] إلى جانب المملكة العربية السعودية، تعتبر الكويت من أبرز الدول العربية من حيث قوة وفاعلية شبكات الأمان الاجتماعي، إذ يقارب الإنفاق الاجتماعي 44% من الميزانية العامة.[57] وفي البحرين، بلغت الميزانية السنوية المخصصة للإنفاق الاجتماعي 454 مليون دينار، بما يمثل %13.6 من إجمالي المصروفات الحكومية.[58]
ورغم تراجع الموارد النفطية؛ فإن الإنفاق الاجتماعي بالدول الخليجية الثلاث لا يزال مرتفعًا، ففي الكويت لا تزال نسبة الإنفاق الاجتماعي تتجاوز 28.3% من الناتج المحلي الإجمالي.[59] أما السعودية، وبالرغم من الطابع الظرفي والانتقالي لبرنامج «حساب المواطن»، والذي يستحوذ على الحصة الأكبر من الميزانية الاجتماعية؛ فإنها لم تتوقف عن تمديد البرنامج، وزيادة مخصصاته المالية لمواكبة ارتفاع الأسعار وما تسببه من إضرار بالقدرة الشرائية للأشخاص المستهدفين. الزيادة نفسها شملت بقية مكونات الأمان الاجتماعي لمحاولة تدارك الفجوات الاجتماعية.[60] واستحضارًا لهاجس التضخم في هندسة التحويلات المستهدفة، عمدت البحرين في 2022 إلى زيادة قيمة الدعم المخصص لذوي الدخل المحدود في إطار برنامج الضمان الاجتماعي بنسبة 10% مع مضاعفة مخصصات ذوي الإعاقة في ميزانية 2023 – 2024.
هذه التمويلات مكنت من توسعة نطاق القاعدة الديموغرافية لشبكات الأمان الاجتماعي. ففي السعودية انتقل عدد المستفيدين من حساب المواطن من 10.6 مليون في 2018 إلى 12 مليون شخص مستفيد بنهاية العام 2024، وهو ما يعني أن إعانات البرنامج أصبحت تشمل قرابة نصف السعوديين بغطاء مالي بلغ 230 مليار ريال منذ انطلاقة البرنامج. أما فيما يتعلق بالتجربة الكويتية، فقد شهدت تطورًا متزايدًا في أعداد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية لتتجاوز 00043 ألف شخص ينتمون إلى 12 فئة بميزانية شهرية تقارب 70 مليون دولار.[61] وبمراعاة مختلف مظلات التأمين الرسمية وغير الرسمية، يمكن القول أن الكويت قد نجحت في شمول الجميع بخدمات التغطية الصحية الأساسية. وفي البحرين، مكَّنت الحزم المتنوعة لبرامج الدعم الاجتماعي من التكفل بعشرات الآلاف من الأسر محدودة الدخل. إذ تتجاوز أعداد المستفيدين من علاوات الغلاء –وهي علاوات تُدفَع للأسر التي يتراوح دخلها الشهري بين 300 وألف دينار– 130 ألف أسرة بما يُمثِّل قرابة نصف مليون شخص.[62] في السياق نفسه، يشمل الدعم النقدي المخصص لتحرير أسعار اللحوم ما يزيد عن 185 ألف أسرة، كما ارتفع عدد الأشخاص المنتفعين من مخصصات الإعاقة إلى أكثر من 14 ألف شخص في نهاية 2024.[63] ورغم أن البحرين قد شملت جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، بفضل تدخلات الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية؛ فإن نسبة التأمين الصحي الاجتماعي في صفوف المقيمين لا تزال تراوح 41.8%.[64]
على مستوى الأثر الاجتماعي المستدام، بما أن شبكات الأمان بالدول الخليجية مُصمَّمة في الأصل بشكل ريعي وغير مبنية على أساس القضاء على الفقر، فإن إسهامها لا يزال ضعيفًا على هذا المستوى. ففي البحرين لا يزال %7.5 من السكان يقبعون تحت خط الفقر. أما الكويت، فرغم تسجيلها لمعدلات متدنية، فإن نسبة الفقر لم تتغير طيلة هذه المدة. وفي السعودية، ورغم تراجع معدل الفقر خلال الفترة بين عامي 2010 و2021 من 18.2% إلى 13.5%؛ إلا أن الفقر لا يزال يطال واحدًا من بين كل سبعة مواطنين حسب معطيات بيانات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).[65] هذا المآل يفرض تحديات بشأن إعادة تصميم شبكات الأمان الاجتماعي، بهدف جعلها وسيلة لكسر حلقة توارث الفقر وتضييق فجوات توزيع الدخل.
تحديات شبكات الأمان الاجتماعي الخليجية والاستجابات المطلوبة
رغم المكاسب الآنية؛ لم تمكن الإصلاحات المتعاقبة التي نفذتها الدول الخليجية الثلاث من إرساء شبكات أمان وحماية متماسكة ومستعدة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تؤثر سلبًا وبشكل متسارع على الوضع الاجتماعي. الأمر الذي يفرض ضرورة إجراء مراجعة جذرية للأطر المعتمدة في تصميم وتمويل البرامج الاجتماعية في ضوء الدروس المستفادة من التجارب الرائدة بدول الجنوب العالمي على غرار الهند والبرازيل.
التحدي الأبرز في هذا الشأن يتمثل في إعادة تفعيل البعد التعاقدي للمسألة الاجتماعية أمام التآكل التدريجي للعوائد السياسية للعقود الاجتماعية الرعائية.[66] وفي هذا الصدد، تكمن الأهمية في ضرورة صياغة عقود اجتماعية أكثر تشاركية تُشكل أطرًا مرجعية لوضع تدخلات اجتماعية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة. وذلك من خلال الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية، كالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ووثائق منظمة العمل الدولية ذات الصلة، كالاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 157 الخاصة بإقامة نظام دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي، والتوصية رقم 205 بشأن العمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود. كما يتطلب الأمر مراعاة معايير الإنصاف والمساواة في تصميم وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي. وكذا استحضار المبادئ التوجيهية للمرجعيات الدولية للحماية الاجتماعية؛ كالشمول بدلًا من الانتقاء، والتمكين عوض الرعاية، والتركيز على استئصال التفاوتات بدلًا من معالجة أعراض الفقر. وأخيرًا يجب أن تكون التشريعات الوطنية أكثر تمثيلًا للجوهر الحقيقي للحماية الاجتماعية، بدلًا من خضوعها للنزعات الخيرية في تصميم البرامج الاجتماعية.
إلا أن التمثيل الفعلي للإطار المعياري الدولي يفرض بالضرورة اعتماد منظور قائم على الحقوق، ينظر إلى خدمات الحماية الاجتماعية كحقوق أساسية للمواطنين، وليست إحسانًا أو مساومة. الأمر الذي يطرح راهنية توسيع قاعدة شبكات الأمان الاجتماعي: على المستوى الأفقي بتوسيع أنظمة التأمينات الاجتماعية لتشمل العمالة المهاجرة، والعاملين في القطاعات غير الرسمية، ومختلف الفئات المستبعَدة في إطار استراتيجيات وطنية مستدامة تراعي حقوق الإنسان ومعايير منظمة العمل الدولية.[67] فيما يتعين على المستوى العمودي تحقيق أعلى مستويات الجودة والفعالية في أنظمة الضمان الاجتماعي، بما يضمن استفادة فعلية وليس مجرد استفادة إحصائية، مع الحذر من تحويل منهجية الاستهداف إلى مطية لحصر سياسات الحماية الاجتماعية في سقف محدود يقتصر على الفئات الأشد فقرًا. ونشير في هذا الصدد إلى أن الامتثال للإيديولوجية النيوليبرالية (neoliberal ideology) من شأنه تفكيك شبكات الأمان الاجتماعي تحت ستار إصلاح الاقتصاد، كما حدث في بلدان كانت تعتبر نفسها نماذج متقدمة للدولة الاجتماعية مثل بريطانيا.[68] وفي مقابل الهاجس التقشفي الضاغط، يتعين استحضار المنظور الحقوقي من أجل تعميم استفادة جميع الفئات المتضررة من المنافع الاجتماعية مع الزيادة المستمرة في قيمة المساعدات الممنوحة للمستفيدين، ومقدار الإنفاق على المرافق الاجتماعية.
من الناحية المالية، صحيح أن عدم الاعتماد على المصادر الضريبية في تمويل منظومة الأمان الاجتماعية أفاد إلى حد بعيد الأنظمة الخليجية في ظرفيات سابقة؛ لأنه كرس الاعتماد على الدولة كمصدر وحيد للرفاه الاجتماعي وحد من المساءلة الشعبية للسياسات العامة. إلا أن أثر ذلك قد تجاوز النطاق السياسي ليشمل المستوى الثقافي بتكريس حالة من الذهنية الريعية (Rentier Mentality) بين صفوف المواطنين وفق هندسة اجتماعية تربط توزيع المزايا والامتيازات الاجتماعية بتقديم فروض الطاعة.[69] وعلى حد تعبير حازم الببلاوي، حرصت الأنظمة الخليجية على ربط الولاء السياسي للمواطنين بالمنافع المالية والاجتماعية وليس بالمشاركة الفعلية والنشاط المنتج، ما جعلهم يألفون الاستفادة من الريع الاجتماعي.[70] كما أورث هذا النهج ضمورًا متزايدًا في القيم المحفزة على العمل مقابل تعزيز التواكل والتبعية المالية للدولة؛ إذ تجعل المساعدات الاجتماعية غالبية المستفيدين تستنكف عن العمل، فيما تدفع البعض الآخر إلى عدم الانخراط في أية برامج للاندماج الاقتصادي.[71]
على المستوى المؤسساتي يفرض تعدد التدخلات وضعف التنسيق بين المتدخلين الارتقاء بحكامة تدبير البرامج الاجتماعية، باستحداث هيئة مشتركة للقيادة والتنسيق تضم ممثلي كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية،[72] مع إشراك ممثلين عن أصحاب المصلحة في تشخيص الحاجيات وتقييم النتائج بما يجعلها أكثر استجابة لواقع المستهدفين. للهدف نفسه، تبرز الحاجة الماسة إلى إجراء إعادة هيكلة شاملة لنظام الحماية الاجتماعية ليصبح أكثر عدالة وكفاءة، بما يضمن توسيع دائرة الأسر الفقيرة المستهدفة بالدعم الاجتماعي على أساس منظومة استهداف فعالة تكفل وصول الإعانات لمستحقيها،[73] وذلك من خلال توحيد الوعاء المعلوماتي للبرامج الاجتماعية ضمن قاعدة معطيات مركزية لتسجيل ومعالجة البيانات الاقتصادية والاجتماعية للمستهدفين؛ توخيًا لشمول المستحقين واستبعاد غير المؤهلين. مع تعزيز التكامل بين منظومتي الحماية والمساعدة الاجتماعيتين، على اعتبار أن خروج بعض الأسر من دائرة الفقر لا يُبرر بأية حال من الأحوال إخراجها من مظلة الحماية الاجتماعية التي يجب أن تشمل الجميع وليس فقط الفئات الأشد فقرًا.[74]
خاتمة
شهدت شبكات الأمان الاجتماعي في كل من السعودية والكويت والبحرين تحولات متسارعة نتيجة تأثير الظرفيات الاقتصادية، التي جعلت الأنظمة السياسية بهذه البلدان مضطرة للموازنة بين هواجس تثبيت السلم الأهلي ورهانات التحكم في التوازنات الماكرواقتصادية للميزانية العامة التي أصبحت مُخترَقة بقُصور هيكلي أمام توالي الأزمات الاقتصادية والمالية. وفي ضوء هذا المأزق، لا تزال الدول الخليجية الثلاث تنظر إلى المسألة الاجتماعية بمنظور سيادي كصمَّام أمان لتثبيت الاستقرار الاجتماعي ولتجديد الشرعية السياسية للأنظمة القائمة، التي ما فتئت تحترس من «الكلفة الاجتماعية» لانتهاك بنود «عقود اجتماعية ريعية» تعمل على إغداق المنافع والامتيازات الاجتماعية مقابل التغاضي عن الحقوق والحريات السياسية، وهو الرهان المركزي الذي يفسر الحذر في الاستبدال التدريجي للأشكال التقليدية للدعم والرعاية بأنماط مستحدَثة تعتمد على الاستهداف بدلًا من الشمول.
إلا أن هذا التحوط لا ينفي وجود تحول منهجي بالاقتصاد السياسي لشبكات الأمان والحماية الاجتماعية في ضوء التحولات الجارية بالدول موضوع الدراسة. فاستفحال عجز الموازنة وتراجع الموارد النفطية كانت له عدة ارتدادات على السياسات الاجتماعية؛ كالتخلي عن بعض استحقاقات دولة الرعاية وإشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تمويل البرامج الاجتماعية، وتوحيد مختلف عمليات المساعدة والحماية ضمن شبكة أمان اجتماعية موحدة على أساس منظومة استهداف رقمية تُمكن من حصر مستحقي الدعم، والحد من الهدر المالي الذي يستنزف مخصصات الإنفاق الاجتماعي دون تحقيق الفارق المطلوب في التوزيع العادل للدخل.
لمواكبة هذا التحول، يتعين الملاءمة أكثر مع الإطار المعياري الدولي بإدماج مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز ضمن التطبيقات الجديدة للضمان الاجتماعي والتحويلات المستهدفة، والرهان على دورها التنموي والإدماجي مما يجعلها آلية لكسر حلقة الفقر والتحرر من أسر المقاربة الريعية التي عززت سلوكيات التواكل والاعتماد على دعم الدولة. كما يتعين الارتقاء بحكامة التدخلات الاجتماعية من خلال إنشاء وكالات متخصصة للقيادة الاستراتيجية لمختلف تعبيرات الفعل العمومي الاجتماعي، مع إنشاء سجلات اجتماعية موحدة تشكل نقطة انطلاق لمعالجة موضوعية ومنصفة للبيانات الاجتماعية، والتمييز بين من يستحق الاستفادة بشكل مجاني من خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، ومن لا يستحقها.
ارتباطًا بذلك، يبرز الرهان على إبرام عقود اجتماعية أكثر تشاركية تأخذ بعين الاعتبار إسهام المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تشخيص الحاجيات وفي تمويل البرامج ومساءلتها، بما يضمن الموازنة بين متطلبات الاقتصاد السياسي في تصميم وتمويل البرامج الاجتماعية وبين استحقاقات العدالة الاجتماعية.
[2] بيير بيستي، اقتصاديات الحماية الاجتماعية [The Economics of Social Protection]، (جامعة كامبريدج، 2023)، 3-4، https://doi.org/10.1017/9781009295475.
[3] أحمد بعلبكي، «تحولات الأخلاق والسياسة في أنظمة الحماية الاجتماعية»، المجلة العربية لعلم الاجتماع – إضافات، 38، العدد 39 (2017): 183. https://doi.org/10.12816/0041793.
[4] ماكليلن لورين إم وميلاني كاميت، سياسات الرعاية الاجتماعية غير الحكومية [The Politics of Non-state Social Welfare] (جامعة كورنيل، 2014)، 155.
[5] لوي ماركوس وتينا زينتل، «هشاشة الدولة، العقود الاجتماعية ودور الحماية الاجتماعية: وجهات نظر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، [State Fragility, Social Contracts and the Role of Social Protection: Perspectives from the Middle East and North Africa Region]. مجلة العلوم الاجتماعية، 10، العدد 12 (2021)، 16، https://doi.org/10.3390/socsci10120447.
[6] علي عبد القادر علي، «حول العدالة الاجتماعية وسياسات الإنفاق العام في دول الثورات العربية»، عمران، 3، العدد 9 (2014): 18. https://doi.org/10.12816/0007301.
[7] أنديل سنتلي، «فاعلية شبكات الأمان الاجتماعي في تقليل الفقر المدقع» [The Effectiveness of Social Safety Nets in Reducing Extreme Poverty]، المجلة الدولية لدراسات الدول النامية، 6، العدد 2 (2024): 47–48، https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2025.103585.
[8] ماغدالينا سبولفيدا و هايدي هوتالا وكارلي نيست، النهج القائم على حقوق الإنسان في الحماية الاجتماعية [The Human Rights Approach to Social Protection] (وزارة الشئون الخارجية الفنلندية، 2012)، 9، تاريخ لاطلاع 11 يوليو 2025، https://tinyurl.com/mrx2y54w.
[9] جاكومو لوتشاني، «تخصيص الموارد مقابل الدولة المنتجة: إطار نظري» [Allocation vs. Production States: A Theoretical Framework)، في: الدولة الريعية (The Rentier State]، (روتليدج، 1987)، 63-82، https://www.doi.org/10.4324/9781315685229-4.
[10] مروان قبلان، التحولات الاجتماعية في دول الخليج العربية: الهوية والقبيلة والتنمية، (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2021)، 23-24.
[11] جودي سانجر، «إصلاح سياسي وتنويع اقتصادي في الخليج: الكويت والإمارات العربية المتحدة» [Political Reform & Economic Diversification in the Gulf: Kuwait and the United Arab Emirates]، منصة أكاديميا، ديسمبر 2014: 4، تاريخ الاطلاع 16 يوليو 2025، https://tinyurl.com/26h9xxq5.
[12] نهى أبو الدهب، الحماية الاجتماعية، وليس فقط الحماية القانونية: العمالة المهاجرة في الخليج [Social Protection, Not Just Legal Protection: Migrant Laborers in the Gulf] (مؤسسة بروكينغز، 2021)، 3، http://tinyurl.com/543btx4f.
[13] فريد غازمي وآخرون، «تحليل تجريبي للعقد الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودور الرقمنة في تحوله» [An Empirical Analysis of the Social Contract in the MENA Region and the Role of Digitalization in Its Transformation]، مدرسة تولوز للاقتصاد، أوراق العمل، رقم 1423 (2023): 2-3، تاريخ الاطلاع 26 مايو 2025، https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2023/wp_tse_1423.pdf.
[14] بلال شحيطة وجومانا كيال، «صنع السياسات العامة في دول الخليج العربي»، في الأمن المجتمعي والجماعي في الوطن العربي. تحرير سرور طالبي (مركز جيل البحث العلمي، 2020)، 28، تاريخ الاطلاع 29 مايو 2025، https://jilrc.com/archives/12827.
[15] ماركوس وزينتل. هشاشة الدولة، 447.
[16] رافائيل أوسوريو وآخرون، «الحماية الاجتماعية بعد الربيع العربي» [Social Protection after the Arab Spring]، المركز الدولي للسياسات من أجل النمو الشامل. موجز السياسات، 14، العدد 3 (2017): 27، تاريخ الاطلاع 15 مايو 2025، https://tinyurl.com/4zrn7xr3.
[17] أحمد عارف، «العدالة الاجتماعية إبان جائحة COVID-19: دراسة مقارنة لسياسات الصحة والاقتصاد في الدول العربية» [Social Justice Under COVID-19: A Comparative Study of Health and Socioeconomic Policy Responses]، في التحول الاجتماعي في منطقة الخليج: وجهات نظر متعددة التخصصات [Social Change in the Gulf Region: Multidisciplinary Perspectives]، تحرير عبد الرحمن ميزانور وعمر العظم (سبرينغر نيتشر، 2023)، 122-123، تاريخ الاطلاع 15 يوليو 2025، https://doi-org/10.1007/978-981-19-7796-1_7.
[18] كرستينا لو، وآخرون، «توسيع الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تحليل للممكنات والعوائق» [Extending Social Protection to Migrant Workers in the Region of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC): An Analysis of Enablers and Barriers]. المجلة الدولية للضمان الاجتماعي، المجلد 76، العدد 4 (2023): 104. https://doi.org/10.1111/issr.12346.
[19] أنيس بن بريك، «استجابات الحماية الاجتماعية في دول الخليج العربي» [Social Protection Responses in the Arab Gulf States]، في: جائحة COVID-19 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: استجابات السياسة العامة [The COVID-19 Pandemic in the Middle Eastand North Africa: Public Policy Responses]، (روتليدج، 2023)، 40-41. https://doi.org/10.4324/9781003266259-2.
[20] طارق نهاري وآخرون، «العمال المهاجرون مع COVID-19: تحدٍ كبير لدول مجلس التعاون الخليجي للحد من انتشار العدوى» [Migrant Workers with COVID-19: A Major Challenge for Gulf Cooperation Council Countries to Curb the Spread of Infection]، تعزيز الصحة العالمية، 31، العدد 3 (2024): 141-146. https://doi.org/10.1177/17579759231216108.
[21] شو تشين وآخرون، «استجابات الحكومة لجائحة COVID-19 في دول مجلس التعاون الخليجي: الممارسات الجيدة والدروس للاستعداد للمستقبل» [Government Responses to the COVID-19 Pandemic of the Gulf Cooperation Council Countries: Good Practices and Lessons for Future Preparedness]، أبحاث في السياسة الصحية العالمية، 19 (2024): 11. تاريخ الاطلاع 27 يوليو 2025، https://tinyurl.com/4jr265j2.
[22] مصطفى حجازي، الشباب الخليجي والمستقبل: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، (2008)، 85.
[23] تيم نيبلوك ومونيكا مالك، الاقتصاد السياسي للمملكة العربية السعودية [The Political Economy of Saudi Arabia]، (روتليدج، 2017)، 232. https://doi.org/10.4324/9780203946190.
[24] كريستيان كوتس أولريكسن، مراكز القوة في دول الخليج العربي [Centers of Power in the Arab Gulf States]، (هيرست، 2023)، 176.
[25] بيانكو سينزيا، الملوك في الخليج بعد الربيع العربي: التهديدات والأمن [The Gulf Monarchies after the Arab Spring: Threats and Security]، (جامعة مانشستر، 2024)، 9.
[26] مريم الكاظمي، «إعادة بناء المعنويات من جديد في الكويت بعد فترة الحرب»، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 13 أبريل 2025، تاريخ الاطلاع 27 مارس 2025، https://tinyurl.com/24twphjy.
[27] كريستيان أولريشسن، الخليج غير الآمن: نهاية اليقين والانتقال إلى عصر ما بعد النفط [Insecure Gulf: The End of Certainty and the Transition to the Post-Oil Era]، (جامعة كولومبيا، 2011)، 5. تاريخ الاطلاع 12 أغسطس 2025، https://www.hurstpublishers.com/book/insecure-gulf/.
[28] آدم هنيّة، سلالات التمرد: قضايا الرأسمالية المعاصرة في الشرق الأوسط [Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East]، (دار هايماركت، 2013)، 7.
[29] محمد بن صنيتان، السعودية.. الدولة والمجتمع: محددات تكون الكيان السعودي، (الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2008)، 100.
[30] ميلاني كاميت وإسحاق ديوان، الاقتصاد السياسي للانتفاضات العربية [The Political Economy of the Arab Uprisings]، (روتليدج، 2014)، 6.
[31] محمد المشد، «منظومة اجتماعية وسياسية جديدة في السعودية؟»، نيويورك: معهد كارنيجي للسلام الدولي. 12 يناير 2017، تاريخ الاطلاع 29 أبريل 2025، https://tinyurl.com/2djwrvod.
[32] زيان هوانغ، الحماية الاجتماعية في ظل الأنظمة السلطوية: سياسات الصحة والسياسة في الصين [Social Protection under Authoritarianism: Health Politics and Policy in China]، (جامعة أكسفورد، 2021)، 200.
[33] جاستن جينغلر، الصراع الجماعي والتعبئة السياسية في البحرين والخليج العربي: إعادة التفكير في الدولة الريعية [Group Conflict and Political Mobilization in Bahrain and the Arab Gulf: Rethinking the Rentier State]، (جامعة إنديانا، 2015)، 16.
[34] آدم هنية، المال والأسواق والملكيات: مجلس التعاون الخليجي والاقتصاد السياسي للشرق الأوسط المعاصر [Money, Markets, and Monarchies: The Gulf Cooperation Council and the Political Economy of the Contemporary Middle East]، (جامعة كامبريدج، 2018)، 258-259.
[35] لين جيك وآخرون، «الرفاهية في أزمة: العمل والحماية الاجتماعية في الجنوب العالمي» [Welfare in Crisis: Labor and Social Protection in the Global South]، مجلة العمل والمجتمع، 27، العدد 2 (2024): 6، تاريخ الاطلاع 03 أبريل 2025، https://tinyurl.com/m9sm7tr7.
[36] البنك الدولي، بناء مجتمعات أكثر صحة وإقامة أنظمة للرعاية الصحية أعلى أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، (واشنطن: مجموعة البنك الدولي، 2015)، 11، تاريخ الاطلاع 41 أبريل 2025، https://shorturl.at/DXsuK.
[37] البنك الدولي، إطار الشراكة الوطنية بين الكويت والبنك الدولي للفترة 2021-2025، (واشنطن: مجموعة البنك الدولي، 2020)، 23، تاريخ الاطلاع 01 أبريل 2025، https://mof.gov.kw/otherPDF/Partnership.pdf.
[38] مملكة البحرين، الاستعراض الوطني الطوعي حول أهداف التنمية المستدامة 2030، (المجلس الأعلى للبيئة، 2023)، 25، تاريخ الاطلاع 41 أبريل 2025، https://shorturl.at/nO9J3.
[39] جين كينينمونت، رؤية 2030 والعقد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية: التقشف والتحول [Vision 2030 and Saudi Arabia’s Social Contract: Austerity and Transformation]، (تشاثام هاوس،2017)، 40، تاريخ الاطلاع 28 مارس 2025، https://shorturl.at/AsVh8.
[40] أمينة سعيد الصياد، «الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية»، في الحماية الاجتماعية في أعقاب الربيع العربي (مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل، 2017)، 64. تاريخ الاطلاع 19 أبريل 2025، https://shorturl.at/a4y4n.
[41] المملكة العربية السعودية، لوائح وأنظمة ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، (لجنة برنامج حساب المواطن، 2016)، 8-9، تاريخ الاطلاع 7 أبريل 2025، https://tinyurl.com/4kdh3mzj.
[42] علي علي الزغل علاء، «تحليل سياسات الحماية الاجتماعية في دولة الكويت خلال الفترة (1960–2019): شبكة الأمان الاجتماعي نموذجًا»، مجلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات والبحوث الاجتماعية، 17، العدد 17 (2019): 640–641. https://doi.org/10.21608/JFSS.2019.135608.
[43] رافائيل أوسوريو وآخرون، «الحماية الاجتماعية بعد الربيع العربي»، 27.
[44] الإسكوا، إصلاح الحماية الاجتماعية في الدول العربية [Social Protection Reform in Arab Countries]، (بيروت: الأمم المتحدة، 2019)، 59. تاريخ الاطلاع 16 يوليو 2025. https://tinyurl.com/4uz6uz5r.
[45] سلمان باقر النجار، الحداثة الممتنعة في الخليج العربي: تحولات المجتمع والدولة، (دار الساقي، 2018)، 45.
[46] هنري كليمان مور وروبرت سبرينغبورغ، العولمة وسياسات التنمية في الشرق الأوسط [Globalization and the Politics of Development in the Middle East]، (جامعة كامبريدج، 2010)، 229.https://doi-org/10.1017/CBO9780511778162 .
[47] أسماء البنا، «اختبار العلاقة بين الإصلاحات الاقتصادية والحريات السياسية: رؤية 2030 والتحول الديمقراطي في السعودية»، رواق عربي، 28 العدد 1 (2023)، 39. https://doi.org/10.53833/WLUK6425.
[48] مروان المعشر وآخرون، «انكسارات عربية: مواطنون، دول، وعقود اجتماعية»، 18 يناير 2017، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. تاريخ الاطلاع 17 يوليو 2025. https://tinyurl.com/yoexwt5w.
[49] لؤي علي، «مدخل إلى فهم الصراع الاجتماعي في الكويت من خلال التصويت على القوانين الاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي (2006-2012)»، مجلة عمران، 7، العدد 28 (2019): 77-78. https://doi.org/10.31430/YYWD4901.
[50] مصطفى حجازي، الشباب الخليجي والمستقبل، 85.
[51] برونو بالييه، تحسين الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة في الكويت [Final Report: Improving Social Protection for the Most Vulnerable in Kuwait]، (معهد الدراسات السياسية،2021)، 12. تاريخ الاطلاع 01 أبريل 2025، https://tinyurl.com/3bt8dtz6.
[52] محمد بن أحمد الصالح، الرعاية الاجتماعية في الإسلام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، (العبيكان للنشر، 1999)، 227-228.
[53] رنا جواد وولاء طلعت، الحق في الصّحة من منظور الحماية الاجتماعية، (شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، 2023)، 10، تاريخ الاطلاع 17 يوليو 2025، https://tinyurl.com/32j662hs.
[54] رنا جواد، «هل تصبح الحماية الاجتماعية أكثر تضامنًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟»، في الحماية الاجتماعية في أعقاب الربيع العربي (مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل، 2017)، 15. 59. تاريخ الاطلاع 11 يوليو 2025. https://tinyurl.com/4zrn7xr3.
[55] على سبيل المثال بلغ إجمالي الإنفاق الإجمالي بالسعودية لسنة 2023، 250 مليار ريال موزعة بين 97 مليار منافع اجتماعية و27 مليار في صورة إعانات ومنح؛ للمزيد: المملكة العربية السعودية، بيان الموازنة للسنة المالية 2024 [Budget Statement Fiscal Year 2024]، (وزارة المالية، 2024) ، تاريخ الاطلاع 10 مايو 2025، https://tinyurl.com/2dg3j67v.
[56] المملكة العربية السعودية، ميزانية العام المالي 2025: نسخة المواطن، (وزارة المالية، 2025)، 12، تاريخ الاطلاع 05 مايو 2025، https://tinyurl.com/2xvmq2kq.
[57] الإسكوا، الإنفاق الاجتماعي، وكفاءة الإنفاق والاستدامة المالية: استراتيجيات لإعادة التوازن إلى ميزانية الكويت (بيروت: الأمم المتحدة، 2025)، ص 2، تاريخ الاطلاع 05 مايو 2025، https://tinyurl.com/26sc843w.
[58] البحرين، الاستعراض الوطني الطوعي، 50.
[59] علي قاسم، «الكويت من أكثر دول العالم سخاء في الإنفاق الاجتماعي… بـ 13.88 مليار دينار»، الراي، 26 مايو2024، تاريخ الاطلاع 29 أبريل 2025، https://tinyurl.com/27jcfzxo.
[60] صلاح بن فهد الشلهوب، «البرامج الاجتماعية في ميزانية 2024»، الاقتصادية، 9 ديسمبر 2023، تاريخ الاطلاع 08 مايو 2025، https://tinyurl.com/22hy5kf3.
[61] بشرى شعبان، «22 مليون دينار شهريًا للمساعدات الاجتماعية»، الأنباء، 14 يناير 2025، تاريخ الاطلاع 26 يونيو 2025، https://www.alanba.com.kw/1291108.
[62] عبد الله جناحي، «الفقر في البلدان العربية وأنسنة الاقتصاد»، صفر، 25 مارس 2025، تاريخ الاطلاع 15 مايو 2025، https://alsifr.org/poverty-arab-countries.
[63]مملكة البحرين، «حقائق وأرقام»، (وزارة التنمية الاجتماعية، 2025)، تاريخ الاطلاع 12 مايو 2025، https://www.social.gov.bh/media/statistics.
[64] الإسكوا، التأمين الصحي المدعوم للفئات التي يصعب الوصول إليها: نحو تغطية صحية شاملة في المنطقة العربية، (بيروت: الأمم المتحدة، 2022)، 31، تاريخ الاطلاع 17 أبريل 2025، https://tinyurl.com/adzhrmh7.
[65] الإسكوا، 3.3 مليون مواطن في بلدان مجلس التعاون الخليجي في براثن الفقر، (بيروت: الأمم المتحدة، 2023)، 1-2، تاريخ الاطلاع 11 أبريل 2025، https://tinyurl.com/4z88zuen.
[66] ماركوس وزينتل، هشاشة الدولة، 7.
[67] بن بريك، «استجابات الحماية الاجتماعية في دول الخليج العربي،» 39-40.
[68] ماري أوهارا، تقشف قاسٍ: رحلة إلى الحافة الحادة لسياسات التخفيض في المملكة المتحدة [Austerity Bites: A Journey to the Sharp End of Cuts in the UK ]، (بوليسي برس، 2015)، 5. https://doi.org/10.2307/j.ctt13x0q6t.
[69] كالفرت جونز، من بدو إلى برجوازيين: إعادة تشكيل المواطنين من أجل العولمة [Bedouins into Bourgeois: Remaking Citizens for Globalization]، (جامعة كامبريدج، 2017)، 77-78. https://doi-org/10.1017/9781316800010.
[70] نيبلوك ومالك، الاقتصاد السياسي للمملكة العربية السعودية، 17-18.
[71] منذر ماخوس، إرهاصات التنمية والثورات المجهضة في العالم العربي، (المعهد العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2022)، 126، https://tinyurl.com/yc24w6h7.
[72] صندوق النقد العربي، نافذة على طريق الإصلاح: إصلاحات شبكات الأمان الاجتماعي في الدول العربية، (صندوق النقد العربي، 2019)، 8، تاريخ الاطلاع 15 مايو 2025، https://tinyurl.com/yr6srdkr.
[73] محمد عبد الشفيع عيسى، «دور شبكات الأمان في الحماية الاجتماعية للفقراء في الدول العربية»، شئون عربية، العدد 130 (2007): 102، تاريخ الاطلاع 19 مايو 2025، https://tinyurl.com/5f9e9dda.
[74] هويدا عدلي رومان، «هـل برامـج التخـارج مـن الفقـر قـادرة فعلاً على تحريـر الفقـراء مـن فـخ الفقـر؟ تـأملات في تجـارب دوليـة وإقليميـة»، مبادرة الإصلاح العربي (2024)، 7، تاريخ الاطلاع 22 مايو 2025، https://tinyurl.com/v2uam8t2.
Read this post in: English