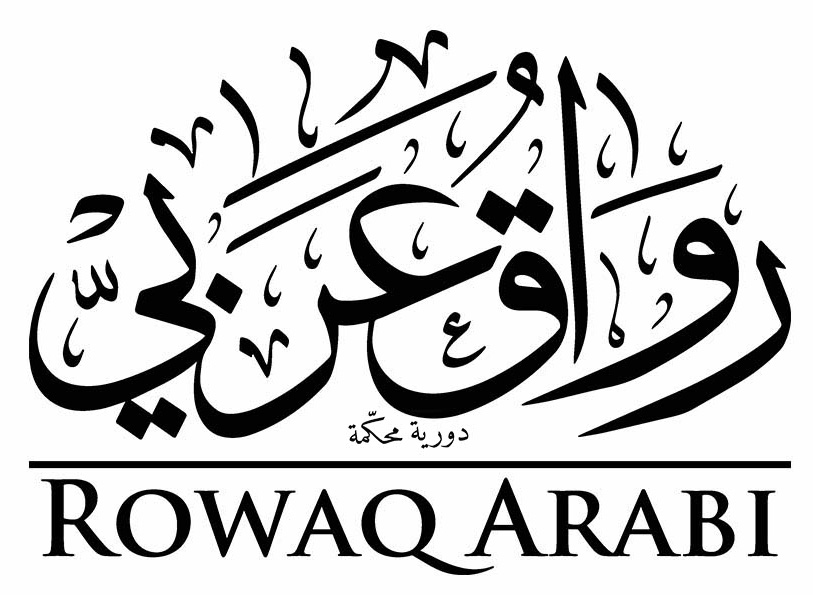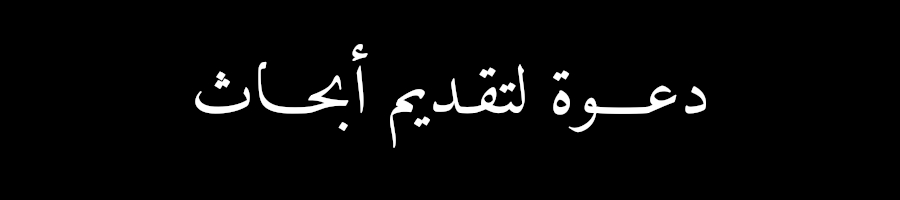الحجاب السياسي والكولونيالية النفطية في الفيلم الإيراني «فتاة تسير إلى المنزل وحيدة في الليل»

الإشارة المرجعية: الرفاعي، إنجي. 2025. «الحجاب السياسي والكولونيالية النفطية في الفيلم الإيراني فتاة تسير إلى المنزل وحيدة في الليل». رواق عربي 30 (2): 32-44.https://doi.org/10.53833/MVFN9661.
خلاصة
تستكشف هذه الدراسة رمزية الحجاب في فيلم المخرجة الإيرانية آنا ليلي أميربور «فتاة تسير إلى المنزل وحيدة في الليل» (A Girl Walks Home Alone at Night) الصادر عام 2014. ورغم أنّ هذا الفيلم يُنسب على نطاق واسع إلى النقاشات النسوية التي تؤطر الحجاب بوصفه رمزًا للقمع الأبوي، فإنّ هذا التصنيف يتغافل عن التأثيرات التاريخية والإمبريالية التي ربطت بين الحجاب والقمع؛ وهو خطاب اكتسب زخمًا خلال حقبة الاستعمار الأوروبي للشرق الأوسط في القرن التاسع عشر، ولا سيّما حين اندمج مع استغلال النفط في ظلّ جهود التحديث التي قادتها إيران. كما يتجاهل هذا التصنيف تسييس الحجاب في إيران الحديثة من قِبل القوى العلمانية والدينية على حدّ سواء، وهو تسييس ارتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسات النفط. وعليه، تبحث هذه الدراسة في الكيفية التي يتشابك بها خطاب الحجاب في إيران مع الإمبريالية النفطية، مستندةً إلى منهج التحليل التاريخي لوضع الفيلم في سياق التاريخ البترو-سياسي لإيران وفهم أثر هذا السياق على خطاب الحجاب عبر الزمن. وبالاستناد إلى نظرية ما بعد الكولونيالية، تخلص الدراسة إلى أنّ خطاب الحجاب في إيران متداخل جوهريًا مع الإمبريالية النفطية، وهي رؤية لا تدعم السردية التي يطرحها الفيلم فحسب، بل تُغفلها أيضًا الكثير من القراءات النسوية في النقد الإعلامي.
مقدمة
ظلت المرأة المسلمة، لا سيما تلك التي تعيش في الشرق الأوسط، إحدى أبرز الموضوعات التي هيمنت على نقاشات وسائل الإعلام الغربية على مدى العقود القليلة الماضية. ويُعد الحجاب الإسلامي أحد أكثر الرموز إثارة للجدل وتداولًا في النقاش كدلالة على قمع المرأة في ظل ما يُصطلح على تسميته بالبُنى الأبوية، وكأن أصول هذا النظام الأبوي ووجوده يقتصر حصرًا على مجتمعات الشرق الأوسط أو المجتمعات الإسلامية؛ وهو افتراض استشراقي يغفل عن التاريخ المتجذر للقمع القائم على النوع الاجتماعي في المجتمعات الغربية ذاتها.[1] وفي واحدة من أشهر مقولات المفكر والناشط الإسلامي الهندي المرموق أصغر علي إنجنير، يقول: «ظلت النساء، لآلاف السنين، في حالة خضوع تام في جميع المجتمعات الأبوية، وقد صادف أن معظم المجتمعات كانت أبوية. ومن ثم، ساد لقرون اعتقاد مفاده أن «القانون الطبيعي» يقضي بأن النساء أدنى منزلة من الرجال، ويتعين عليهن الخضوع لسلطة الرجال لضمان إدارة الحياة الأسرية بشكل سلس».[2] ورغم ذلك، لا تزال الصورة النمطية للمرأة الشرق أوسطية، التي هيمنت طويلًا على الإعلام الغربي، هي صورة «كائن مقموع ومُحاط بهالة من الإثارة الجنسية، يخضع لسيطرة الرجل والدين».[3] وبطبيعة الحال، فإن تواتر صور النساء المحجبات، والذي يتجلى بأوضح صوره في إيران ما بعد الثورة، يساهم في توطيد هذا الوضع الراهن. بيد أن توصيف هؤلاء النساء غالبًا ما يعجز عن الإحاطة، ليس فقط بالمسار التاريخي للحجاب، بل وأيضًا بالسجالات السياسية التي شكّلت الخطاب المحيط به.
في وجهة نظري، تربط أميربور خطاب الحجاب في إيران باستغلال النفط، بوصفه شكلًا من أشكال القمع الذي يغذي فعليًا البُنى الأبوية المدانة بشدة من جانب النسويات الغربيات. فمن خلال ربطها الحجاب بالإمبريالية النفطية، فإنها تنتقد كلًا من السرديتين الغربية والشرقية للحجاب. فيما يتعلق بالسردية الأولى، فإنها تُبيّن أن الحجاب ليس مجرد رمز للقمع في ظل الهيمنة الذكورية، بل هو علاوة على ذلك رمز يرتبط في جوهره باستغلال النفط كشكل من أشكال الهيمنة الإمبريالية. فتاريخيًا، كان الربط بين الحجاب الإسلامي والقمع صنيعة أوروبية،[4] اكتسبت زخمًا أثناء حقبة الاستعمار الأوروبي للشرق الأوسط في ظل خطاب «المهمة الحضارية» المرتبط بالتحديث.[5] وهي الفترة ذاتها التي شهدت الاستيلاء الإمبريالي البريطاني على النفط الإيراني للأغراض الصناعية والحربية على حد سواء.[6]
تقدم ليلى أحمد، أستاذة اللاهوت بجامعة هارفارد، والتي اشتُهرت بأعمالها المؤثرة في مجال الإسلام والنسوية في الشرق الأوسط، نقدًا لاذعًا للرؤية الأوروبية المركزية التي تربط الحجاب بالقمع. فمع بلوغ التوسع الإمبريالي الأوروبي آفاقًا جديدة، تزايدت أيضًا مزاعمهم بشأن تفوقهم العرقي والحضاري المتأصل. إذ أن الدراسات الأنثروبولوجية في ذلك الوقت «قدمت «أدلة» علمية، كتلك التي استُخلصت من قياس الجماجم، والتي رسّخت «حقيقة» التفوق العرقي الأوروبي».[7] هذه الدراسات المزعومة عززت مفاهيم دونية الرعايا غير الأوروبيين والنساء في آن واحد، وهي سردية رائجة خدمت مصالح المؤسسة الفيكتورية في بريطانيا العظمى. وفي ظل الاعتقاد الأوروبي السائد بأن النساء وغير البيض أدنى منزلة بطبيعتهم، نُظر إلى الحجاب في المجتمعات غير الأوروبية باعتباره دليلًا على قمع المرأة؛ إذ فُسّر حجاب النساء وحجبهن خلال اللقاءات المبكرة للأوروبيين مع الإسلام من خلال الأطر الدينية والثقافية الأوروبية.[8] وفي كتابها «المرأة والجندر في الإسلام: الجذور التاريخية لنقاش حديث»، تؤكد أحمد أن هذه السردية المركزية الأوروبية «مستمدة من حكايات الرحالة والصليبيين»،[9] مما يكشف عن الجذور العميقة لهذا الخطاب المجحف.
وفيما تتحدى أحمد في أعمالها الأكاديمية السرديات السائدة حول حجاب المسلمات؛ إلا أنها لم تستكشف علاقة خطاب الحجاب باستغلال النفط بالشكل الكافي. وفي هذا الصدد، تنتقد أميربور تسييس الحجاب في إيران على يد الأنظمة العلمانية والدينية على حد سواء، كاشفةً كيف استغلّت كلتا القوتين الحجاب لخدمة مآربهما. تاريخيًا، شكّل الحجاب ساحة للسجال السياسي في إيران الحديثة، بدءً من إجبار النساء على خلع الحجاب إبان عهد رضا شاه بهلوي في ثلاثينيات القرن الماضي في إطار مخططاته التحديثية، وصولًا لإعادة فرض الحجاب الإلزامي على النساء على يد آية الله الخميني في أعقاب ثورة 1979، بموجب الشريعة الإسلامية في جمهورية إيران الإسلامية. وبينما يعكس كلا الحدثين الصراع السياسي بين القوى العلمانية والدينية في إيران وتنازعهما على السيطرة على هوية النساء وجنسانيتهن؛ إلا أنهما يعكسان أيضًا، وبشكل أعمق، تحولات جيوسياسية كبرى في التوجه الاقتصادي للبلاد القائم على النفط، وهو الأساس الذي استند إليه كلا الحاكمين لترسيخ سلطتهما على الصعيدين المحلي والدولي.
للأسف، يكشف كلا الحدثين كيف أن الإمبريالية الغربية والاستبداد المحلي لم يؤثرا فحسب على خطاب الحجاب في إيران، بل قادا أيضًا إلى إجحاف معرفي بالغ أسفر عن تقليص دور الحجاب التعريفي والوظيفي في التاريخ.[10] وقد استكشفت حميدة صدقي، وهي عالمة سياسة ونسوية إيرانية–أمريكية اشتهرت بأعمالها حول السياسات الجندرية في إيران، كيف يعكس تسييس الحجاب في إيران صراعات أوسع نطاقًا على السلطة وأيديولوجية الدولة. وفي كتابها «النساء والسياسة في إيران: الحجاب، والسفور، والعودة لارتداء الحجاب»، تبحث صدقي كيف أن الدولة الإيرانية، سواء كانت علمانية أم إسلامية، دأبت على توظيف النساء وجعلهن بمثابة ساحات تعبّر عن أيديولوجيا الدولة وسيطرتها. ورغم ذلك، وكما هو الحال مع أحمد، هناك افتقار ملحوظ للأدبيات التي تربط بين تسييس الحجاب في إيران واستغلال النفط. وبينما تحث كلتا الباحثتين على قراءة متعمقة للإجحاف الذي تعرّض له خطاب الحجاب؛ فإن جُل أعمالهما الأكاديمية يركز إما على تفسيرات دينية أو ثقافية، متجاهلًا دور سياسات النفط كقوة بنيوية. وكما سأبيّن لاحقًا، يعالج الفيلم هذه المسألة من خلال جمالياته البصرية، لا سيما عبر توظيف المخرجة لرمزية الحجاب ومشاهد النفط التي تليها. وفي الواقع، تطرح أميربور هذه العلاقة بتقديمها حجاب بطلة الفيلم كرمز سياسي متجذر في بنى السلطة الأيديولوجية في إيران، بما في ذلك توجه البلاد الاقتصادي القائم على النفط؛ فمن خلال الربط البصري بين بطلة الفيلم المحجبة ومشاهد حقول النفط في الفيلم، تصوغ أميربور سردية تعيد تأطير خطاب الحجاب في ضوء استغلال النفط.
يقدم فيلم «فتاة تسير إلى المنزل وحيدة في الليل» شخصية مصاصة دماء غامضة ومجهولة الاسم ترتدي الشادور،[11] تُعرف ببساطة باسم «الفتاة»، وهي تفترس ليلًا الرجال المعتدين والممارسين للعنف في «المدينة الآثمة»، وهي مدينة إيرانية خيالية يقطنها مدمنو المخدرات وعاملات الجنس، وتحيط بها حقول النفط الصناعية. خلال الليل، تجوب بطلة الفيلم الشابة شوارع «المدينة الآثمة» وتراقب سلوكيات أقرانها من المتجولين ليلًا. وقد اختارت ملاحقة الرجال المسيئين للنساء، لا سيما عاملات الجنس، كما أنها تُخيف الفتيان الصغار لتدفعهم إلى معاملة النساء باحترام. ونظرًا لهذه السمات المتعلقة بالحبكة، حظي الفيلم باحتفاء واسع بوصفه فيلمًا نسويًا.[12] فمن هذا المنظور، فإن ما يدفع المشاهدين إلى تصنيف الفيلم نسويًا لا يكمن فقط في أفعال ضحاياها التي تحدد طبيعة نشاطها النسوي، وإنما أيضًا في مراقبتها للفتيان الصغار ومواجهاتها معهم؛ إذ إنها تتدخل بشكل جليّ في حاضر ومستقبل النظام الأبوي.
بيد أن هذه الرؤية، كما أزعم، لا تعدو كونها الواجهة، إذ إن «الفتاة»، التي تجوب شوارع «المدينة الآثمة» ليلًا لتفترس من يعاملون النساء بإجحاف ويسيئون إليهن، لا تظهر في القصة سوى مرتين فحسب. فضلًا عن ذلك، فإن أميربور نفسها أبدت نفورًا من هذه التأويلات النسوية. ففي إحدى المقابلات، حينما سُئلت عما إذا كانت قد عمدت لأن ينطوي الفيلم على مضامين نسوية، أجابت بتحفظ قائلة: «أجد أن هذه الفلسفات [النسوية] هي العلّة التي تدّعي أنها تُقدّم الدواء الشافي منها».[13] وحثت الجمهور على التأمل في سبب مسارعتهم إلى إطلاق صفة النسوية على القصص التي تتمحور حول النساء، رغم أن التأويل النسوي قد لا يتناسب بالضرورة مع سردية العمل. في حقيقة الأمر، تكشف لنا بيئة الأحداث في الفيلم الكثير عن مغزاه؛ إذ تتكرر مشاهد منصات النفط فيما تواصل استخراج النفط من باطن الأرض بلا هوادة، فيما تُعرض جثث الموتى في إحدى الخنادق على الملأ ودونما اكتراث، كما تظهر للعيان أسر فقيرة فتك بها الانغماس في المخدرات والبغاء. وبوضوح، يتجلى هذا الإطار العام المختل والقاتم في علاقات الشخصيات ببعضها البعض، بما يُبرز الويلات التي جلبها «الذهب الأسود» إلى إيران. وليس من قبيل المصادفة أن كل مشاهد القتل التي تنفذها «الفتاة»، يعقبها مشهد يصور إما تعاطي المخدرات أو استخراج النفط من المنصات. ويمكن القول إن أميربور تلمح إلى تأثير استغلال النفط على الثقافة الإيرانية من خلال الصور التي تقدمها، وكذلك، وهو الأكثر أهمية، من خلال طريقة ارتداء «الفتاة» للشادور. فالصور المتكررة لآبار النفط النشطة تسير في خط موازٍ مع جرائم القتل التي ترتكبها «الفتاة»، مما يشي بوجود صلة تاريخية بينهما.
رغم أن الشادور هو رداء أسود تقليدي يغطي كامل الجسد، ويرتبط في العادة بمفهوم الاحتشام في إيران ما بعد الثورة؛ إلا أن «الفتاة» لا ترتديه امتثالاً للتقاليد الدينية أو المحافظة، وإنما يبدو تحته قميص مخطّط وحذاء رياضي، ما يشي برغبتها في تحطيم التركيبة البصرية النمطية التي تربط الاحتشام بالخضوع، وإفساح المجال لتأويلات أخرى. وفي قراءتي للفيلم، أزعم أن طريقة ارتداء البطلة للشادور ترمز إلى كلا النظامين السياسيين في إيران: النظام العلماني المرتبط بالحداثة، والنظام الديني المرتبط بالأسلمة. ورغم ذلك، عمدت أميربور في معظم مقابلاتها الإعلامية إلى التقليل من شأن الدلالات السياسية للفيلم،[14] بما فيها تلك المتعلقة بالحجاب. فهي «لا ترى رسالة جليّة في استخدام الشادور، لكنها تؤكد على بُعده الحسي والملموس كأحد أدوات الفيلم».[15] إلا أنني أرى في قراءتي أن تركيز أميربور على الخصائص المادية للشادور لا يقلل من أهمية رسائله السياسية –والتي تتمثل، في وجهة نظري، في رغبتها بألا يتموضع فيلمها ضمن المشهد الجيوبوليتيكي المعاصر، تمامًا كما لا تريده أن يصطف مع النسوية الغربية. وبهذه الطريقة، فإنها تثير تساؤلًا بشأن شرعية المرجعيات الأيديولوجية المهيمنة التي توجه كلاً من النسوية والجيوبوليتيك.
ورغم ذلك، لا يزال بوسع المرء أن ينسب استخدامات ودلالات متعددة للصورة الظاهرية للحجاب.[16] ففي نهاية المطاف، فإن طريقة ارتداء «الفتاة» للشادور لا تقتصر على زعزعة المجاز الذي أضفته المركزية الأوروبية على الحجاب كرمز للقمع، وهي الصورة الرائجة في المخيال الغربي الشعبي منذ ثورة 1979؛ بل إنها تثير أيضًا تساؤلات بشأن الاستخدامات والدلالات التاريخية متعددة الطبقات للحجاب في إيران والفروق السياسية الدقيقة المرتبطة به، لا سيما فيما يتعلق بوضع الفيلم في سياقه الجيوبوليتيكي. فوقت صدور الفيلم عام 2014، كانت إيران تتفاوض على إعادة فتح اقتصادها، لا سيما قطاعها النفطي، بعد سنوات من العزلة[17] في مقابل فرض قيود كبيرة على برنامجها النووي. ورغم أن الفيلم لا يدور صراحة حول النفط، تمامًا كما لا يدور صراحة حول النسوية، إلا أن صداه يتردد مع اللحظة التاريخية التي صدر فيها. إذ يصبح شادور «الفتاة» بمثابة استعارة سينمائية لتسييس الحجاب في إيران، والذي تأثر وتم تشكيله نتيجة النفط؛ والذي رغم أنه يعد هبة باعتباره موردًا طبيعيًا، ولكنه في الوقت ذاته يمثل لعنة، كأحد بواعث التدخل الإمبريالي واندلاع الحروب. ويمكن النظر إلى الفيلم، في هذا الصدد، كاستجابة ثقافية لحالة إيران الحدّية، كبلد عالق بين القمع والتغيير، والعزلة وإعادة الاندماج. والأمر ذاته ينطبق على رمزية الشادور، بوصفه علامة سياسية دالة، إن لم يكن تعليقًا تاريخيًا، على ساحات المعارك التاريخية التي تجلت فيها فصول علاقة الدولة المتقلبة بسياسات النفط العالمية. وفي الواقع، لطالما كان الشادور بمثابة مؤشر جليّ على انحياز الدولة إلى النفوذ الأجنبي على النفط أو مقاومتها له.
بناءً على ما تقدم، سيأتي هيكل هذه الدراسة على النحو التالي: أولًا، أقدم ملخص وحبكة الفيلم. ثانيًا، أتناول المسار التاريخي لاستغلال النفط في إيران وتأثيراته على خطاب الحجاب. ثالثًا، سأربط السياق الجيوبوليتيكي للفيلم ورمزية الحجاب بالسياق التاريخي لإيران في ذلك الوقت. وأخيرًا، سأقدم تعقيبًا ختاميًا حول الكيفية التي تتشابك بها سياسات الحجاب في إيران بشكل عميق مع استغلال النفط.
ملخص وحبكة الفيلم
يقدم فيلم «فتاة تسير إلى المنزل وحيدة في الليل» شخصية مصاصة دماء شابة (Sheila Vand) ترتدي الشادور، وتفترس الرجال المعتدين والممارسين للعنف في مدينة آثمة، وهو عالم سفلي إيراني خيالي يقطنه منبوذون اجتماعيًا مثل مدمني المخدرات، والقوادين، ومدمني الهيروين، والبغايا. تُغرم «الفتاة» بآراش (Arash Marandi)، الذي قد يكون أول علاقة إنسانية حقيقية لها منذ أمد طويل. تُفتتن «الفتاة» بمظهره الآخاذ الشبيه بالممثل جيمس دين، وهي التي لم تعرف حقًا في البداية كيف لها أن تتعامل مع رجل ليس سيئًا (مثل الآخرين الذين تقتلهم). يعمل آراش بستانيًا وعامل صيانة في إحدى الضواحي لدى فتاة ثرية تدعى شايدة (Rome Shadanloo)؛ لإعالة والده حسين (Marshall Manesh) المدمن على الهيروين، والذي يتولى رعايته منذ وفاة والدته. ومن بين الشخصيات الأخرى في الفيلم سعيد (Dominic Rains)، وهو تاجر مخدرات وقواد، يزود حسين بالمخدرات. وفي إحدى المرات، يستولي سعيد على الشيء الوحيد الثمين الذي يملكه آراش، وهي سيارة ثندر بيرد كلاسيكية من طراز الخمسينيات، مقابل المال الذي يدين به والده له. ومن خلال سعيد، نتعرف على آتي (Mozhan Marnò)، وهي عاملة جنس ترتبط بكل من سعيد وحسين. وهي تمثل نموذجًا آخر لامرأة، إلى جانب «الفتاة»، تسير وحدها إلى المنزل ليلًا، في محاولة لشق طريقها في عالم «المدينة الآثمة». وتشعر «الفتاة» نحوها بالمودة وتحاول إنقاذها من سعيد وحسين. إذ يستغلها سعيد بعنف، رافضًا منحها المال الذي يدين به لها، فيما تراقبهما «الفتاة». وفي طريق عودته إلى منزله، يدرك سعيد أن «الفتاة» تلاحقه، فيظن أن ذلك تعبيرًا عن اهتمامها به؛ إلا أن «الفتاة» تنتقم منه وتقضي عليه. وبينما تستطلع «الفتاة» المظالم التي تعصف بـ «المدينة الآثمة»، ينتابها شعور بأن حسين أيضًا يستغل آتي. وفجأة، تظهر في منزل آتي وتقتله.[18]
وفيما يربط الفيلم المشاهدين بأفعال «الفتاة»، التي تعبر عن غضبها العارم تجاه الرجال المسيئين الذين تقتلهم؛ فإن العنف الذي تُجسده «الفتاة» ليس العنف الوحيد الذي يقدمه الفيلم، هذا إن كان يمكن اعتباره عنفًا حقًا، إذ يتضمن هذا العمل السينمائي أشكالًا أخرى من العنف تتجاوز ما تراه أعين المشاهدين بوضوح. إذ أن «المدينة الآثمة» نفسها تحمل قوة تأويلية أكبر بكثير في الفيلم؛ فهي تمثل شخصية قائمة بذاتها مشبعة بالانحطاط والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي واقع الأمر، تبتكر أميربور صورة خيالية لإيران تعكس تاريخها الحقيقي في استغلال النفط والآثار طويلة الأمد لهذا الاستغلال على المجتمع الإيراني وكذلك على البيئة. فمنذ المشاهد الأولى لـ «المدينة الآثمة»، يتم ترسيخ صورة البلدة كأرض صناعية قاحلة تفتقر للحياة، مع صور لأبراج التنقيب عن النفط في الخلفية تواصل الضخ في إيقاع منتظم. هذه الصور ليست عرضية؛ فتاريخ إيران يتشابك بعمق مع استغلال النفط الذي يعود تاريخه (على عكس الآراء السائدة التي تربطه فقط بالإمبريالية الأمريكية) إلى عام 1901 عندما مُنح امتياز النفط، لأول مرة، لمدة ستين عامًا لأحد الرعايا البريطانيين وهو ويليام نوكس دارسي.[19] واستنادًا لهذا الامتياز، سيطرت بريطانيا لاحقًا على شركة النفط الأنجلو–فارسية (المعروفة حاليًا باسم «بريتيش بتروليوم BP») وعلى صناعة النفط حتى تأميمها عام 1951، والانقلاب الذي أعقب ذلك بدعم من وكالة المخابرات المركزية.[20]
وبالمثل، فإن رمزية الشادور ليست عرضية، إذ تشابك استغلال النفط مع خلع الحجاب في إيران في ظل سياسات ومخططات التحديث التي اقترحها الغرب وتبناها الشرق، والتي شكلت أساسًا لتفاقم التفاوتات الاجتماعية وانعدام الاستقرار السياسي. وهذه هي «أطروحة الخطاب الكولونيالي الجديد»،[21] وتفاعل أميربور معها، والذي يتجلى في الطريقة المختلفة التي ترتدي بها «الفتاة» الشادور. وفي رأيي، فإن هذه الطريقة المختلفة في ارتداء الشادور هي دعوة لإعادة النظر في المفاهيم الغربية الخاطئة عن الحجاب الإسلامي كرمز للقمع. وهي أيضًا دعوة لإعادة النظر في التسخير والتسييس التاريخي للحجاب في إيران على يد القوى العلمانية والدينية على حد سواء، فضلا عن الاحتجاجات الثورية[22] التي تزامنت مع تسييس الحجاب قبل ثورة 1979 بوقت طويل، وهي قضية أغفلها العديد من الباحثين الغربيين.
لا يمكن إنكار أن شخصيات «المدينة الآثمة» تعكس العواقب المجتمعية لاستغلال النفط؛ فالعديد من سكان البلدة مجرمين أو مدمني مخدرات أو قوادين، وهم أناس يمثلون مجتمعًا تُرك فريسةً للعفن بعد سنوات من الاستغلال والتدهور الاقتصادي. وفي الواقع، بالاستناد إلى نظرية التبعية،[23] يمكن للمرء ملاحظة كيف يوضح الفيلم أن استغلال النفط يخلق حالة من التبعية تتجلى بوضوح في علاقات الشخصيات ببعضها البعض. على سبيل المثال، ترتبط المخدرات التي يبيعها سعيد بتبعية مدمرة لحياة حسين، والد آراش، الذي غالبًا ما يكون في حالة أشبه بالسُبات. وفي وقت لاحق من الفيلم، يبيع آراش المخدرات التي كانت في حوزة سعيد في البداية لتدبير أمور معيشته. كما يستغل سعيد عاملة الجنس آتي بعنف، والتي تعتمد بدورها على عملها لمحاولةً البقاء على قيد الحياة في «المدينة الآثمة»؛ إذ يجبرها على ممارسة الجنس الفموي ثم يرفض أن يدفع لها مقابل خدماتها.
ويمكن القول إن استغلال النفط هو ما أفرز في المقام الأول شخصية سعيد، تاجر المخدرات والقواد. فمثقلًا بوطأة الواقع القاسي للمجتمع الرأسمالي الحديث الذي تجسده «المدينة الآثمة»، لا يجد سعيد أي إنصاف في هذه المدينة؛ ما يدفعه إلى تحقيق ذاته من خلال العنف. ولعل سعيد يمثل قصة «الرجل المنسي» الذي سحقه المسار التاريخي الكولونيالي لاستغلال النفط. ويشمل هذا المسار العنف الذي لحق بإيران (فارس آنذاك) خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية من خلال الغزوين الروسي والبريطاني، رغم إعلانها الحياد.
كذلك، تشكلت شخصية «الفتاة» بفعل استغلال النفط؛ إذ تستخدم قدراتها كمصاصة دماء لافتراس الرجال الذين يستغلون النساء ويعاملونهن بقسوة. فكما أن مصاصي الدماء يستنزفون الدماء ليبقوا على قيد الحياة، استنزفت صناعة النفط في إيران بدورها أثمن موارد البلاد لتخدم المصالح الغربية، مُخلفةً وراءها مجتمعًا خاويًا. وبناءً على هذا الطرح، يصبح الشادور تجليًا للإجحاف المعرفي المفروض على مغزاه؛ وهو إجحاف يصاحب الاستخراج المادي للنفط الإيراني واستغلاله. فمن خلال تصويره للتدهور الصناعي، وتركيزه على الأفراد المهمشين، وتصويره لشخصية «الفتاة» مصاصة الدماء المرتدية للشادور؛ يسلط الفيلم الضوء على تأثير المسار التاريخي لاستخراج النفط في إيران على خطاب الحجاب. وفي الواقع، لفهم الأبعاد السياسية الكامنة في هذا العمل السينمائي الآسر فنيًا، لا بد للمرء من التنقيب في التاريخ متعدد الطبقات للحجاب وخلع الحجاب والعودة لارتداء الحجاب في إيران، وصلاته المعقدة بالإمبريالية النفطية. ولتحقيق ذلك، يجب أيضًا وضع الفيلم في إطاره الأوسع ضمن تاريخ إيران البترو-سياسي، وبشكل خاص باعتباره منتجًا ثقافيًا خلال عام 2014، وهي لحظة فارقة في تاريخ إيران بسبب مفاوضاتها النووية مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، وروسيا، وألمانيا)، والتي هدفت إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي، مما تُوّج بما يُعرف عمومًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).[24] وفي القسم التالي، سأوضح بمزيد من التفصيل كيف أن خطاب الحجاب في إيران كان متشابكًا على نحو وثيق مع الإمبريالية النفطية.
الحجاب والنفط في إيران: نظرة عامة تاريخية
لحق بإيران تاريخ طويل من الأذى من خلال تدخلات القوى العظمى، وهو تاريخ حجبه الإعلام الغربي إلى حد كبير عن الرأي العام. فرغم أن إيران تتمتع باحتياطيات نفطية هائلة؛ إلا أنها ابتُليت أيضًا بهذا المأزق الجيولوجي بسبب أطماع القوى الاقتصادية الكبرى في نفطها، وسعيها إلى نهب هذا المورد الطبيعي. وللأسف، سقطت إيران فريسة لسياسات نفطية لا تعرف الرحمة، وتكبدت خسائر كارثية خلال الحربين العالميتين على حد سواء، إذ تنافست الدول للسيطرة على احتياطاتها النفطية. وبالنظر إلى أن المصالح الغربية في العصر الحديث كانت دائمًا تتحدد بالنفط؛ فقد خضعت إيران لانقلاب عسكري مدعوم من الخارج (1953) وللثورة الإسلامية (1978-1979)، وهما حدثان لم يقتصرا على تشكيل مسار تاريخ إيران الحديث والمعاصر، بل أثرا أيضًا على خطاب الحجاب.
دور النساء في الثورة الدستورية
منذ البداية، تشابك خطاب الحجاب في إيران مع سياسات النفط. فلا يعد مستغربًا أن يتزامن أول امتياز نفطي في إيران، وهو امتياز دارسي الممنوح عام 1901 لمدة ستين عامًا، مع الدور الفريد الذي مارسته المرأة الإيرانية في واحدة من أنجح الحركات الثورية في تاريخ الشرق الأوسط، وهي الثورة الدستورية (1905-1911).[25] فخلال الثورة، قاتلت النساء المرتديات للشادور في الخطوط الأمامية ضد الهيمنة الأجنبية[26] والاستبداد المحلي. وكنّ محجبات ومعزولات في «الأندروني» (andaruni)، وهو المصطلح الفارسي المقابل للحريم،[27] كما جرت العادة الاجتماعية آنذاك. في ذلك الوقت، لم تكن هناك سياسة تفرضها الدولة سواء بخلع الحجاب أو الحجاب، إلا أن الأمر كان جزءً من نقاش أوسع حول الحداثة، وماهية الأُمّة الوطنية، ودور النساء في الحياة العامة. وفي واقع، لم يكن الحجاب رمزًا للقمع بعد، كما لم تكن النساء سلبيات نتيجة للنظام الأبوي بالطريقة التي درجت وسائل الإعلام على تصويرها. بل كانت هؤلاء النساء اللاتي وُصفن بـ «المحجوبات» قادرات على التصرف بفاعلية. فمن خلال سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات والصدامات الدامية، تمكنت النساء المرتديات للشادور، إلى جانب رجال الدين والمثقفين والبازاريين (bazaaris) –(عمال البازارات، وهي الأسواق التقليدية في إيران)– من إرغام مظفر الدين شاه (الذي منح الامتياز النفطي قبل ذلك بسنوات) على قبول الدستور، الذي كان من شأنه إتاحة فرصة لإدماج أصوات الشعب في عملية صنع القرار الحكومي.[28]
بيد أنه في أعقاب الانتصار الثوري الذي أرسى دعائم حكومة دستورية، أُصيبت النساء بخيبة أمل في رجال الدين، الذين رفضوا مطالبهن بالحق في التصويت وفي تعليم الفتيات.[29] لذا، شرعت قلة من النساء المثقفات، معظمهن من الطبقة العليا، في التصدي لهذه القضايا من خلال تنظيم أنفسهن في أحزاب أو «أنجومان» (anjumans) (جمعيات سرية).[30] هذه الأفعال لم تقتصر على نساء النخبة فحسب، فعلى مدار سنوات الثورة الدستورية، تجمعت نساء كثيرات في شوارع طهران، وخلعن حجابهن، وهتفن «عاشت الحرية… يجب أن نعيش كما نريد!».[31] إبان تلك الفترة، طرأ تغير ملحوظ على المجتمع، وهو تغير في نظرة النساء إلى أنفسهن ووعيهن بالعالم خارج نطاق الأسرة. وهذا التمكين –الذي امتد لأول مرة إلى ما هو أبعد من حدود المنزل التقليدية– سمح للنساء بتوجيه غضبهن من القمع الذي تعرضن له عبر الاضطلاع بدور فاعل في التصديق على الدستور عام 1906.
خلع الحجاب الإجباري والتحديث
جلبت الحرب العالمية الأولى عدم الاستقرار والدمار إلى إيران. وللحيلولة دون تفكك البلاد، قاد رضا شاه انقلابًا دون سفك الدماء ونصّب نفسه ملكًا عام 1925 بعد الإطاحة بالملكية القاجارية، بهدف استعادة سيادة إيران المنقوصة. وبينما كان يطمح إلى بناء جيش قوي ودولة مركزية، فإنه كان متشبعًا بالمفاهيم الغربية والأوروبية. وتمثلت رؤية رضا شاه لإيران في مجتمع يضم مؤسسات تعليمية علمانية، تضاهي نظيراتها في أوروبا، تدرس وتُعلّم فيها نساء غير محجبات يرتدين ملابس غربية. وجدير بالذكر أنه اعتبر دخول النساء الغير محجبات إلى المساحات العامة مكونًا جوهريًا للحداثة، على غرار المعايير الغربية. وفي عام 1936، أجبر النساء على خلع حجابهن بموجب مرسوم خلع الحجاب الإجباري.[32] وكانت لدى الشرطة الإيرانية أوامر بنزع حجاب النساء قسرًا إن لم يمتثلن للأمر. وبحلول ذلك الوقت، أضحت صورة المرأة الغير محجبة هي صورة إيران، وارتبط بذلك اقتران صورة المرأة الغير محجبة بالمكانة التعليمية. إذ ربط رضا شاه خلع الحجاب بتعليم المرأة، وكأن النساء، بسبب ارتدائهن لغطاء الرأس، مُستبعدات من النشاط الفكري.
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن مبادرة خلع الحجاب جاءت في وقت شهد تغيرًا اجتماعيًا سريعًا، وفي خضم الاضطرابات التي عصفت بالاقتصاد الوطني خلال فترة ما بين الحربين. وفي هذا الوقت، ألغى رضا شاه السياسات السابقة التي كانت سارية بموجب امتياز دارسي؛ إذ كان بحاجة إلى «أموال إضافية من شركة النفط الأنجلو–فارسية، التي كانت قد خفضت عائداتها لإيران خلال فترة الكساد».[33] وفي عام 1933، تم التوصل إلى اتفاق عام جديد عالج العديد من مطالب إيران وحلّ محل امتياز دارسي لعام 1901،[34] وهو ما دفع العديد من القوميين لاحقًا إلى انتقاد الاتفاق واستخدامه لتبرير تأميم النفط الإيراني عام 1951، وهو الحدث الذي أعقبه انقلاب مدعوم من الغرب على القيادة الإيرانية وإحلال الإمبريالية الأمريكية محل الإمبريالية البريطانية. وظل الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بعيدًا كل البعد عن الإنصاف، إلا أنه منح الشاه بعض الأموال اللازمة[35] لإنفاقها على الأسلحة والتشييد وتأسيس جيش قوي.
رغم أن رضا شاه لم يُكمل أي مشاريع إسكان جماعي؛ إلا أنه ترك تأثيرًا بالغًا على الحياة الأسرية من خلال سن تشريعات، مثل «قانون خلع الحجاب»،[36] الذي «أثر بعمق على الشئون المنزلية للنساء من نواحٍ عديدة، ففضلًا عن القيود التي فرضتها عليهن الطبيعة الأبوية للأسرة التقليدية في إيران؛ كان عليهن قضاء معظم أوقاتهن في المنزل».[37] وتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب قانون خلع الحجاب، تأثرت الحياة المنزلية للمرأة الإيرانية بالتغيرات المعمارية التي جلبها التحديث. فعلى عكس المساكن التقليدية التي اعتادت عليها المرأة الإيرانية، كانت مدن النفط الحديثة التي بناها البريطانيون، مثل بواردة في عبادان، «تفتقر إلى أي خصوصية للمرأة الإيرانية».[38] ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، تنازل رضا شاه في نهاية المطاف عن العرش لابنه محمد رضا شاه. وخلال هذه الفترة، برهن النفط الإيراني على أهميته ونفوذه في العلاقات الدولية للمرة الثانية.
الحداثة وإعادة تشكيل الكارتل النفطي
عمل محمد رضا بهلوي (شاه إيران، 1941 – 1979) على توسيع برنامج والده للتحديث على النمط الغربي. ورغم تخفيف قانون خلع الحجاب في عهده؛ إلا أن ذلك كان بمثابة صرف للانتباه عن إعادة تشكيل الكارتل النفطي، وبعبارة أخرى، إعادة بسط السيطرة الإمبريالية الغربية على النفط الإيراني، والذي جاء كرد فعل على تأميم صناعة النفط في إيران، التي كانت «منذ عام 1901 تعمل تحت احتكار البريطانيين». وقد ضمن تشكيل تكتلات نفطية بين شركة النفط الوطنية الإيرانية والكارتل النفطي الدولي وصول شركات النفط الغربية –لا سيما البريطانية والأمريكية– إلى نفط إيران.[39] في تلك الآونة، كانت الولايات المتحدة قد بدأت تنخرط في تصدير النفط الإيراني وضمه إلى دائرة نفوذها، وهو الأمر الذي لا تزال أصداء عواقبه تتردد حتى يومنا هذا. في غضون ذلك، أدى رفع الحظر عن الحجاب إلى عودة الاهتمام بارتدائه مرة أخرى. وكانت هذه الفترة تحررية إلى حد كبير بالنسبة للنساء الإيرانيات؛ إذ منحتهن حرية تقرير ما إذا كن سيرتدين الحجاب أم لا على أقل تقدير، رغم أن ارتداء الحجاب كان لا يزال يعتبر علامة على التخلف في نظر الحكومة الإيرانية. وإلى جانب الحفاظ على موقف مرن تجاه خلع الحجاب، أقرّ محمد رضا شاه عام 1963 سلسلة من الإصلاحات التحديثية، عُرفت باسم الثورة البيضاء، والتي أقرت في بنودها حق المرأة في الاقتراع.[40] وقد استُخدمت عائدات النفط المتزايدة في ذلك الوقت للاستثمار في هذه المشاريع التنموية.
رغم ذلك، لاقت هذه الإصلاحات معارضة من العديد من رجال الدين، مثل آية الله الخميني، الذين اعتبروا مشاريع التحديث هذه نقيضًا للإسلام وتهديدًا للقيم التقليدية.[41] علاوة على ذلك، فإن «هذه السياسات التي سعت إلى تغريب البلاد لم تكن متوائمة مع الأعداد الغفيرة من النساء الإيرانيات المحرومات اللواتي لم ينلن نصيبهن من المنافع الناجمة عن عائدات النفط الضخمة».[42] في نهاية المطاف، أدى الاستقطاب الصارخ في المجتمع بين فاحشي الثراء في القمة والفقراء في القاع، إلى جانب تفشي التضخم، إلى تأجيج السخط الشعبي، وصولًا إلى ثورة 1979 وإعادة فرض الحجاب على النساء في ظل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومنذ ذلك الحين، فرضت القوى العالمية عقوبات، ما فتئت يتسع نطاقها وشدتها بمرور الوقت. وهي العقوبات التي قوضت سيادة إيران، وشلّت قدرتها على الانخراط في التجارة الدولية وتمويل أنشطتها الاقتصادية.
السياق الجيوبوليتيكي للفيلم ورمزية الحجاب
صدر فيلم «فتاة تسير إلى المنزل وحيدة في الليل» عام 2014، في وقت كانت إيران تتفاوض فيه على إعادة فتح اقتصادها. إذ أن العقوبات الدولية، التي يتسع نطاقها وتزداد شدتها، ألحقت ضررًا بالغًا باقتصادها الوطني. وبعد الثورة الإسلامية عام 1979، فاقمت هذه العقوبات من تقويض سيادة إيران. أول حزمة من العقوبات[43] المفروضة على إيران تضمنت حظرًا على وارداتها النفطية، شمل «تجميد جميع أصول الحكومة الإيرانية في الولايات المتحدة البالغة 12 مليار دولار [… و] فرض حظر على التجارة الأمريكية مع إيران وحظر السفر إليها».[44] وفي نهاية المطاف، أقر الكونغرس الأمريكي قانونًا باسم «قانون عقوبات إيران وليبيا لعام 1996» وذلك بهدف «معاقبة الأشخاص أو الشركات التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة الإيراني»،[45] الذي كان مصدر الدخل الرئيسي لإيران. وكانت النيّة المعلنة لفرض العقوبات هو الضغط على إيران لوقف برنامجها للأسلحة النووية وإنهاء دعمها لأعمال الإرهاب الدولي. انتقد المجتمع الدولي هذه الخطوة في البداية، وتمكنت إيران من التغلب على هذه العقوبات لسنوات. ولكن بدءً من عام 2006 فصاعدًا، شرع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات [إضافية] على إيران، تضمنت قيودًا على البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية، مما أرغمها على العزلة عن كل من التجارة الدولية والنظام المالي العالمي.[46] كما وسّعت الولايات المتحدة عقوباتها لتشمل البنك المركزي الإيراني، وكان ذلك بمثابة عرقلة أفضت مباشرة إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الكلي. وفي عام 2012، شعرت إيران بتأثير جميع العقوبات الدولية المفروضة عليها «عندما فقد الريال، عملة إيران، قرابة ثمانين بالمائة من قيمته في عام 2011».[47] ولا شك أن هذه معضلة كبرى لبلد يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. فقط، عند هذه المرحلة، استأنفت إيران المفاوضات بشأن برنامجها النووي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا، مقابل رفع بعض العقوبات. وفي نهاية المطاف، وقّعت إيران عام 2015 على خطة العمل الشاملة المشتركة مع الدول الغربية الكبرى لرفع عقوبات محددة مقابل تقييد برنامجها النووي.[48] وبينما كانت هذه المفاوضات رمزًا لرغبة إيران في إعادة الاندماج في النظام الاقتصادي والسياسي العالمي بعد سنوات من العزلة؛ يمكن القول إن هذا الاتفاق كان أيضًا بمثابة تذكير تاريخي بسيادة إيران النفطية المتنازع عليها، والتي يعود تاريخها إلى انقلاب عام 1953 الذي أنهى جهود التأميم الإيرانية.
على هذه الخلفية، يمكن قراءة فيلم «فتاة تسير إلى المنزل وحيدة في الليل» كتأمل مجازي في مكانة إيران الهشة في العالم. فمن ناحية، يُعد الحضور الدائم لمنصات حفر النفط في «المدينة الآثمة» تمثيلًا بصريًا لاعتماد إيران على النفط، وربما تلميحًا إلى قطاعها النفطي المتعثر الذي كان يرزح تحت ضغط العقوبات. ومن ناحية أخرى، لا تعكس هذه البيئة المقفرة بلدًا تخلف عن الركب فحسب، بل ربما بلدًا ينتظر أن يُبعث مجددًا من خلال الانخراط الدولي.[49] وبالمثل، بات الحجاب، الذي كان يومًا علامة على القمع في السرديتين الشرقية والغربية على حد سواء، مقياسًا ثقافيًا للكولونيالية النفطية في إيران. فمن خلال تتبع المسار التاريخي للحجاب وخلع الحجاب وإعادة ارتداء الحجاب في إيران في ضوء ديناميكيات الإمبريالية النفطية، نرى كيف تشير رمزية الحجاب لسردية جديدة تربط خطاب الحجاب بالديناميكيات الاقتصادية والجيوبوليتيكية الأوسع للنفط، وتدعو في الوقت ذاته إلى تحقيق العدالة المعرفية. في نهاية المطاف، يعد اختزال الحجاب في كونه إما قمعًا أو تمكينًا، كما يفعل معظم الناس، تسطيحًا للتعقيد الثري للتجارب الحياتية للنساء الإيرانيات.
خاتمة
بحثت هذه الدراسة في رمزية الحجاب في فيلم «فتاة تسير إلى المنزل وحيدة في الليل». وخلافًا للخطاب السائد الذي يربط الحجاب بالقمع الأبوي، تطرح هذه الدراسة رؤية جديدة توصل خطاب الحجاب في إيران بالإمبريالية النفطية. فمن خلال تحليل تاريخي مستمد من نظرية ما بعد الكولونيالية، تُبيّن الدراسة كيف يتشابك خطاب الحجاب في إيران مع استغلال النفط، وهي صلة غالبًا ما تغفلها تأويلات وسائل الإعلام النسوية للفيلم. كما تُبرهن على امتداد المنطق الإمبريالي للنفط إلى الميادين الثقافية، بما في ذلك التدخلات الغربية التي فرضت معاييرها الأخلاقية والاقتصادية والجندرية الخاصة على الطبيعة المتصورة للحجاب في إيران. ومن ثم، فإن الكولونيالية النفطية ليست مجرد ظاهرة اقتصادية، بل هي أيضًا ظاهرة معرفية. لذا لا ينبغي النظر إلى النفط ككيان معزول، وإنما باعتباره تجليًا للعلاقات الاجتماعية والسياسية الحقيقية التي شكّلت خطاب الحجاب في إيران وغيرها. وحسبما أكد الباحث المرموق بيتر ر. أوديل، فإنه «بدون النفط لكان الشرق الأوسط منطقة مختلفة جذريًا»،[50] وربما منطقة لا تعرف صراعًا ولا قمعًا. وللأسف، كان اكتشاف النفط في إيران بداية لتاريخ من الاضطراب والتدخل في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي لا تزال تداعياته ملموسة على الصعيد العالمي.
بيان الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
لم يتم استخدام أي أداة ذكاء اصطناعي سواء في البحث أو الكتابة.
شكر وتقدير
أود توجيه الشكر للدكتور ماهر حمّود لنصائحه وتعليقاته المثمرة أثناء كتابة هذه الورقة. كما أتقدم بالشكر إلى البروفيسور جيلبرت بيرونو على لفت انتباهي للسينما الإيرانية والتلقي النسوي لها، لاسيما من خلال فيلم «فتاة تسير إلى المنزل وحيدة في الليل». وأخيرًا، أود أن أعبّر عن امتناني لدورية رواق عربي على احتضانها لاهتمامي البحثي بتطورات حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
هذا المقال كتب في الأصل باللغة الانجليزية لرواق عربي.
[2] أشغار علي إنجنير، حقوق المرأة في الإسلام، (دار ستيرلينغ للنشر، 1992)، 1.
[3] ناهد الطنطاوي، «من الحجاب إلى التدوين: المرأة والإعلام في الشرق الأوسط» (From Veiling to Blogging: Women and Media in the Middle East)، في: المرأة والإعلام في الشرق الأوسط: من الحجاب إلى التدوين (Women and Media in the Middle East: From Veiling to Blogging)، (لندن: روتليدج، 2013)، 767. وهنا، يجد المرء نفسه مدفوعًا إلى التشكيك في فحوى هذا القمع، ببساطة لأن النساء في المؤسسة الفيكتورية في بريطانيا، على سبيل المثال، كنّ أكثر تعرضًا للقمع على يد الرجال. فبغض النظر عن حقيقة أن الزي الفيكتوري لم يكن بأي حال من الأحوال الأكثر تحررًا، فقد كان يُنظر إلى النساء على أنهن أدنى فكريًا من الرجال بسبب «تركيبتهن البيولوجية». ولأن حجم دماغ المرأة أصغر من حجم دماغ الرجل، فقد كان يُفترض أنها أدنى مرتبة. وقد روّج لهذه النظرية بول بروكا، وهو عالم أنثروبولوجيا فرنسي من القرن التاسع عشر، مجادلًا بالدونية البيولوجية للنساء وغير البيض. للمزيد، انظر تشارلز سويرواين، «دماغ المرأة، دماغ الرجل: النسوية والأنثروبولوجيا في أواخر القرن التاسع عشر في فرنسا» (Women’s Brain, Man’s Brain: Feminism and Anthropology in late Nineteenth-century France)، مجلة تاريخ المرأة 12، العدد 2 (2003).
[4] إن اعتبار الحجاب الإسلامي رمزًا للقمع هو فكرة حديثة نسبيًا اكتسبت أهمية مع التوغلات الإمبريالية الأوروبية في معظم أنحاء الشرق الأوسط والسيطرة عليها في القرن التاسع عشر. قبل ذلك كان الحجاب رمزًا للمكانة الاجتماعية بين الطبقة الحاكمة والنخبة الحضرية المسلمة، ولكن مع وقوع المسلمين تحت الهيمنة الأوروبية، اكتسب الحجاب بُعدًا جديدًا ومهمًا يدل على القمع. للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر ليلى أحمد، «نزع الحجاب»، في: ثورة هادئة: صحوة الحجاب، من الشرق الأوسط إلى أمريكا (A Quiet Revolution: The Veil’s Resurgence, from the Middle East to America)، (نيو هيفن: منشورات جامعة ييل، 2011)، 23-24، https://doi.org/10.12987/9780300175059.
[5] لا يجب أن يكون مفاجئًا القول بأن الإمبريالية النفطية كانت بمثابة القاطرة التي اكتسبت إيران من خلالها الحداثة. وقد ساد اعتقاد بأن هذه الحركة الحداثية قد جلبت التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لإيران، وبطبيعة الحال لمناطق أخرى «أقل نموًا» في العالم، مثل مصر وغيرها، وهو ما لم يتحقق في نهاية المطاف.
[6] بالنسبة للبريطانيين، كان الهدف آنذاك هو ضمان مصدر ثابت لهذا الوقود الجديد (بدلًا من الفحم) لقواتهم البحرية. وفي الواقع، يُعتقد أن تدفق النفط الإيراني لم يسفر فقط عن انتصار البريطانيين (والحلفاء) في الحرب العالمية الأولى، بل أسفر أيضًا عن تطور صناعة البترول في إيران في المقام الأول. للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر شبكة شانا لمعلومات الطاقة والبترول، «النفط الإيراني والحربان العالميتان» (Iran Oil and Two World Wars)، 21 أكتوبر 2018، تم الاطلاع عليه في 20 أكتوبر 2025، https://en.shana.ir/news/285275/Iran-Oil-and-Two-World-Wars.
[7] ليلى أحمد، نزع الحجاب، 23.
[8] المرجع السابق، 24. جادلت أحمد بأنهم اعتبروا الحجاب مرتبطًا بتعدد الزوجات، مما رسّخ الاعتقاد بأن الإسلام يقمع النساء، في حين كانت هذه الممارسة نفسها تؤدي إلى الحرمان الكنسي في أوروبا في القرن العاشر. ورغم ذلك، كان تعدد الزوجات موضع احتفاء في التقليد المسيحي شأنه في ذلك شأن الإسلام؛ إذ يسجل الكتاب المقدس العديد من حالات تعدد الزوجات في العهد القديم.
[9] ليلى أحمد، «خطاب الحجاب»، في: المرأة والجندر في الإسلام: الجذور التاريخية لنقاش حديث (Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate)، تحرير كيشا علي، (نيو هيفن: منشورات جامعة ييل، 2021)، 149، https://doi.org/10.12987/9780300258172.
[10] على مر التاريخ، ومنذ التقاليد القديمة وصولًا إلى تجلياته الحديثة، حمل الحجاب دلالات مختلفة باختلاف العصور والمناطق والسياقات والثقافات. لم يبتدع الإسلام الحجاب، كما أن ارتداءه ليس ممارسة تقتصر على الشرق الأوسط. بل إن ارتداء الحجاب تقليد قائم منذ آلاف السنين في الشرق الأوسط ومناطق شاسعة خارجه، بل وحتى قبل ظهور الإسلام في القرن السابع. للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر سحر عامر، ما هو الحجاب؟، (جامعة ساوث كارولينا، 2014)، http://www.jstor.org/stable/10.5149/9781469617763_amer.
[11] يُطلق على الحجاب الذي ترتديه النساء الإيرانيات على وجه الخصوص اسم الشادور، وهو قطعة من القماش تغطي المرأة من رأسها حتى أخمص قدميها. وفي هذه الورقة، أستخدم مصطلحي «الشادور» و«الحجاب» على نحو تبادلي.
[12] وفقًا لهذه الرؤية، يُعد الفيلم نسويًا لمجرد أن «الفتاة» تسعى لتخليص عالم «المدينة الآثمة» الخيالي من عنف النظام الأبوي. وبينما غالبًا ما تصور وسائل الإعلام الغربية النساء المحجبات كضحايا للقمع أو كائنات عاجزة؛ فإن الفيلم يقلب هذه الصورة النمطية، إذ تصبح «الفتاة» الآن هي الصيادة لا الفريسة، ويتحول شادورها إلى أداة للتمكين، لا علامة على الخضوع. وفي هذا السياق، يصبح كل من الفيلم والشادور رمزًا للغضب والمقاومة النسوية ضد البنى الأبوية. للاطلاع على قراءات نسوية، انظر: شادي عبدي وبرناديت م. كالافيل، «يوتوبيا الكوير ومصاصة دماء إيرانية (نسوية): تحليل نقدي للمسخ المقاوم في فيلم فتاة تسير إلى المنزل وحيدة في الليل» (Queer utopias and a (Feminist) Iranian vampire: a critical analysis of resistive monstrosity in A Girl Walks Home Alone at Night)، في: دراسات نقدية في التواصل الإعلامي 34، العدد 4 (2017)، https://doi.org/10.1080/15295036.2017.1302092.
[13] ريتش جوزوياك، «حكاية مصاصة الدماء الإيرانية في فيلم فتاة تسير إلى المنزل وحيدة في الليل» (The Iranian Vampire Tale of A Girl Walks Home Alone at Night)، أرشيف جاوكر، 21 نوفمبر 2014، تاريخ الاطلاع 21 أكتوبر 2025، https://www.gawkerarchives.com/the-iranian-vampire-tale-of-a-girl-walks-home-alone-at-1661607676.
[14] يتجلى هذا بوضوح في نهاية الفيلم في السيارة، حينما تقرر «الفتاة» وحبيبها آراش مغادرة «المدينة الآثمة» متجهين نحو مستقبل غامض. ويمكن القول إن رفض الفيلم تقديم خاتمة سردية يشير إلى الوجهة الغامضة لإيران عام 2014، وهو العام الذي أُنتج فيه الفيلم.
[15] ألينا ستروماير، «حول إعادة تكوين الفضاءات الإعلامية السينمائية: من سينما الشتات إلى سينما ما بعد الشتات» (On the Re-Configurations of Cinematic Media-Spaces: From Diaspora Film to Postdiaspora Film)، في: إعادة التكوين: وضع عمليات التحول والأزمات المستمرة في سياقها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Re-Configurations: Contextualising Transformation Processes and Lasting Crises in the Middle East and North Africa)، تحرير رشيد عويسة، وفريدريكه بانفيك، وألينا ستروماير (منشورات سبرينغر، 2021)، 226، https://doi.org/10.1007/978-3-658-31160-5_14.
[16] أعتمد هنا على علم تأويل الأفلام (Film Hermeneutics) لألبيرتو باراكو، وهي استراتيجية منهجية لتفسير الفيلم. ويتمثل علم تأويل الأفلام لباراكو في قراءة تتنقل جيئة وذهابًا بين أفق المشاهد و«أفق النص السينمائي»، مضيفةً طبقات «لا متناهية» من المغزى والفهم للفيلم. للمزيد، انظر: ألبيرتو باراكو، تأويل عالم الفيلم: منهج ريكوري لتفسير الفيلم (Hermeneutics of the Film World: A Riceurian Method for Film Interpretation) (منشورات بالغريف ماكميلان تشام، 2017)، https://doi.org/10.1007/978-3-319-65400-3.
[17] يعتمد اقتصاد إيران على النفط؛ فهو القطاع الإنتاجي الوحيد الذي يُدر الدخل للبلاد.
[18] توجد شخصيات أخرى لم يتم الإشارة لأسمائها في الفيلم؛ فهناك الفتى الصغير (Milad Eghbali)، الذي يؤدي دور المتفرج البريء الذي يشهد كل المظالم في «المدينة الآثمة»، والذي تتعمد «الفتاة» إخافته لردعه عن التورط في مثل هذه المظالم مستقبلًا. وهناك أيضًا امرأة متحولة جنسيًا نراها ترقص وحدها بالبالون. ولأغراض هذه الدراسة، لن أركز على هذه الشخصيات.
[19] في ذلك الوقت، كانت سلالة القاجار (التي سبقت سلالة بهلوي) مدينة بالكثير للغرب. فقد دأب ملوك القاجار على الاقتراض بكثافة من القوى الأوروبية، لا سيما روسيا وبريطانيا، لتغطية التكاليف الإدارية والنفقات الشخصية.
[20] كحال معظم البلدان الغنية بالنفط و/أو السلع الاستراتيجية الأخرى، أزعم أن الانقلاب في إيران كان بسبب النفط. ولسوء الحظ، فإن انقلاب عام 1953 الذي دعمته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز الاستخبارات البريطاني ضد رئيس الوزراء الإيراني الراحل محمد مصدق، الذي أمم النفط الإيراني بعد سنوات من الاستغلال البريطاني، قد أعاد الشاه إلى السلطة وضمن السيطرة الغربية –ومعظمها أمريكية– على هذا المورد الطبيعي.
[21] ليلى أحمد، «المرأة والجندر في الإسلام» (Women and Gender in Islam)، 152. هذا مصطلح تستخدمه أحمد، ووفقًا لها فإنها ترى أن «أطروحة الخطاب الكولونيالي الجديد للإسلام تمحورت حول النساء… وكان الإسلام قمعيًا للمرأة، وكان الحجاب هو التعبير عن التخلف الشامل للمجتمع الإسلامي».
[22] على سبيل المثال، انتفاضة التبغ الجماهيرية ضد امتياز التبغ البريطاني عام 1890-1892. إذ كانت النساء الإيرانيات، يرتدين الشادور، في طليعة الوعي الوطني الإيراني يناضلن من أجل سيادتهن. للاطلاع على تفاصيل وافية، انظر: أندريه فوجل، «مصدر التغيير في المجتمع: مسح موجز لحركات المرأة الإيرانية الحديثة» (The Source of Change Within Society: A Brief Survey of Modern Iranian Women’s Movements)، المجلة الجامعية للمواطنة العالمية 2، العدد 4 (2018)، 13، تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2025، https://digitalcommons.fairfield.edu/jogc/vol2/iss4/2/. إلى جانب ذلك، شهدت البلاد ثورات إصلاحية أخرى تنادي بالاستقلال في محافظات جيلان، وأذربيجان، وخراسان بعد الحرب العالمية الأولى، وانتفاضات في أذربيجان وكردستان بعد الحرب العالمية الثانية، وحركة تأميم النفط التي حظيت بدعم شعبي بقيادة مصدق (الذي حكم البلاد من 1951 إلى 1953)، والمظاهرات الشعبية المناهضة للحكومة في أوائل ستينيات القرن الماضي، وقد انطوت جميعها، بدرجات متفاوتة، على جهود لإنهاء السيطرة الأجنبية على الاقتصاد الإيراني وبناء دولة مستقلة. للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر: نيكي ر. كيدي، «الثورات الإيرانية من منظور مقارن» (Iranian Revolution in Comparative Perspective)، المجلة التاريخية الأمريكية، 580.
[23] تتمثل الفرضية العامة لنظرية التبعية في أن الدول النامية تُثري الدول المتقدمة بمواردها الخاصة وعلى حسابها. وقد طُوِّرت نظرية التبعية رسميًا في أواخر ستينيات القرن الماضي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وكانت بمثابة رد فعل على نظرية التحديث، وهي نظرية سابقة في التنمية تفترض أن التقدم تقوده الدول المتقدمة، ولكن هذا التقدم في الواقع يرتكز على استغلال الدول المتأخرة.
[24] وزارة الخارجية الأمريكية، خطة العمل الشاملة المشتركة (Joint Comprehensive Plan of Action)، تم الاطلاع عليها في 21 أكتوبر 2025، http://2009-2017.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa.
[25] قبل الثورة الدستورية، كان يوجد نظام مزدوج للسلطة في المجتمع الإيراني التقليدي، إذ كانت سلطة الآباء الآخرين (من رجال الدين والقبائل والأعيان المحليين، بمن فيهم الأمراء وغيرهم من حكام المقاطعات) يراقبون السلطات الموروثة للملك في بعض الميادين.
[26] في ذلك الوقت، كانت إيران [التي كانت آنذاك تحت حكم السلالة القاجارية] تخضع على نحو متزايد للتغلغل الاقتصادي الغربي وهيمنة بريطانيا العظمى وروسيا. للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر: نيكي ر. كيدي، «الثورات الإيرانية من منظور مقارن» (Iranian Revolutions in Comparative Perspective)، 580.
[27] في الأصل، يشير مصطلح «الحريم» إلى ذلك القسم من المنزل الذي تعيش فيه زوجات القائد المسلم. للمزيد، انظر: «رحلات إسلامية | البند رقم 238: الحريم وفقًا لأكسفورد للدراسات الإسلامية أونلاين» (Muslim Journeys | Item #238: Harem’ from Oxford Islamic Studies Online)، (15 مارس 2025)، تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2025، http://bridgingcultures-muslimjourneys.org/items/show/238. مع ذلك، صوّر المؤلفين الغربيين الحريم في نهاية المطاف كفضاء للقمع المطلق تكون فيه النساء مسلوبات الإرادة ويتم تشييئهن بالكامل؛ للمزيد، انظر: ناتاشا بهارج وبيتر هيجارتي، «نقد نسوي ما بعد كولونيالي لتشابهات الحريم في علم النفس» (A Postcolonial Feminist Critique of Harem Analogies in Psychological Science)، مجلة علم النفس الاجتماعي والسياسي 3، العدد 1 (2015)، 259، https://doi.org/10.5964/jspp.v3i1.133.
[28] حميدة صدقي، النساء والسياسة في إيران: الحجاب، والسفور، والعودة لارتداء الحجاب (Women and Politics in Iran. Veiling, Unveiling and Reveiling)، (منشورات جامعة كامبريدج، 2007)، 43، تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2025، https://doi-org/10.1017/CBO9780511510380.
[29] أعلنت السلطة الدينية، بقيادة آية الله فضل الله نوري (خميني عصره)، أن هذه المطالب جزء من مؤامرة لاجتثاث الإسلام من البلاد. فقد أصدر فتوى دينية ضد مدارس الفتيات، وأعلن أن هذه المدارس وتعليم المرأة بشكل عام يتعارضان مع الشريعة الإسلامية.
[30] بوباك ترافيشي، «النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة: تاريخ رحلة المرأة الإيرانية في القرن الماضي» (The Struggle for Freedom, Justice, and Equality: The History of the Journey of Iranian Women in the Last Century)، (أطروحة ماجستير، جامعة لويزفيل، 2010)، 8، تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2025، https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1928&context=etd.
[31] صدقي، النساء والسياسة في إيران، 25.
[32] هوما هودفر، «الحجاب في عقولهم وفوق رؤوسنا: ممارسات الحجاب والنساء المسلمات» (The Veil in Their Minds and on Our Heads: Veiling Practices and Muslim Women)، في: النساء والجندر والدين: قراءات (Women, Gender, Religion: A Reader)، تحرير إي. إيه. كاستيلي (منشورات بالغريف ماكميلان، 2001)، 429، https://doi.org/10.1007/978-1-137-04830-1.
[33] فيروزة كاشاني-ثابت، «المعركة الأخرى: حق المرأة في الاقتراع وتأميم النفط الإيراني» (The Other Fight: Women’s Suffrage and Iran’s Oil Nationalization)، المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط 56، العدد 2 (2024): 272، https://doi.org/10.1017/S0020743824000576.
[34] المرجع السابق.
[35] المرجع السابق.
[36] إحسان حنيف، «كتابات الحيّز المنزلي: تأريخ قصتين مُغيَّبتين من قصص الحداثة لكاتبات إيرانيات» (Writing Domesticity: Historicising Two Silenced Stories of Modernisation by Iranian Women Writers)، في: البقاء مع الحداثة؟ (فك) تشابك الكولونيالية والعمارة (Staying with Modernity? (Dis)Entangling Coloniality and Architecture) ، (مركز دراسات جاب باكيما، 2024)، 59-60، تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2025، https://philpapers.org/archive/HANWDH.pdf.
[37] المرجع السابق.
[38] المرجع السابق.
[39] صدقي، «النساء والسياسة في إيران»، 101. وأشارت دراسة أخرى إلى أن التكتل كان يتألف من كبرى شركات النفط، بما في ذلك شركة النفط الأنجلو–فارسية المعروفة الآن باسم بريتيش بتروليوم (BP)، بحصة أربعين بالمائة، ومُنحت شركة رويال داتش شل أربعة عشر بالمائة، واستحوذت كل من جيرسي، وتكساس، وسوكال، وجالف، وسوكوني على سبعة بالمائة لكل منها، بينما حصلت شركة البترول الفرنسية (CFP) على ستة بالمائة، وذهبت الخمسة بالمائة المتبقية إلى العديد من شركات النفط الأمريكية الخاصة. وقدّر التكتل حصة إيران على أساس تقاسم الأرباح مناصفة (50-50)، وهو ما استمر حتى أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي. للاطلاع على المزيد من تفاصيل، انظر: سيروس بينا، «نفط إيران، ونظرية الريع، وظل التاريخ الطويل: تحفظات بشأن عقود النفط في الجمهورية الإسلامية» (Iran’s Oil, the Theory of Rent, and the long Shadow of History: A Caveat on Oil Contracts in the Islamic Republic)، في: الاقتصاد السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية (L’économie politique de la République islamique d’Iran)، تحرير آن لو نايو، وتانيا أنجيلوف، وروزر كوسو، وبيير جانين (منشورات السوربون، 2017)، 63-90، تم الاطلاع عليه في 20 أكتوبر 2025، https://www.jstor.org/stable/e26452353.
[40] أندريه فوجل، «مصدر التغيير في المجتمع: مسح موجز لحركات المرأة الإيرانية الحديثة» (The Source of Change Within Society: A Brief Survey of Modern Iranian Women’s Movements)، المجلة الجامعية للمواطنة العالمية 2، العدد 4 (2018)، 7، تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2025، https://digitalcommons.fairfield.edu/jogc/vol2/iss4/2.
[41] صدقي، النساء والسياسة في إيران، 128.
[42] ترافيشي، النضال من أجل الحرية، 3.
[43] ويمكن إرجاع ذلك إلى أزمة الرهائن عام 1979، حين احتجز طلاب إيرانيون دبلوماسيين أمريكيين من السفارة الأمريكية في طهران.
[44] ميلودي فهميراد، «الاتفاق الإيراني: كيف يضع التنفيذ القانوني للاتفاق الولايات المتحدة في وضع غير مؤات سواء اقتصاديًا أو فيما يتعلق بالتأثير على مستقبل المعاملات التجارية الإيرانية» (The Iran Deal: How the Legal Implementation of the Deal puts the United States at a Disadvantage both Economically and in Influencing the Future of Iran’s Business Transactions)، مجلة نورث وسترن للقانون الدولي والأعمال، 37، العدد 2 (2017)، 305، تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2025، https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol37/iss2/4.
[45] إسلام عبد الباري ورشا الشوا، «العقوبات الاقتصادية كأداة للسياسة الخارجية: دراسة حالة للصراع بين إيران والغرب» (Economic Sanctions as a Foreign Policy Tool: A Case Study of the Iran West Conflict)، رسائل الهجرة 20، العدد 7 (2023)، 218، تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2025، https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/4392.
[46] إسلام عبد الباري ورشا الشوا، «العقوبات الاقتصادية كأداة للسياسة الخارجية»، 216.
[47] أوليفر بورسزيك، «العقوبات الدولية ضد إيران في عهد الرئيس أحمدي نجاد: تفسير صمود النظام» (International Sanctions against Iran under President Ahmedinejad: Explaining Regime Persistance)، ورقة عمل، المعهد الألماني للدراسات العالمية والمناطقية (هامبورج : GIGA، 2014، 2024)، تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2025، https://ciaotest.cc.columbia.edu/wps/giga/0034014/index.html.
[48] كالي روبنسون، «ما هو الاتفاق النووي الإيراني؟» (What is the Iran Nuclear Deal?)، مجلس العلاقات الخارجية، 27 أكتوبر 2023، تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2025، https://www.cfr.org/backgrounder/what-iran-nuclear-deal.
[49] و إلى حد كبير، يشبه هذا طموحات إيران العالمية الراهنة في برنامجها النووي، في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل عليها.
[50] بيتر ر. أوديل، «أهمية النفط» (The Significance of Oil)، مجلة التاريخ المعاصر 3، العدد 3 (منشورات سيج، 1968)، 93، تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2025، https://www.jstor.org/stable/259700.
Read this post in: English