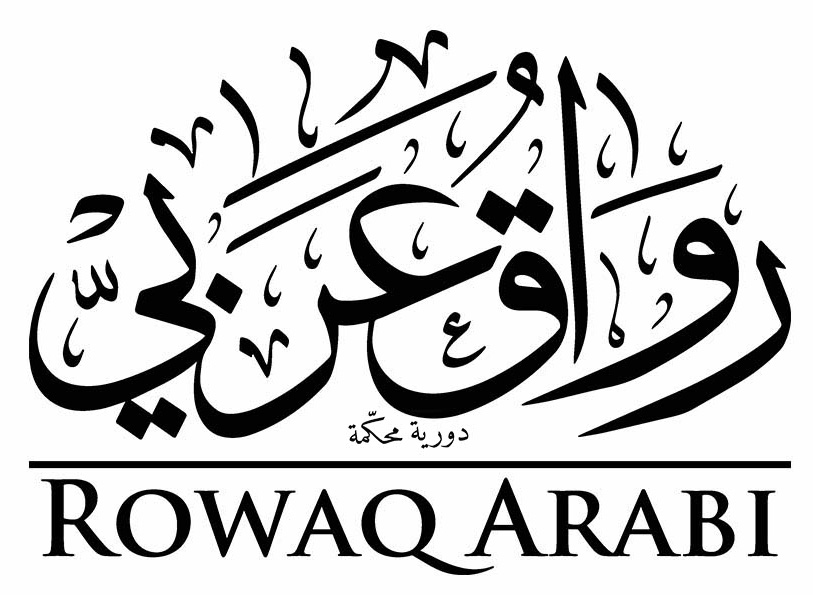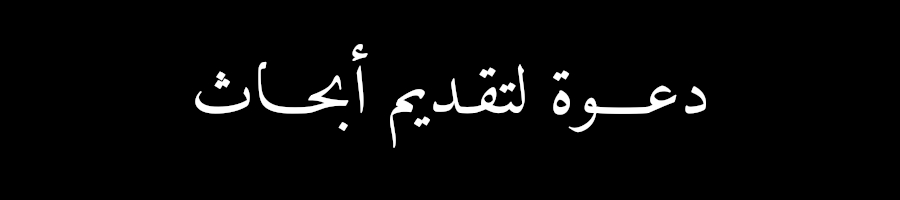رؤى: عقيدة الاستقرار الغربية الراسخة تجاه المنطقة العربية

الإشارة المرجعية: ناتاشا هول ويووست هلترمان. 2025. «رؤى: عقيدة الاستقرار الغربية الراسخة تجاه المنطقة العربية». رواق عربي 30 (3): 12-19. https://doi.org/10.53833/LWSE4512.
إن التنبؤ باستقرار الأنظمة السلطوية يعد أمرًا شاقًا؛ إذ أن الحكام المستبدون، بحكم طبيعتهم، يعرقلون التدفق الحر للمعلومات والأفكار. وقد كشفت الانتفاضات الشعبية العربية عام 2011 أن أنظمة الحكم نفسها قد لا تكون قادرة على الصمود، فيما تمتلك السلطوية بحد ذاتها القدرة على ذلك. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا؟
في عام 2011، أطاحت الاحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي بالعديد من الأنظمة السلطوية العربية التي كانت تبدو في السابق وكأنها حصينة ضد التغيير. وإلى جانب تبديدها وهم صمود الأنظمة الحاكمة، فقد شككت أيضًا فيما يُطلق عليه «نموذج الاستقرار» –وهو فكرة أن المصالح الجيوستراتيجية الغربية يتم تحقيقها على أفضل وجه من خلال دعم الحكام السلطويين.[1] وقد استندت تلك السياسة، التي تعود لعقود من الزمن، إلى مبدأ «شرٌ تعرفه أفضل من خيرٍ تجهله»؛ إذ رأت في هؤلاء الديكتاتوريين، الذين كان بعضهم وحشيًا بشكل لا يمكن وصفه تجاه رعاياهم، أنهم يمثلون الحاجز الوحيد الذي يقف بين الاستقرار والفوضى التي لا تُطاق. ولكن، حينما انهارت سيطرتهم نتيجة عجزهم عن خدمة مصالح شعوبهم، بات من الواضح أنهم كانوا أبعد ما يكونون عن المناعة.
بيد أن السلطوية برهنت أن قدرتها على الصمود تفوق قدرة بعض أنظمة الحكم ذاتها. فقد عادت مصر وتونس فعليًا إلى النادي السلطوي بعد مداعبة للسياسة التشاركية في أعقاب الاحتجاجات، وذلك في الوقت الذي استسلمت فيه الولايات المتحدة وأوروبا لمستبدي العصر الجديد الذين رأوا فيهم القدرة والرغبة في الحفاظ على مصالحهم الأساسية. في السياق نفسه، حشدت الدول المنتجة للنفط، في الخليج وأماكن أخرى، مواردها لتعزيز أجهزتها القمعية في مواجهة التهديد الشعبي، ووظفت في ذلك الدعم الخارجي الذي حرصت الدول الغربية على تقديمه من أجل الحفاظ على تدفق النفط. كما قدمت هذه الدول رعايتها أيضًا للحلفاء الذين لا يحظون بثروات طبيعية، مثل الأردن والمغرب، لضمان عدم انهيارهم ومنع تأثير الدومينو.
ولكن لم تتبع جميع الدول هذا المسار، فقد خرّبت الحروب الأهلية سوريا واليمن والسودان وليبيا وحولت تلك البلدان إلى أنقاض. فيما تركت الولايات المتحدة، في سياق سعيها المُلّح لنفض يدها من المنطقة العربية، الشركاء المحليين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتعاملان مع الفوضى وتحققان أهدافهما الخاصة، حتى عندما تسببت تدخلاتهم في جعل المنطقة أكثر اضطرابًا. عدم الاستقرار المزمن هذا خدم أيضًا أجندة إسرائيل، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، التي كانت تمتلك مصلحة دائمة في إبقاء أعدائها الحاليين والمحتملين منقسمين وضعفاء، إلى أن أضحت صفقات التطبيع مع الأنظمة السلطوية الطيّعة ممكنة. والنتيجة اليوم هي ما نراه من خليط فوضوي من الدول المنهارة والهشة والسلطوية.
سجل صمود الأنظمة
قبل عام 2011، بدت الدول العربية وكأنها تتمتع بقدرة استثنائية على البقاء. فقد أشرفت على جهاز شرطي واسع النطاق يتغلغل بعمق في مفاصل مجتمعاتها، جامعًا للمعلومات الاستخباراتية، ويغرس الخوف ومحبطًا للمعارضة المعلنة. كما استفادت الأنظمة من عقد اجتماعي ضمني مع رعاياها –أو ما يُعرف بــ «الصفقة السلطوية»– الذي وعد بتحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات من جانب الدولة مقابل الخضوع السياسي.[2] وفيما تمتعت الدول الغنية بالنفط –التي دعمها الغرب لفترة طويلة– بميزة خاصة في هذا العقد الاجتماعي؛ فقد اضطرت الدول الأكثر فقرًا، العاجزة عن تلبية التطلعات السياسية والاقتصادية لشعوبها، إلى الاعتماد على الدعم الخارجي من أجل الحفاظ على بقائها.
الأدبيات العلمية التي تناولت تلك الحقبة تُسلط الضوء على العوامل الكامنة وراء صمود الأنظمة. ولعل إيفا بيلين هي أفضل من لخص الأمر ببراعة؛ فقد عزَت «متانة» الأجهزة القمعية للأنظمة إلى مزيج من العوامل التي كان يجب توافرها: تدفقات دخل كافية للحفاظ عليها؛ ودعم دولي كبير؛ والمستوى المنخفض من مأسسة قوات الأمن؛ والتعبئة الشعبية الضعيفة.[3] متى ما فُقِد أي من هذه العوامل أو طرأ عليه تحوّل، يزداد خطر تعرّض النظام للتهديد.
في المنطقة العربية، كانت هذه العوامل قائمة إلى حد كبير. فالقوات الأمنية الأكثر سطوة في الأنظمة الملكية الخليجية كانت بمثابة الحرس الإمبراطوري الذي أُنشئ لحماية النظام، ويدين له بالولاء المطلق، وليست جيشًا محترفًا قائمًا على الجدارة ويحظى بثقة الجمهور. وشهدت الدول المنتجة للنفط أدنى حد من التعبئة الشعبية لأنها كانت قادرة على قمع، وحتى منع، المعارضة في شرارتها الأولى. كما أتاحت الثروة الناتجة عن الموارد استيعاب المعارضة المحتملة، من خلال التوظيف في القطاع العام وتوفير مختلف الإعانات الانتقائية.
في بقية المنطقة، كانت الصورة أكثر تعقيدًا. فالدولة كانت عاجزة بشكل متزايد عن توفير الوظائف والخدمات الأساسية، واعتمدت بشكل أكبر على أجهزتها القمعية لإبقاء المعارضة تحت السيطرة. فيما بحثت العديد من الفئات السكانية المهمشة والفقيرة عن الدعم خارج إطار الدولة –ووجدته غالبًا لدى المنظمات الدينية الشعبية التي تعمل على توزيع الصدقات. وفي هذا الحيز، ظهرت منظمات مثل الإخوان المسلمين، وبعد ذلك بكثير، حزب الله، الأمر الذي شكل تحديات هائلة للمؤسسات السياسية التقليدية في البلدان التي نشطت فيها –مصر ولبنان على التوالي– وأثارت خوف الأنظمة في جميع أنحاء المنطقة.
خارج مصر، تعد جماعة الإخوان شبكة إسلامية عالمية أكثر من كونها منظمة، وتتجلى من خلال صيّغ محلية، وليس فروع، يمتلك كل منها قيادته وأجندته الوطنية الخاصة، رغم أنه يُشار إليها جميعًا بشكل عام باسم «الإخوان». وفي السنوات التي سبقت الانتفاضات العربية، كانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أقوى حركة اجتماعية في المنطقة، إذ كانت تتمتع بالتنظيم الجيد وتتسم بالانضباط، وتحظى بدعم جماهيري حقيقي. وقد تدخلت حيثما غابت الدولة، لتقديم الخدمات الأساسية للناس الذين هم في أمس الحاجة إليها. وسمح لها نظام الرئيس حسني مبارك بالعمل كحركة خيرية طالما كانت بمنأى عن السياسة. وفي الأردن، سمحت الملكية الهاشمية للتجلّي المحلي للإخوان، وهو «جبهة العمل الإسلامي»، بالعمل سياسيًا، وحتى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، لكنها حرصت دائمًا على الحد من السلطة التي يمكن أن تكتسبها من خلال التلاعب بالنظام الانتخابي واستيعاب أعضائها. أما في اليمن (حزب الإصلاح) وتونس (حزب النهضة)، فقد تعرض الإخوان للقمع قبل عام 2011، لكنهم تمكنوا من ترسيخ أثرهم سرًا، وذلك من خلال الوعظ وتقديم الخدمات العامة في المناطق التي شهدت تقصير من الدولة.
وفي كل الأحوال، كان مصير أي محاولة من جانب الإخوان نحو التعبئة أو المشاركة السياسية الحقيقية، ومعها أي فرصة للتحول الديمقراطي، هو القمع السريع.[4] فبينما خضعت المؤسسات للمحاسبة، والمشاركة السياسية؛ فإن الانتخابات كانت تُعتبر التزامات متقلبة وغير مضمونة. وقد فضلت الولايات المتحدة تجنب عدم اليقين هذا، وكذلك فعلت إسرائيل وبعض دول الخليج، التي وجدت، بالإضافة إلى ذلك، صعوبة في تقبل إمكانية صعود الأحزاب الإسلامية أو أي أحزاب معارضة أخرى إلى السلطة.
نموذج استقرار راسخ
لقد عزز الخوف من الإخوان نموذج الاستقرار لدى الداعمين الخارجيين للأنظمة العربية. ولكن يمكن القول إن الولايات المتحدة وأوروبا والأنظمة العربية كانوا يخشون من حالة عدم اليقين التي يمكن أن تجلبها السياسة التشاركية الحقيقية أكثر من خشيتهم من الإخوان في حد ذاتهم، لكنهم اعتبروا الإخوان بمثابة القاطرة الأكثر ترجيحًا للتحول الديمقراطي في حالة انهيار النظام. وقد شهدت الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي مخاوف مماثلة بشأن القومية العربية والتيارات المختلفة من الاشتراكية (والتي غذتها أيضًا منافسات الحرب الباردة). وفي كل حالة، كانت الولايات المتحدة وشركاؤها يخشون من سياسة تشاركية لا يمكنهم السيطرة عليها. ومن ثم، فبينما كانت الولايات المتحدة تبالغ في الحديث عن الترويج للديمقراطية في العالم العربي؛ فإنها تجاهلت إلى حد كبير خطابها الخاص في هذا الصدد. فنفقاتها المكرّسة لتعزيز قوات أمن الأنظمة تجاوزت بكثير ما أنفقته على الأنشطة التي كان من الممكن أن تدفع الأنظمة السلطوية نحو سياسة تشاركية حقيقية، وسلطة قضائية قائمة على سيادة القانون، وإضفاء الطابع المهني على منظمات المجتمع المدني. وقد واصلت الولايات المتحدة إرسال قرابة 1.3 مليار دولار أمريكي من المساعدات العسكرية سنويًا إلى مصر.[5] وفيما كان يتم تخصيص بضعة ملايين إضافية لدعم المجتمع المدني؛ فإن الولايات المتحدة كانت تتشدق بالكاد بتلك المبادئ دون بذل جهد حقيقي لدعمها.
يُسلط دانيال بايسا وميلاني كاميت الضوء على أهمية المساعدات في إبقاء قادة معينين صامدين في مواقعهم، وذلك في سبع عشرة دولة في الشرق الأوسط خلال الفترة من عام 1962 وحتى عشية انتفاضات 2011. وباستخدام تقنيات التعلم الآلي اللامعلمية لإزالة تحيز الباحث، وجدا أن «المساعدات الخارجية، وخاصة الإقراض الميسر، حاسمة لصمود السلطوية، خاصة فوق عتبة معينة، وأن القمع والحرب الباردة والمنح الخارجية لها قوة تنبؤية ثانوية».[6]
وتدعم هذه النتائج حجتنا القائلة بأن المساعدات الخارجية وتمويل التنمية يمكن أن يكونا، وغالبًا ما يكونان، مخصصين لمساعدة القادة على البقاء. لنأخذ حالة الأردن كمثال؛ فالبلاد تعاني على الدوام من أزمة مالية، إذ لا تملك وسيلة لفرض ضرائب على الناس لإصلاح الخدمات الأساسية بشكل مجدٍ. ولتفادي الاحتجاجات الشعبية، يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة لإنقاذها ماليًا؛ إذ أن واشنطن لن تدير ظهرها للأنظمة الملكية العربية أو الأنظمة الأخرى التي وقعت معاهدات سلام مع إسرائيل أو طبَّعت علاقاتها معها بطريقة أو بأخرى. بيد أن مثل هذا الوضع يحمل مخاطره الخاصة، فقد دفع الرئيس المصري أنور السادات حياته ثمنًا لذلك. وعلى هذا النحو، يتوقع القادة العرب الحصول على دعم كبير في المقابل.
بمرور الوقت، انضمت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة وأوروبا في نهجهم القائم على مبدأ «الأمن والاستقرار أولًا»، إذ دعمت كل منهما، لأسبابها الخاصة، الجهود الرامية إلى كبح جماح قوة الإخوان، وفي نهاية المطاف، إخماد التطلعات التي أُطلق العنان لها خلال الثورات الشعبية.[7] إسرائيل أيضًا فضلت التعامل مع الأنظمة على الفوضى التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها في الدول المنخرطة في سياسة مفتوحة وانتخابات منتظمة –حتى وإن تضمن ذلك سوريا في عهد حافظ الأسد ومن بعده بشار الأسد. في واقع الأمر، تم الكشف بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 أن المخابرات الإسرائيلية تواصلت مع مسئولين رفيعي المستوى في نظام الأسد لسنوات عبر تطبيق واتساب، للتفاوض على صفقات سرية وإدارة قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي.[8]
بشكل عام، كانت الدول السلطوية تتعلم فعليًا من بعضها البعض وتتعاون في محاولة للبقاء. وقد تغلّبت حماسة الثورة المضادة على موجات الاحتجاجات في عملية انتشار سلطوي. يشير ستيفن هيدمان ورينود ليندرز إلى أن القادة في الشرق الأوسط راقبوا تكشُّف الأحداث في أعقاب الربيع العربي، «وأصبحوا مقتنعين بشكل متزايد بأن أفضل رهان لهم يكمن في استراتيجيات القمع، وفي جوهر الأمر، في الانكفاء على الذات واتباع مجموعة من التدابير اللازمة للنجاة من الانتفاضات».[9]
الولايات المتحدة المتقلبة والواهنة
في مواجهة منطقة عربية مضطربة، بدت إدارة أوباما في البداية مستعدة للتخلي عن نموذج الاستقرار الذي طالما حدد مقاربتها إزاء المنطقة. لكن سرعان ما تبددت تصريحاتها الأولية الداعمة للتغيير الديمقراطي في المنطقة. فقد سايرت التغييرات الدراماتيكية في تونس ومصر، لكنها في الحالات الأخرى أخذت موقف المتفرج، وبدت وكأنها تترك الشركاء الإقليميين يفعلون ما يروق لهم، وعادة ما كان ذلك داعمًا للقادة السلطويين. وعندما لم يتمكن سلطوي واحد من الظهور لاحتكار استخدام العنف، سارعت هذه القوى الإقليمية بإشعال حروب بالوكالة لمساندة رجل قوي من اختيارها. فقد أرسلت المملكة العربية السعودية والإمارات قوات مجلس التعاون الخليجي إلى البحرين لخنق الانتفاضة الشعبية؛ وساعدتا في التحريض على انقلاب عسكري ضد محمد مرسي، رئيس مصر المنتخب شعبيًا من بين صفوف الإخوان؛ وغزتا اليمن في محاولة لقمع الحوثيين أو على الأقل احتوائهم (بعد أن ساعدتا في البداية على خلع الديكتاتور علي عبد الله صالح، لصالح حكومة انتقالية). كما عمدت الإمارات لتسليح وكلائها المختارين في ليبيا والسودان، وقادت لاحقًا الطريق في تطبيع العلاقات مع بشار الأسد في سوريا.
وبينما لم تُبد الولايات المتحدة أي رغبة في دعم ما كان ينبغي أن يُمثّل المرحلة التالية بعد سقوط الأنظمة، وهو المساعدة في بناء أنظمة سياسية جديدة تتمتع بدعم شعبي واسع وقائمة على عقد اجتماعي جديد؛ فقد امتنعت عن التدخل المباشر في الصراعات السياسية في ليبيا، في الوقت الذي سارعت فيه فرنسا وإيطاليا ودول أخرى لتنظيم حكم البلاد في مرحلة ما بعد القذافي، وهو جهد باء بالفشل الذريع.[10]
رأت إدارة أوباما أن تبتعد تمامًا عن الموقف، في الوقت الذي أخذت فيه كلٌّ من المملكة العربية السعودية والإمارات على عاتقهما دعم الجيش المصري للإطاحة بالرئيس مرسي واسترداد السيطرة على زمام الأمور عام 2013. وقد وصل تجنّب الإدارة الأمريكية إلى عدم استخدام مصطلح «انقلاب عسكري» عند الإشارة لاستيلاء الجنرال عبد الفتاح السيسي على السلطة، خشية أن يستدعي ذلك الاعتراف قطع مساعداتها العسكرية السنوية الكبيرة لمصر بموجب القانون الأمريكي.[11] التمرد الوحيد الذي دعمته هو الجهد الشعبي لإسقاط نظام الأسد في سوريا، والذي من الجليّ أنه لم يكن صديقًا لواشنطن. ولكن حتى في هذه الحالة، اتسم دعمها، أولًا للشعب في الشوارع ثم للمجموعة الواسعة من فصائل المتمردين، بالفتور؛ إذ ثبت أن عدم اليقين بشأن سيناريوهات اليوم التالي كان مربكًا للغاية، خاصة بعد تجربة ليبيا. وفي النهاية، لم تحتل سوريا مرتبة عالية في المصالح الجيوستراتيجية الأمريكية؛ فقد كانت الإدارة راضية تمامًا عن ترك الأسد في مكانه، فيما كانت منغمسة في محاربة الجماعات الجهادية ذات الأجندات العابرة للحدود الوطنية.
علاوة على ذلك، وبسبب تجربتها المريرة في العراق وحيرتها أمام التغيرات السريعة في العالم العربي، بدأت الولايات المتحدة تتجنب التدخل الفعلي في المنطقة في الوقت الذي بدأت فيه بالتركيز على صعود الصين منافسها الأساسي كقوة عظمى. وقد غذت الضغوط الداخلية أيضًا هذا التحول في المقاربة، في ظل تنامي قوة قاعدة جماهيرية شعبوية تتبنى شعار «أمريكا أولًا»، الأمر الذي بلغ ذروته بفوز دونالد ترامب في نوفمبر 2016. وفي محاولة لتقليص وجودها العسكري في الخارج، واصلت الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب تمسكها بمقاربة الاستقرار؛ لاعتقادها بأن الرجال الأقوياء قد يشكلون حصنًا ضد الصراع المحتدم في معظم أنحاء المنطقة. ولكن «نموذج صفقات النخبة» في الدبلوماسية، حسبما أوضح الخبراء في تشاتام هاوس، فشل في معالجة دوافع الصراع.[12] وكانت قضايا التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان تتلاشى شيئًا فشيئًا حتى من الأجندة الخطابية.
وقد عجّل الرئيس ترامب هذا التوجه خلال فترة ولايته الأولى؛ إذ سارع لإظهار ميوله السلطوية من خلال احتضانه للزعيم المصري الذي نصب نفسه، عبد الفتاح السيسي، والتودد لحكام الخليج المستبدين سعيًا وراء صفقات تجارية مربحة. في الوقت نفسه، أضحى النهج الأمريكي تجاه المنطقة متقلبًا، إذ تعهد ترامب بدعم المملكة العربية السعودية ضد إيران، لكنه لم يحرك ساكنًا حينما هاجمت إيران منشآت نفطية سعودية في سبتمبر 2019. (وقد أعلن الحوثيون في اليمن مسئوليتهم عن الهجوم). وردًا على ذلك، ورغم الارتياح الذي أبداه ترامب علنًا تجاه الرجال الأقوياء؛ بدأ العديد من القادة العرب في تطوير سياسات تأمين أكثر جرأة. ففيما سعت بعض دول الخليج إلى تحقيق انفراجة مع إيران لحماية نفسها من التداعيات المحتملة لمواجهة أمريكية إسرائيلية مباشرة مع الجمهورية الإسلامية؛ فإنها عملت في الوقت ذاته على دعم الديكتاتور أو أمير الحرب الذي تفضله في بلدان أخرى. ولم تستخدم الولايات المتحدة رأسمالها السياسي للحيلولة دون استمرارهم في ذلك، مُفضلّة اتباع نهج «عدم التدخل» مع حلفائها وشركائها.
لكن ما أنجزه ترامب فعليًا هو لم شمل بعض حلفاء الولايات المتحدة وشركائها معًا، وهو ما بلغ ذروته فيما يسمى بـ «الاتفاقيات الإبراهيمية». فبتسهيل من إدارة ترامب، وقّعت الإمارات والبحرين اتفاقيات «تطبيع» مع إسرائيل في حديقة البيت الأبيض في سبتمبر 2020، ولحق بهما فيما بعد المغرب والسودان. وكانت هذه الاتفاقيات بمثابة مواثيق سلطوية، لا تتضمن فقط تعزيز العلاقات التجارية، وإنما أيضًا تبادل تكنولوجيا المراقبة المستخدمة لكشف المعارضة وقمعها. كما استهدفت أيضًا إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق تسويته لصالح إسرائيل وتهميش الفلسطينيين.
ورغم تصدع الأنظمة في جميع أنحاء المنطقة العربية؛ ظل نموذج الاستقرار راسخًا في الإدارة الديمقراطية التي جاءت بعد ذلك. فحينما أصبح جو بايدن رئيسًا، تبنى بحماس فكرة التطبيع العربي الإسرائيلي. فبينما وصف بايدن، حينما كان مرشحًا رئاسيًا، ولي العهد محمد بن سلمان بـ«المنبوذ» لدوره في مقتل الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة والمطلع السابق على شئون البلاط السعودي، جمال خاشقجي؛ عاد بايدن بصفته رئيسًا لاحتضان الزعيم السعودي الفعلي. وفي الوقت نفسه، نأت الإدارة بنفسها بشكل متزايد عن الصراعات في سوريا وليبيا واليمن، وكذلك عن النضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير والثورة الشعبية السودانية. وكانت الإدارة وحلفاؤها مقتنعين تمامًا بهذا النهج لدرجة أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أدلى بتصريح شائن في نهاية سبتمبر 2023 بأن الشرق الأوسط بات «أكثر هدوءً» مما كان عليه قبل عقدين، في الوقت الذي يستمر فيه الصراع والفساد في التهام جزء كبير من المنطقة.[13] وبعد ثمانية أيام فقط من تصريحاته العلنية، هاجمت حماس إسرائيل، مما أثار رد فعل إسرائيلي مدمر، شمل هجمات على سبع دول.
كان من الممكن أن يكون ذلك بمثابة المسمار الأخير في نعش الاعتقاد القائل بإمكانية التغلب على دوافع الصراع من خلال إبرام الصفقات بين النخب، ولكن الأمر لم يكن كذلك. إذ مضت الولايات المتحدة قدمًا في نهجها، وما زالت تسترشد بنموذج الاستقرار. وفي الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن، حاولت الولايات المتحدة بشكل محموم تأمين اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي بينما كان الهجوم الإسرائيلي على غزة مستعرًا.
في مواجهة مستقبل غامض
رغم الوعود التي حملتها الانتفاضات العربية؛ لا تزال المنطقة اليوم تتألف من دول عاجزة عن تلبية التطلعات السياسية، بل والاقتصادية في معظم الأحيان، لشعوبها. وقد تزايدت حدة ردة الفعل من جانب القادة السلطويين والجهات الفاعلة الدولية ضد حركات التغيير هذه. فقد استخدم قادة، من الرئيس رجب طيب أردوغان في تركيا إلى قيس سعيد في تونس، سيطرتهم على طرق الهجرة إلى أوروبا لإحباط الإدانة الدولية لتكتيكاتهم السلطوية المتزايدة، والتربح هذه العملية. وقد تمكن السيسي في مصر من النجاة، ويمكن القول إنه أصبح أكثر قمعًا من سلفه مبارك، وذلك بمساعدة الولايات المتحدة والخليج.[14]
من ناحية أخرى، انخرطت دول الخليج العربية التي طبَّعت علاقاتها مع إسرائيل، بشكلٍ غير مُقيَّد في صراعات السودان وليبيا واليمن ومناطق أخرى. وحتى في الوقت الذي أكد فيه هجوم السابع من أكتوبر والربيع العربي حماقة هذا النهج، فوَّضت الولايات المتحدة، على نحو متصاعد، بعض جوانب سياستها في الشرق الأوسط إلى إسرائيل، وهي دولة تسعى إلى ترسيخ أنظمة سلطوية مُذعنة أو دول فاشلة لا يمكن أن تشكل تهديدًا حقيقيًا لأهدافها التوسعية في الضفة الغربية وغزة وغيرهما. ونتيجة لهذا التفويض المفتوح، ذهبت إسرائيل إلى ما هو أبعد بكثير مما بدت الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذه، دونما تواجه مقاومة حقيقية. فقد دمرت غالبية غزة وجنوب لبنان؛ وحطمت استراتيجية الدفاع المتقدم الإيرانية، وقضت على العديد من قادتها السياسيين والعسكريين، وجزءًا كبيرًا من قدراتها النووية؛ وشنت على سوريا أكثر من ثمانمائة غارة جوية دمرت قدرتها العسكرية، واحتلت أراضٍ إضافية في جنوبها، وحاولت تعميق الانقسامات العرقية والطائفية.
ورغم أن إدارة ترامب كانت تهدف في البداية إلى إنهاء الحرب في غزة، وأعربت عن دعمها لسوريا الجديدة تحت قيادة أحمد الشرع؛ إلا أنها سمحت لإسرائيل باتخاذ مسار مختلف، فقد قبلت بحجج نتنياهو الداعمة لمواصلة الحرب في غزة، بل إن ترامب نفسه اقترح استيلاء الولايات المتحدة على القطاع الصغير لإنشاء «ريفييرا» جديدة. كما غضت إدارة ترامب الطرف عن هجمات إسرائيل المستمرة في سوريا وإيران ولبنان.
لقد استوعب القادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط المشهد، وباتوا أكثر جرأة في قمع التهديدات الحقيقية أو المتصورة محليًا ودوليًا. فقد قمع كل من السيسي وسعيد شخصيات المعارضة بينما يواصلان تلقي المساعدات الإقليمية والدولية. أما بالنسبة للشرع، فلا يزال غير واضح ما إذا كان سيعمل، في إطار سعيه لترسيخ سلطته، على تشجيع الحكم الشامل أم تثبيطه.
وفي خضم هذا الإحياء الاستبدادي، عزز التعاون بين القادة السلطويين وإسرائيل من قدرة هذه الدول على عرقلة التغيير السياسي وتعزيز قبضتها على السلطة. كما أتاح لهذه الدول التدخل في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات كما يحلو لها، إذ تتنافس كل منها لدعم رجلها القوي –من سوريا إلى السودان وليبيا. وقد جعل هذا الأمر سماع أصوات المجتمع المدني أمر بالغ الصعوبة، في الوقت الذي تنادي فيه بإعادة الإعمار والحوكمة التي تخدم غالبية الناس، وإتاحة التعبير عن المعارضة عندما تخفق الحكومة في تلبية الاحتياجات والتطلعات المجتمعية والسياسية والاقتصادية.
استقرار ظاهري بتكلفة باهظة
في عالم فوضوي متعدد الأقطاب، تبدو الجهات الفاعلة الدولية أكثر استعدادًا للتنصل من الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والديمقراطية سعيًا وراء الاستقرار الفوري الذي تنشده من خلال الرجال الأقوياء. ورغم ذلك، فإن المحفزات الأساسية التي أفضت إلى اندلاع الربيع العربي لا تزال باقية أو زادت حدتها. إذ تزداد ندرة المياه، فيما بلغت البطالة والفقر مستويات غير مسبوقة خارج دول الخليج الغنية بالنفط، فيما يشهد انعدام الثقة في الحكومات تزايدًا نتيجة سنوات من الصراع السياسي والاقتصادي. ومن المتوقع أن تشهد بعض الأماكن الأكثر انعدامًا للأمن المائي في المنطقة، مثل سوريا واليمن والعراق، زيادة في عدد سكانها بنسبة ثمانين بالمائة بحلول عام 2050.[15] فيما لا تزال الخدمات الأساسية مثل الكهرباء تعاني من تردٍّ شديد حتى في البلدان الغنية بالطاقة مثل العراق.
إن أوان التغيير السياسي قد حان منذ أمد بعيد، ولكن القادة داخل المنطقة وخارجها أتقنوا كيفية مقاومة هذا التغيير باعتبارها الضمانة الأفضل لاستمرارهم في السلطة. ويستخدم الكثيرون تكنولوجيا المراقبة والدعم الدولي لإخماد المعارضة قبل وصولها إلى الشوارع. ومن المغري التكهن بأن النزعة السلطوية ستسود في مثل هذا العصر، لا سيما إذا استمر نموذج الاستقرار يمثل استراتيجية راسخة للولايات المتحدة والقوى الإقليمية. ومع ذلك، فقد كشفت السنوات الخمس عشرة الماضية أيضًا عن الهشاشة المتأصلة في مثل هذه الأنظمة. كما برهنت الثورات الشعبية في 2011 و2019 على أن أي تحديات شعبية جديدة للوضع الراهن الحرج يمكن لها أن تقوض بشكل خطير الأنظمة القائمة في منطقة شهدت نصيبها العادل من التغييرات المزعزعة للاستقرار في العامين الماضيين. ولا يمكن لأحد التكهن بما إذا كانت مثل هذه السيناريوهات ستتحقق أثناء العقد القادم أم لا. ولكن لا يمكن الشك في أن إخفاق الأنظمة في معالجة المظالم الشعبية ودوافع الصراع سيجعل الحكم الاستبدادي مهنة محفوفة بالمخاطر بشكل لا لبس فيه.
بيان الاستعانة بالذكاء الاصطناعي: لم يتم استخدام أي أدوات ذكاء اصطناعي في البحث وصياغة هذا المقال.
هذا المقال كتب في الأصل باللغة الانجليزية لرواق عربي.
[2] إيفا بيلين، «إعادة النظر في مناعة السلطوية في الشرق الأوسط: دروس من الربيع العربي» (Reconsidering the Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Lessons from the Arab Spring)، مجلة السياسة المقارنة المجلد 44، العدد 2 (يناير 2012)، 138، تم الاطلاع عليه في 6 أغسطس 2025، https://www.jstor.org/stable/23211807.
[3] إيفا بيلين، «مناعة السلطوية في الشرق الأوسط: الاستثناء من منظور مقارن» (The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in Comparative Perspective)، مجلة السياسة المقارنة المجلد 36، العدد 2 (يناير 2004)، 139-157، تم الاطلاع عليه في 6 أغسطس 2025، https://www.jstor.org/stable/4150140.
[4] تُعد حركة الإخوان عمومًا حركة سلمية. وفي فلسطين وحدها طورت الحركة جناحًا مسلحًا، وهو حماس، الذي استخدم العنف في إطار السعي لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
[5] هيومن رايتس ووتش، «مصر: الإدارة الأمريكية تسقط الشروط الحقوقية من المساعدات العسكرية» (Egypt: US Waives Human Rights Conditions on Military Aid) ، 13 سبتمبر 2024، تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2025، https://tinyurl.com/yc8aecvy.
[6] دانيال بايسا وميلاني كاميت، «الدعم الخارجي والسلطوية المستمرة في الشرق الأوسط» (External Support and Persistent Authoritarianism in the Middle East)، شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، 22 يناير 2023، تم الاطلاع عليه في 3 سبتمبر 2025، http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4015909.
[7] لدى الإمارات حساسية مفرطة تجاه أي شيء تفوح منه رائحة الإسلام السياسي، لا سيما في صيغته المنظمة كما هو الحال مع الإخوان، وقد قمعت بنشاط النسخة المحلية من الإخوان في الداخل. فيما ترى إسرائيل أن دعم الإخوان يعزز من حظوظ حماس، رغم أنها هي نفسها من دعمتهم في الماضي حينما كان الإخوان في الضفة الغربية وخاصة غزة لا يزالون في طور النشوء في الثمانينيات، وكان عدو إسرائيل الأساسي آنذاك هو منظمة التحرير الفلسطينية وأكبر فصائلها، فتح.
[8] جاي ليرون، «هدية غير متوقعة: إسرائيل وسقوط نظام الأسد» (An Unexpected Gift: Israel and the Fall of the Assad Regime)، مركز ويلسون، 14 يناير 2025، تم الاطلاع عليه في 3 سبتمبر 2025، https://www.wilsoncenter.org/article/unexpected-gift-israel-and-fall-assad-regime.
[9] ستيفن هيدمان ورينود ليندرز، «التعلم السلطوي والصمود السلطوي: استجابات الأنظمة لـ«الصحوة العربية» (Authoritarian Learning and Authoritarian Resilience: Regime Responses to the ‘Arab Awakening’)، في كتاب الثورات العربية وتحولات العالم (Arab Revolutions and World Transformations)، تحرير آنا أجاثانجيلو ونيفزات سوغول، (لندن: روتليدج، 2013)، تم الاطلاع عليه في 5 سبتمبر 2025، https://shorturl.at/NBCrN.
[10] جيفري جولدبرج، «مستشار أوباما السابق لشئون الشرق الأوسط: كان يجب أن نقصف الأسد» (Obama’s Former Middle East Adviser: We Should Have Bombed Assad)، مجلة ذا أتلانتيك، 20 أبريل 2016، تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2025، https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/04/philip-gordon-barack-obama-doctrine/479031/.
[11] تيري جروس، «بين أيدي الجنود: استكشاف كيف ساهمت الولايات المتحدة في الفوضى في مصر» (Into the Hands of Soldiers’ Explores How the US Contributed to Chaos in Egypt)، الإذاعة الوطنية الأمريكية العامة NPR، 7 أغسطس 2018، تم الاطلاع عليه في 3 سبتمبر 2025، https://www.npr.org/2018/08/07/636254979/america-s-role-in-deposing-the-first-democratically-elected-president-of-egypt.
[12] ريناد منصور وتيم إيتون، «إعادة التفكير في التسويات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» (Rethinking Political Settlements in the Middle East and North Africa)، تشاتام هاوس، 20 سبتمبر 2023، تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2025، https://www.chathamhouse.org/2023/09/rethinking-political-settlements-middle-east-and-north-africa/02-elite-bargains.
[13] جال بيكرمان، «الشرق الأوسط أكثر هدوءً اليوم مما كان عليه قبل عقدين» (‘The Middle East Region is Quieter Today Than It Has Been in Two Decades)، ذا أتلانتيك، 7 أكتوبر 2023، تم الاطلاع عليه في 3 سبتمبر 2025، https://www.theatlantic.com/international/archive/2023/10/israel-war-middle-east-jake-sullivan/675580/. لاحظ أن تاريخ النشر هو يوم هجوم حماس، الذي قضى على أي هدوء وهمي كان قائمًا حتى ذلك الحين.
[14] السفارة الأمريكية في القاهرة، «الولايات المتحدة تعلن عن استثمار بقيمة 129 مليون دولار في تنمية مصر خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر» (United States Announces $129 Million Investment in Egypt’s Development During US-Egypt Strategic Dialogue) ، 19 سبتمبر 2024، تم الاطلاع عليه في 3 سبتمبر 2025، https://eg.usembassy.gov/united-states-announces-129-million-investment-egypt-development/.
[15] ناتاشا هول، «البقاء على قيد الحياة في ظل الندرة: المياه ومستقبل الشرق الأوسط» (Surviving Scarcity: Water and the Future of the Middle East)، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، 22 مارس 2024، تم الاطلاع عليه في 1 أكتوبر 2025، https://features.csis.org/surviving-scarcity-water-and-the-future-of-the-middle-east/.
Read this post in: English