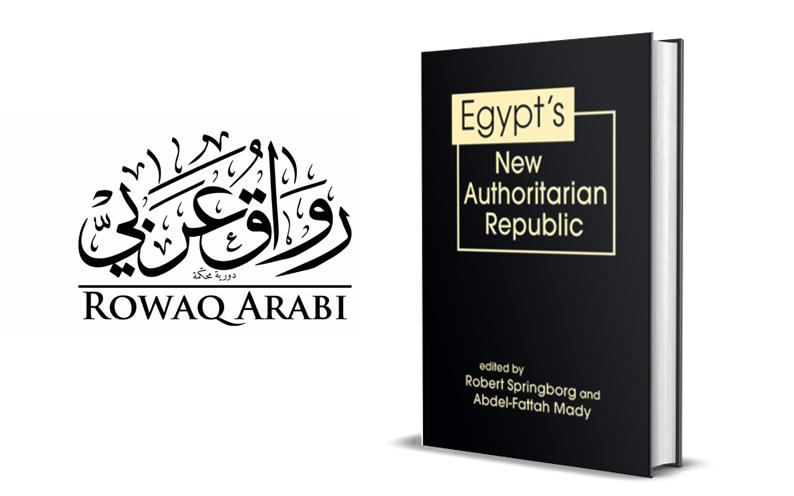الإشارة المرجعية: هيكس، نيل. 2025. «مراجعة كتاب: «الجمهورية السلطوية الجديدة في مصر» لعبد الفتاح ماضي وروبرت سبرينجبورج.» رواق عربي 30 (1): 76-79. https://doi.org/10.53833/DCLK7663.
العنوان: الجمهورية السلطوية الجديدة في مصر
المحرران: روبرت سبرينجبورج وعبد الفتاح ماضي
الناشر: لين رينر للنشر
سنة النشر: 2025
الرقم الدولي المعياري للكتاب (الإصدار الإلكتروني): 9798896160205
المعرِّف الرقمي الموحّد (DOI): https://doi-org/10.1515/9798896160205
يقدّم الكتاب الذي حرّره كلٌّ من عبد الفتاح ماضي وروبرت سبرينجبورج، ويضم مساهمات أحد عشر باحثًا مصريًا ودوليًا من أبرز الباحثين المتخصصين في الشأن المصري، قراءة تبعث على القلق وتدعو للتأمل. إذ يجمع بين الكثير من هذه المساهمات خيط ناظم يتمثل في الفجوة المثيرة للقلق بين الطموحات الكبيرة المُعلَنة لما يُسمّى بـ «الجمهورية الجديدة» للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبين غياب تحسينات ملموسة في حياة الغالبية العظمى من المصريين. الأكثر إثارة للقلق أن نمط الحكم شديد المركزية والمفرط في الشخصنة الذي ينتهجه الرئيس السيسي يقوّض أي إمكانية لتطوير مؤسسات دولة قوية ومستقلة، أو أحزاب سياسية قادرة على المشاركة في صناعة القرارين السياسي والاقتصادي. ويخيّم على كل ذلك إنفاق حكومي يتجاوز بكثير قدرات الدولة، موجَّه في الأغلب إلى مشروعات عملاقة باهظة التكلفة ومشكوك في جدواها، وإلى صفقات أسلحة تفوق بكثير ما تنفقه دول أخرى ذات مستوى اقتصادي مماثل، وهو ما يصفه سبرينجبورج في فصله اللافت عن الاقتصاد المتعثر بأنه «دولة ريعية بلا ريع». وفي ظل تراكم الديون على مصر، وبيعها للأصول المملوكة للدولة، وتزايد اعتمادها على المساعدات من دول الخليج الغنية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ يلوح في الأفق مستقبل من التبعية المتفاقمة، وربما حتى فقدان السيادة.
تصف الفصول كيف وصلت مصر إلى هذه النقطة المتدنية في حظوظها السياسية والاقتصادية. و يخلص المؤلفون، رغم التوترات والتناقضات الواضحة، إلى أن النظام لا يبدو مهددًا بانهيار وشيك، وإنما يظهر حالة من الاستقرار، وإن كان هذا الاستقرار لا يضمن بقاءه إلى ما لا نهاية. لقد مر الآن أكثر من اثني عشر عامًا منذ انقلاب السيسي وانتخابه رئيسًا في عام 2014، مما يشير إلى قدر من رسوخ حكمه.
ولا يعد مستغربًا أن معظم الفصول تتناول الكيفية التي ينجح بها نظام السيسي في تطبيق خدعته السياسية. فما يتقنه نظام السيسي هو تحويل أعبائه الحقيقية إلى عوامل تمكّنه على أقل تقدير من البقاء في السلطة، إن لم تتحوّل إلى مكاسب. وفي هذا الصدد، يصف محمد عفان وبروس ك. رذرفورد كيف تمكن النظام من بناء «شرعية من دون أداء». فمن خلال «المبالغة في إنجازاته، وطمس إخفاقاته، وقمع البدائل»، يروج النظام سردية للإنجاز، قد لا تتوافق مع الواقع، لكنها في الوقت نفسه فعّالة في الحفاظ على قدر كافٍ من الدعم الداخلي والدولي. وقد تعزّزت الفكرة القائلة إن نظام السيسي «أكثر فاعلية من أي بديل قابل للتطبيق»، وذلك عبر سردية الدعاية الرسمية التي تؤكد أن السيسي أنقذ البلاد من فوضى واضطرابات ما بعد 2011، لا سيما تهديدات مثل الإرهاب وحكومة محمد مرسي المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين. يُعزز هذه الدعاية واقع قاتم من الفوضى المتفاقمة والعنف الكارثي على الحدود مع غزة والسودان، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار المزمنة في ليبيا. وفي مثل هذه الأوقات العصيبة، يبحث الناس عن قائد قوي يوفر لهم الحماية؛ والسيسي لا يملّ من التأكيد للمصريين بأنه ذلك القائد. إن ممارسة السيسي للقمع بالقوة الغاشمة، المتمثّل في إقصاء خصومه السياسيين وسحق المعارضة، مع سقوط آلاف الضحايا في رابعة وغيرها، قد مهّد الطريق لحكمه السلطوي المستمر من خلال إظهار التكلفة الباهظة للمقاومة.
العامل الثالث –فيما يصفه سبرينجبورج في الفصل الختامي من الكتاب بـ «مثلث السيسي المُهلك»– هو الدعم الخارجي، الذي يتشابك على نحو ثلاثي مع كل من القوة الصلبة والناعمة في علاقة تآزرية متبادلة، ويُوظَّف من جانب النظام للحفاظ على بقائه في السلطة. إن جاذبية السيسي لدى داعميه الدوليين تستند إلى المبادئ ذاتها تقريبًا التي يستند إليها في ادعاءاته بالشرعية أمام الشعب المصري. فهو لا يحتاج إلى تأييد حماسي؛ بل كل ما يحتاجه هو الإذعان لفكرة أنه أفضل من البدائل المتاحة الأخرى.
ويشير سبرينجبورج في فصله عن الاقتصاد إلى مواصلة مصر الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي؛ رغم كونها ثاني أكبر دولة مدينة للمؤسسة بعد الأرجنتين، ورغم إخفاقها المتكرر في الامتثال لشروط الإصلاح الاقتصادي التي حاول الصندوق فرضها. كما تقدّم الاتحاد الأوروبي بحزمة مساعدات ماكرو-اقتصادية بعدة مليارات يورو من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد المصري؛ رغم ضعف الأدلة على امتلاك الحكومة النية أو القدرة على إجراء الإصلاحات اللازمة.
على جانب أخر، يصف الفصل الذي كتبته مي درويش سياسة السيسي الخارجية باعتبارها سجلًا آخرًا من الإخفاقات، متنكرًا بخطاب يوهم بالتقدّم والنجاح. وتصف درويش هذا الأمر، بتعبير مخفّف، بأنه «التنافر بين الخطاب والسياسات»، وهو ما يعني عمليًا سلسلة من الادعاءات الزائفة. ومع ذلك، فإن داعمي مصر الدوليين يمضون طوعًا مع هذه المزاعم الكاذبة؛ لأن نظام السيسي يبدو في منظور العلاقات الدولية أفضل من البدائل الأخرى المتاحة. ويُشكّل فصل درويش تذكرة صادمة، حتى لأولئك الملمين بالتاريخ، بسجل طويل من إخفاقات السياسة الخارجية لحكومات مصر المتعاقبة منذ عام 1956: ففي عهد عبد الناصر، كان هناك مشروع الوحدة قصير الأمد مع سوريا، وحرب اليمن، والحرب الكارثية عام 1967 مع إسرائيل؛ وفي عهد السادات، فشلت اتفاقية كامب ديفيد في إنصاف حقوق الفلسطينيين، وتركت مصر في مواجهة ازدراء جيرانها العرب وأججت الانقسام في الداخل؛ أما في عهد مبارك، وفي إطار سعيها أن تغدو جسرًا مفيدًا بين الغرب والشرق الأوسط، باتت مصر تعتمد على الولايات المتحدة، بل وعلى إسرائيل، بشكل متزايد.
جاء السيسي إلى السلطة متعهدًا ببناء علاقة شراكة، لا تبعية، مع الغرب. وأطلق ادعاءات متباهية عن إنشاء قوة عربية مشتركة للتصدي لتهديد انهيار الحكومات المركزية في المنطقة العربية بعد 2011. غير أن هذه المبادرة قوبلت بالتجاهل من بقية الدول العربية، فيما أضحت مصر «خاضعة للميول الإماراتية والسعودية». إن إخفاقات السيسي في السياسة الخارجية، سواء في ما يخص سدّ النهضة الإثيوبي، أو جزيرتي تيران وصنافير اللتين تنازلت عنهما مصر إلى السعودية، أو الكارثة المتفاقمة في غزة، تُشير إلى أن السياسة الخارجية المصرية في عهد السيسي ما تزال تتبع نهج أسلافه، إذ شكّل التراجع في القوة الإقليمية سمة بارزة في سجلاتهم. وتلفت درويش النظر إلى أن «تواطؤ الحكومة وإذعانها للسياسات الإسرائيلية والأمريكية» قد وسّع الهوة بين الرأي العام وسياسات النظام. فبينما يتيح تكيّف مصر، أو خضوعها، للداعمين الذين ازدادت تبعيتها لهم اكتسابها رضاهم، بما يضمن لها دعمًا ماليًا وسياسيًا وغير ذلك على المدى الطويل؛ إلا أن هذا الأمر قد يأتي على حساب تآكل شرعيتها الداخلية.
حقوق الإنسان أيضًا من بين المجالات الأخرى في سياسات النظام التي تُظهر امتدادًا لنهج أسلافه، ويصف معتز الفجيري في فصله المعنون بـ «النشاط الحقوقي العابر للحدود»، كيف أن «النظام العالمي لحقوق الإنسان قد أتاح مساحة لمقاومة السلطوية في مصر». وبرغم صحة هذا الأمر؛ إلا أنه يعكس أيضًا واقعًا أكثر قتامة، يتمثل في أن القمع شديد الوطأة الموجَّه بحق نشطاء حقوق الإنسان في مصر قد أجبر عشرات من أبرز النشطاء على مغادرة البلاد لتفادي الاضطهاد. وقد باتت عدة منظمات حقوقية مصرية رائدة اليوم، ذات طابع عابر للحدود قسريًا، إذ يعمل بعض أفراد طواقمها داخل البلاد والبعض الآخر خارجها. قبل نحو عشرين عامًا، كتبتُ عن تطبيق نظرية النموذج اللولبي (spiral model theory) في التنشئة الحقوقية على مصر، ولاحظتُ حينها أن مصر «تمثّل تحذيرًا من التداعيات المتفائلة لنظرية النموذج اللولبي».[1] وكما يوضح الفجيري، فإن نشطاء حقوق الإنسان في مصر يمكنهم «تحدي سردية الحكومة»، لكنهم حققوا نجاحًا ضئيلًا في تغيير ممارساتها الحقوقية. قبل عقدين، كانت مصر قد أتقنت بالفعل تقديم «تنازلات تكتيكية» بلغة نظرية النموذج اللولبي، إلا أن تأثير تلك التنازلات على واقع حقوق الإنسان على الأرض كان طفيفًا للغاية. وقد واصل السيسي هذه الممارسات، بل ووسّع نطاقها، عبر مبادرات رفيعة المستوى لكنها فارغة المضمون مثل «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» و«الحوار الوطني».
كانت مصر سبّاقة عالميًا في ابتداع أساليب للالتفاف على الانتقادات الموجَّهة إلى سجلّها في حقوق الإنسان. فقد سبقت غيرها في توظيف متطلبات تسجيل منظمات المجتمع المدني كآلية للسيطرة، وفي اعتبار التمويل الأجنبي عيبًا جوهريًا يمكن استغلاله. كما عمدت إلى تطبيع وصم منتقديها السلميين بأنهم إرهابيون أو متعاطفون مع الإرهاب. وتظل هذه الأساليب المُضللة فعّالة لأن الأطراف المعنية الرئيسية تُولي أهمية أكبر للحفاظ على علاقات وثيقة وتعاونية مع مصر أكثر من انشغالها بمسائل حقوق الإنسان. وطالما أن الدول مستعدة للتعاطي بشكل مراوغ في قضايا مثل أوضاع حقوق الإنسان أو الاقتصاد أو غيرها من مجالات الاهتمام المشروع؛ فلن يكون هناك أي حافز جاد يدفع الحكومة المصرية إلى إجراء الإصلاحات اللازمة.
لقد أنجز المحرران والمساهمون عمل جدير بالتقدير في تأليف هذا الكتاب، الذي يروي قصة متماسكة بشأن كيفية ترسيخ السيسي لحكمه من خلال إنشاء دولة بوليسية، إذ تمارس الجهات الرسمية العنف ضد المواطنين بانتظام وفي ظل إفلات تام من العقاب. في الوقت ذاته يشرف السيسي على أزمة اقتصادية متسارعة، وإخفاقات متتالية في السياسة الخارجية، وتآكل منظومة الخدمات الاجتماعية التي كانت العمود الفقري للدولة المصرية خلال العقود الأولى للاستقلال. ورغم هذه التناقضات الظاهرة؛ فإن نظام السيسي لا يُظهر أية مؤشرات على الفشل ويبدو مستقرًا، لأن الداعمين الخارجيين الرئيسيين، في الخليج والغرب، مستعدون لقبول السيسي، بكل ما يمثله من سوء إدارة وإخفاقات، باعتباره أفضل من البدائل المتاحة. إن ممارسة السيسي للقمع بالقوة الغاشمة وخنقه للنظام السياسي يضمنان ألا تظهر بدائل من داخل مصر. في الوقت الراهن، وطالما أن عناصر «المثلث المُهلك» قائمة، فإن المصريين عالقون في قبضة نظام مختلّ لا يقدّم سوى القليل لتحسين نوعية حياتهم. بإمكان السيسي ونظامه التحكّم في استخدامهم للقوة الغاشمة، وقد أظهروا استعدادًا لممارستها بقسوة. كما أنهم بارعون في صياغة سرديات تحافظ على مستوى معين من التأييد، ينبع جزئيًا من الخوف مما يمكن أن يفعله بك النظام، وكذا مما قد يحدث إذا لم يكن النظام قائمًا لحمايتك. كما يوظفون خطابًا عن استعادة العظمة الوطنية، قد يكون خاوي المضمون، لكن الناس على استعداد للارتباط به أو على الأقل التكيّف معه. إلا أن السيسي لا يملك القدرة على ضبط ممارسات داعميه الدوليين، ومع وجود رئيس متقلّب في البيت الأبيض يهدد، على سبيل المثال، بترحيل ملايين الفلسطينيين قسرًا إلى مصر، فإن هذه الضبابية ربما تمثل موضع التهديد الأكثر إلحاحًا الذي سيواجهه النظام.
Read this post in: English